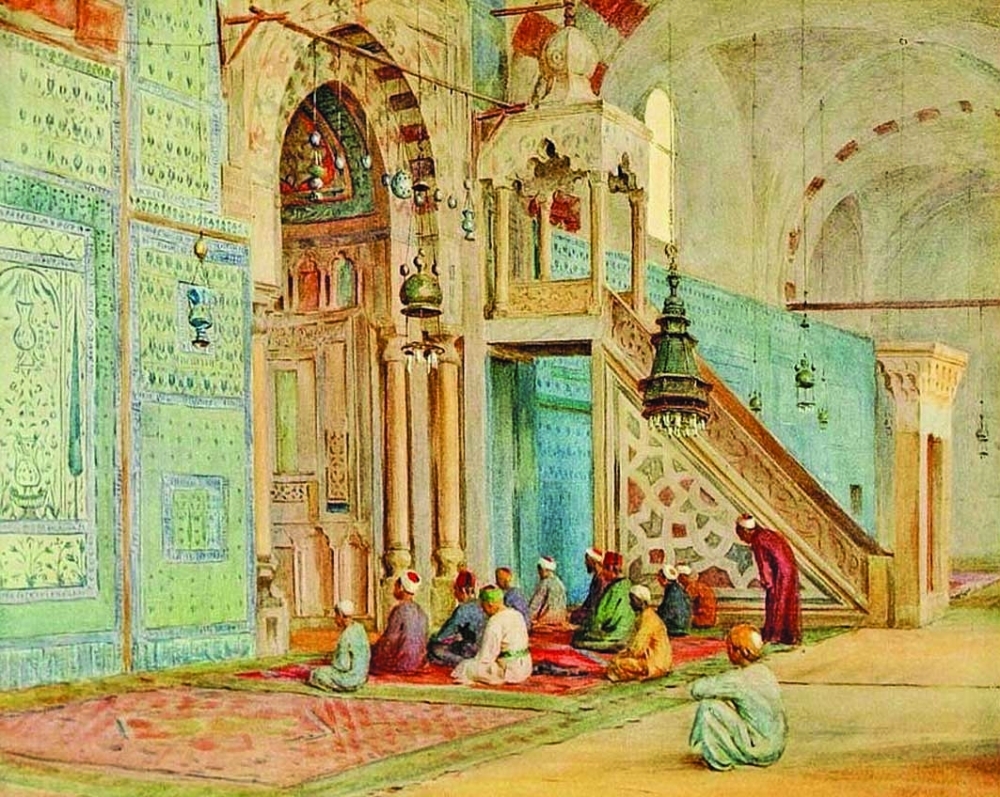منذ الانتكاسات التي مُنيت بها الأمة العربية، وانهيار شعارات الوحدة والقومية والمصير المشترك، مرّ الإنسان العربي بحالة من الضياع والتشتت، وغياب الأهداف، ولم تعد هناك عوامل مشتركة غير اللغة، بغض النظر عن تعدد اللهجات، فالاختلافات في المذاهب الدينية والسياسة، فضلاً عن التنوع الطائفي، اتُخذت ذريعة للتناحر، وتصفية الآخر، وتهميشه فكريًا وعقائديًا من قبل التيارات وليدة الإمبريالية الغربية، والتي قوضت الكثير من طموحات الشباب العربي، الذي اُتهم بسوء الفهم، والزندقة، والجهوية، والطائفية، أو صُبغ بالقومية، أو الوطنية، أو الدينية، أو المذهبية، دون النظر لأن لهم آراء من حقهم التعبير والدفاع عنها.
تزداد الحاجة إلى التراث في الصحوة الإسلامية المعاصرة كي يُساعدنا على تصحيح ممارساتنا، ولكي نستقي منه ثقافتنا، ونستلهم منه القيم السليمة في سعينا لبناء الحاضر واستشراف المستقبل، لأنه يمثل العمود الفقري في التاريخ الحضاري والثقافي للأمة العربية والإسلامية ، في وقت تشتد فيه الحملة المعادية على الإسلام والمسلمين، بحيث صارت كلمة مسلم في أذهان الغربيين مرتبطة بكلمة الإرهابي عدو البشرية، وكاره الأديان الأخرى، وساعي إلى تدمير الحضارة، وإعادة العالم إلى الظلام، في ظل غيابنا عن مقارعتهم بأدواتهم وأساليبهم نفسها بما يوضح حقيقتنا وحقيقة ديننا الحنيف، والدور الحضاري الكبير الذي مارسه المسلمون عبر التاريخ، وكان من المُفترض أن نتخذ من المساحة الإعلامية عبر الإنترنت والتقنية الفضائية ووسائل الإعلام والاتصال الأخرى، مجالاً لتطوير خطابنا بما يخدم التراث وقضاياه.
لكن للأسف انفلت الخطاب الإعلامي الإسلامي المعاصر في بعض مناحيه عن العقلانية، وأهداف الوعي المنشود؛ ليُصبح وسيلة إساءة وأداة إضافية بيد أعداء الإسلام، في وقت أصبح فيه الاتصال عبر وسائل الإعلام شأنًا مهمًا في حياة الأفراد والمجتمعات. وتعددت مفاهيم الإعلام ووسائله وأساليبه ومضامينه، وأخذت المعلومات تنتشر بسرعة هائلة إلى غالبية سكان المعمورة، حتى أن وصف الإعلام بأنه السلطة الرابعة، لم يعد تعبيرًا عن درجة رابعة في التأثير على أنماط التفكير والسلوك الإنساني، بل تكاد هذه السلطة تتحكم في السلطات الثلاث الأخرى. وبنظرة سريعة لبعض مجريات الطرح الآني في الإعلام المعاصر، نجده لا يخلو من أفكار هجينة، والبناء على أرضية هشة، يؤدي بالبناء حتمًا إلى الانهيار في النهاية.
منذ مدة ليست بالقصيرة تداول الكتاب والمفكرين في ميادين الأدب والفن والثقافة والإعلام ثنائية “التراث والمعاصرة” على أساس أنها ثنائية تضاد أو تقابل على أقل تقدير، وكأنهما لا يُمكن أن يجتمعا في غمد واحد، والسبب أنهم جعلوا التراث مرادفًا للأصالة، والمعاصرة مرادفًا للجدة، واستقر في مفهومهم أن أحد هذين المفهومين ينفي الآخر، أو لا يتحقق إلا على حساب الآخر، وهذا خلط يتطلب التأمل والمراجعة، فالتراث يُشكل حصيلة ما أنتجته عقول أبناء الأمم والشعوب من نتاج أدبي وفني وفكري، وهو بهذه الصورة معين ثري لا ينضب من الأفكار والمبدعات والأمثولات الدالة، التي تستند عليها الأمم في نهضتها العلمية والفكرية والثقافية .
التراث إذا أردنا الوقوف على مغزاه الحقيقي حافز للنوابغ الموهوبين على استنباط مشاريع خاصة بهم، ينجزون فيها أبنية جديدة، من عناصر وأجزاء فيه متفرقة ومتباعدة ، وبالتالي يُشكِّل ينبوع الثقافة والأصالة، الذي يُغذي الوعي القومي والجمعي لدى الفرد والجماعة في المجتمع الواحد، أو في المحيط البيئي الذي تشترك فيه مجموعة من الشعوب. وهنا يتراءى لنا أن العلاقة بين التراث والجدة ليست، كما سبق الذكر، علاقة تضاد، وإنما علاقة تداخل وتخارج في أن واحد، تجعل كل مُبدع ضاربًا بجذوره في التراث، ومُفترقًا عنه في نفس الوقت، بمعنى أن الكاتب الأديب أو الفنان المبدع يحتفظ من التراث بأصالته، ويعمل في إطار معطيات هذا التراث، فينشأ جدل من خلاله بين عناصر التراث والواقع ، ألا وهو هل نفهم التراث في ضوء الواقع أم نفهم الواقع في ضوء التراث؟ .
المثقفون في ذلك فريقان، منهم من يستنكر أي محاولة لرؤية التراث أو تفسيره في ضوء معطيات العصر، وحجتهم في ذلك أننا نُحمل الماضي أكثر مما يحتمل، ونضعه في أُطر من التصورات ليس لها أدنى تعلق بتصورات من أنجزوا ذلك التراث. آخرون يستنكرون الحكم على الواقع بمعطيات التراث، وحجتهم في ذلك أن الزمن الحاضر غير الزمن الماضي، ومحال أن يكون أسلافنا قد تطلعوا بأبصارهم إلى هذا المدى من المستقبل، بحيث تستوعب نظرتهم واقعنا الذي نعيش فيه اليوم . ولو أننا صدقنا الفريقين لكانت النتيجة أن التراث والواقع متنافران، ليس بينهما أي تجاوب، لكننا سنجد من يغضب عندما يطرد الواقع التراث، وآخر سيغضب عندما يطرد التراث الواقع، وبالتالي نستمر في قضية تدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. فلو اقتصر الأمر على التراث على أن يكون له مجرد حضور في الذاكرة، لما كان له أدنى فعالية، ولما تحقق التواصل بين حلقات التاريخ، وهذا أمر يختلف عن الوعي بالتراث، فقد يتذكر المرء أحداثًا كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يعي حدوثها، فوعي المرء لا يتقلص مع مرور الزمن؛ بل خلافًا للذاكرة ينمو في اطراد، ويرجع ذلك إلى طبيعته الجدلية.
يقول المفكر الكبير الدكتور زكي نجيب محمود: “هناك نقطتان: الأولى كنت أشعر في بداية حياتي العلمية إنني غير مُعبأ التعبئة الكافية بتراثنا؛ وذلك لأن التربية في المدارس المدنية كانت تُعطينا هذا التراث قطعًا، ولا تعطينا إياه في صورة متماسكة، فخرجنا جميعًا وفكرتنا ضعيفة لا يعتمد عليها في هذا التراث العظيم… فلما بلغت السن ما بلغت أحسست بمسئوليتي نحو قلمي، ونحو عقلي وثقافتي، بألا أُصدر الأحكام الثقافية إلا وأنا على العقل مُلم بشيء يعتمد عليه في معرفة هذا التراث، لذلك انصرفت إليه بكل ما أستطيع من قوة لأعوض ما فاتني من نقص. وفي أثناء دراستي لهذا التراث كنت ألاحظ ملاحظات أثبتها إما في ذاكرتي أو في مذكراتي إلى أن تكونت لديَّ بعض الأفكار لا أدعي أنها صحيحة كلها، ولا أزعم أنها فاسدة، ولكنها على وجه العموم كونت وقفة ووجهة نظر تتمثل في أنه لابد من تقديم هذا التراث لشبابنا على نحو يجعله جُزءًا من ثقافته، ولكن بشرط ألا يشعر الدارس أنه أمام شيء مقدس. النقطة الثانية، أننا عندما ندرس التراث ندرسه لا ليكون وحده هو الميدان الثقافي الذي نتحرك فيه دائمًا ليكون جزء من كل، أما بقية الكل فهي خاصة بثقافة هذا العصر الذي نعيشه، وأهم ما في هذه الثقافة التي نعيشها هو الجانب العلمي… فلا جدوى من أن نحبس أنفسنا بين جدران التراث، ولا جدوى من أن نتعصب للعصر وحده، وننسى شخصيتنا وتاريخنا، لذلك نتمنى أن نضمن الجزأين معًا لتتكون لنا صيغة موحدة لثقافة نستطيع أن نعيشها”.
الحياة