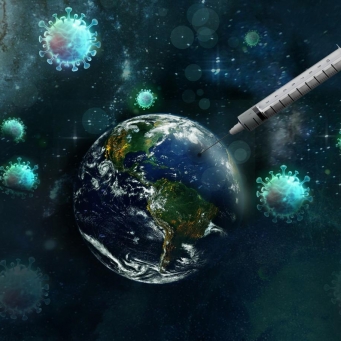
عندما أعلنت “جامعة إكستر” بابتهاج كبير أنها ستشارك في دراسة دولية للنظر في الفوائد المحتملة للقاح القديم المضاد للسل، في مواجهة فيروس كورونا، تمثل رد فعلي الأول مثلما حدث مع عديد من الناس بلا شك، في تهنئة العلماء وتمني النجاح لهم. لكن رد فعلي الثاني جاء من خلال طرح السؤال لمَ استغرق منهم كل هذا الوقت؟ وفي أبريل (نيسان) المنصرم، عندما بلغت الوفيات الناجمة عن كوفيد في المملكة المتحدة ذروتها، برزت أحاديث كثيرة عن الفوارق بين البلدان المختلفة، ولا تزال هذه الأحاديث مستمرة. وكذلك ثار سؤال لفترة وجيزة عن أن أحد العوامل التي تشكل جزءاً من التفسير، ربما يكون الاختلاف في سياسات الحكومات الوطنية تجاه التطعيم ضد السل.
وآنذاك، وجد الباحثون في “معهد نيويورك للتكنولوجيا” أن “البلدان التي ليست لديها سياسات شاملة للتطعيم ضد السل (كإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة) تأثرت بشدة بالمقارنة بالدول التي لديها سياسات شاملة وطويلة الأمد بشأن لقاح [“بي سي جي” BCG مسمى علمي آخر للقاح السل]، وأن الاختلاف لا يمكن تفسيره بعوامل أخرى كالتبني المبكر لإجراءات التباعد الاجتماعي.
في هذا الصدد، ذكر علماء نيويورك أن انخفاض معدل الوفيات يشير إلى أن لقاح “بي سي جي”. يمكن أن يكون “أداة جديدة محتملة في مكافحة كوفيد-19. ولم يكن المقصود أن لقاح السل يحمي من الفيروس، بل إنه قد يخفف تأثيراته، وبالتالي يوفر حلاً مؤقتاً بانتظار ظهور لقاح خاص بكورونا. وآنذاك أيضاً، بدأت تجارب واسعة النطاق على الفور تقريباً في أستراليا، في “معهد مردوخ” في ملبورن، مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين.
بعد ذلك ساد الصمت في كل مكان، حتى جاء الإعلان من “جامعة إكستر” هذا الأسبوع.
والآن يمكن تفسير التأخير الذي حدث منذ أبريل إلى اليوم ببساطة بعملية جمع الأموال والسرعة التي تدور بها دواليب المؤسسات الأكاديمية. في المقابل، أتساءل عما إذا كان هناك عامل آخر. وفي الوقت الحاضر، تُلقح بلدان عدة حديثي الولادة، والبعض الآخر يعطي اللقاح في سن السابعة أو أكثر. مع ذلك، أوقفت المملكة المتحدة، مثل عدد من البلدان الغنية حيث لم يعد السل يشكل خطراً كبيراً، التطعيم الشامل في 2005، واستمرت في إعطائه لتلك الشرائح من السكان التي تعتبر معرضة لخطر الإصابة بشكل خاص. وثمة الآن في أوروبا فجوة ملحوظة بين تلك البلدان التي أوقفت التطعيمات الشاملة ضد داء السل وتلك التي استمرت فيها، وتضم الأخيرة عدداً من بلدان الكتلة الشرقية السابقة.
مع انتشار جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا هذا الربيع، كان هناك استغراب واسع في المملكة المتحدة وأماكن أخرى من أن الجزء الشرقي من القارة، من روسيا إلى شرق ألمانيا، يبدو أفضل حالاً في بعض النواحي، خصوصاً معدل الوفيات، من الجزء الغربي. وما يفسر ذلك الاستغراب على ما يبدو يتمثل في ذلك الموقف المتعالي إلى حد ما تجاه المعايير الصحية والخدمات الصحية في الكتلة الشرقية السابقة.
في ذلك السياق، برز سؤال ضمني عما تفعله تلك البلدان [في أوروبا الشرقية] كي تتفوق في الأداء على الخدمات الصحية الممتازة الموجودة في “العالم الأول” وضمنه المملكة المتحدة. ونعلم جميعاً أن مستويات معيشتها أقل من مستوياتنا وأنه في بعض الحالات، خصوصاً في دول أقصى الشرق، لم يجرِ إلى حد كبير إصلاح أنظمتها الصحية التي تعود إلى الحقبة الشيوعية؟ لذا تساءلت عما إذا كان هذا الموقف، المتمثل أساساً في الميل نحو التعامل باستعلاء مع الكتلة الشرقية السابقة، قد أسهم في تأخير النظر عن كثب في لقاح “بي سي جي”؟
مع ذلك، فإن الرفض غير المبرر على ما يبدو للأبحاث الأولية بشأن هذا اللقاح لا يقارن بالشكوك والعداء الصريح تجاه أبحاث لقاح “كوفيد- 19” الروسي مِن قبل عدد من الحكومات الغربية ومؤسساتها العلمية والصحية.
ففي يوليو (تموز) الماضي، نسقت المملكة المتحدة إصدار إعلان مع الولايات المتحدة وكندا يتهم الاستخبارات الروسية بمحاولة اختراق أبحاث اللقاحات. وقد بدا أن إحدى المؤسسات التي استُهدفت هي جامعة أكسفورد، المتسابقة الأولى في أبحاث لقاح “كوفيد- 19” داخل المملكة المتحدة. وسواء كان عن طريق المصادفة أو بصورة مقصودة، فإن ذلك الإشعار “التحذيري” قد حجب تماماً إعلاناً من قبل روسيا بأن شركتها “آر- فارما” R-Pharma، قد وقعت للتو عقداً مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة “آسترا زنيكا” AstraZeneca لإنتاج لقاح أكسفورد وتوزيعه بموجب ترخيص. وكذلك أشارت روسيا في تصريحات لاحقة، وهي متأثرة إلى حد ما، لماذا ستحاول سرقة شيء أبدت استعدادها لشرائه؟
وبعد ستة أسابيع، جرى الكشف عن حصول “آسترا زنيكا” على موافقة السلطات لبدء المرحلة الثالثة من تجارب لقاح “كوفيد- 19” في روسيا، وتحديداً في موسكو وسان بطرسبرغ. وحتى عندما كان الموقف الرسمي للمملكة المتحدة يدين الروس باعتبارهم غشاشين ولصوصاً، يبدو أن شركة بريطانية كبرى كانت تتعاون مع شركة روسية بطريقة تجارية عادية تماماً.
وفي غضون ذلك، عرضت روسيا في مناسبات عدة مشاركة أبحاثها، لكن لم تحصل عروضها على سوى الرفض وإدانة معاييرها البحثية. وفي المقابل، برزت النقطة المضيئة الوحيدة في أوائل الشهر الماضي عندما نشرت مجلة “لانسيت” The Lancet ورقة بحثية روسية عن لقاح “سبوتنيك،” لتجد نفسها والبحث الروسي عرضة لإدانات شديدة. وفي هذا الأسبوع، أعلنت روسيا، بشجاعة على ما يبدو، عن تطوير لقاح ثانٍ وصل إلى مرحلة متقدمة جداً.
ومهما كانت الأسس الموضوعية أو غيرها لأبحاث اللقاحات الروسية، يصعب تصور أن يُعامل علماء أي بلد آخر بمثل هذا الازدراء قبل أن يجري حتى فحص أبحاثهم. ومن جدير ذكره أيضاً، في ما يتعلق بادعاءات القرصنة، أنه وفق ما اعترف به بهدوء بعض خبراء الإنترنت في المملكة المتحدة في ذلك الوقت، من الطبيعي أن يقوم أي جهاز استخبارات حقيقي في ظل الظروف الحالية بمراقبة أبحاث اللقاحات عن كثب في أي دولة أخرى. وفي الواقع، هذا ما صرح به الرئيس الجديد لـجهاز الاستخبارات الداخلية “أم آي 5” كين ماكالوم، هذا الأسبوع، حينما ذكر أن جهازه “كان يسعى حيثما أمكن للمساعدة بشأن كوفيد، وبشكل أساسي بشأن اللقاح.” وأضاف أن الجهاز “عمل على حماية سلامة البحوث في المملكة المتحدة،” في إشارة إلى أن ما يحدث هو بالفعل سباق تسلح جديد.
واستناداً إلى تلك المعطيات، تتمثل الحقيقة في أنه بينما تتحدث عدد من البلدان، بما فيها روسيا، بسخاء عن “مشاركة” أي لقاح في المستقبل مع جميع بلدان العالم، هناك منافسة شرسة من أجل السبق في إنتاج اللقاح. في هذا الصدد، ترغب روسيا في إبراز أنها ما زالت تحتفظ بشيء من براعتها العلمية إبان الحقبة السوفياتية، وعلومها يمكن أن تكون قوة من أجل الخير. من ناحية أخرى، تأمل المملكة المتحدة بشدة، وفق ما يتضح من دعم الحكومة مشروع [لقاح] أكسفورد ومشاريع اللقاحات الأخرى، في تعزيز سمعتها في التفوق العلمي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأما الولايات المتحدة، فإنها ترغب في الفوز لمجرد أنها تريد الفوز دائماً.
وبطبيعة الحال، جرى استنكار السباق من قبل عديد من العلماء، لكن لا شك في أن من يفوز سيحرص على إبلاغ الجميع بأنه قد “فاز”، سواء قرر “مشاركة” أو بيع المنتج المنقذ للحياة أم لا. إذ باتت المكانة الوطنية على المحك في عصر العولمة الذي لا نزال نعيش فيه.
وفي مقلب آخر، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مثالياً من دون جدوى، لا يسعني إلا الشعور بالأسف تجاه ما يحدث. ولأنه لدي اهتمام خاص بالفن والأفكار من عشرينيات القرن الماضي، تدهشني الانسيابية الرائعة التي كانت تسود في تلك الأيام عبر حدود أوروبا، من روسيا إلى ألمانيا ثم فرنسا وعبر البحر إلى بريطانيا. لقد سافر الناس وكتبوا وأثروا في بعضهم بعضاً وتبادلوا الأفكار. وبعد سقوط جدار برلين، كان هناك أمل في أن تصبح قارة “أوروبا كاملة وحرة،” بحسب التعبير الأميركي.
لكن ما رأيناه من تشكيك وحتى ازدراء غربي حيال تجربة الشرق وأفكاره، يمثل العكس من ذلك تقريباً. ويبين هذا أن أوروبا لا تزال إلى حد ما منقسمةً فكرياً وعلمياً بين الشرق والغرب، ونتيجةً لذلك لا يجري تجميع التجارب والخبرات المختلفة للاستفادة منها بشكل متبادل. إنه لأمر مؤسف، لكن ربما كان حتمياً، أن كل الدول الغربية لم تقبل عرض روسيا مشاركة أبحاثها في مجال اللقاحات. فقد جعل انعدام الثقة قبول العرض أمراً مستحيلاً. وبإطلاق تسمية “سبوتنيك” على لقاحها، استحضرت روسيا عمداً سباق الفضاء. ولقد كان ممكناً، بل متوجباً، أن تنتهي تلك الحقبة مع نهاية الحرب الباردة.
ماري ديجيفسكي
اندبندت عربي
