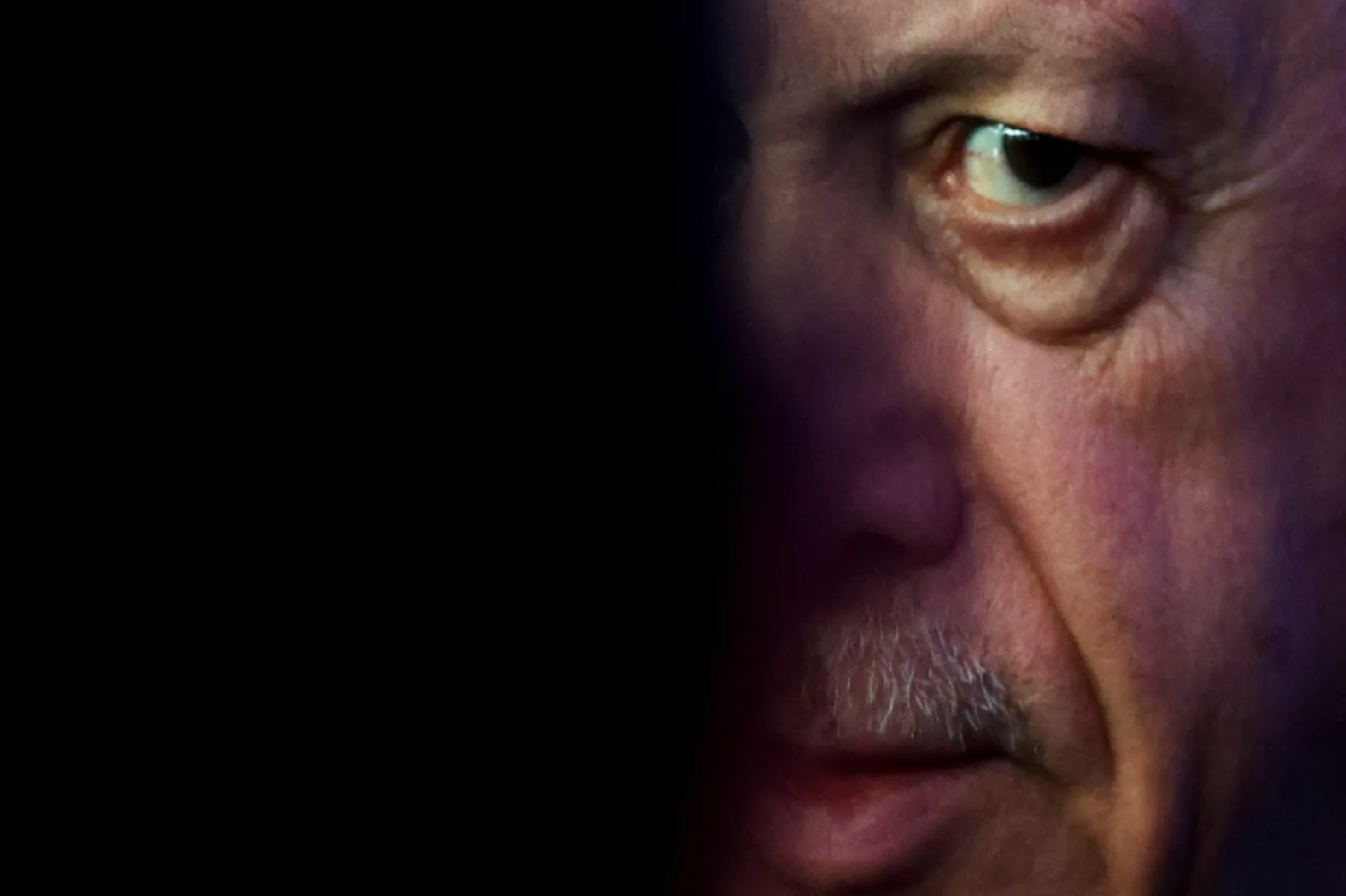لا أحد يجيد تنظيم حملات انتخابية على غرار تلك التي ينظّمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قبل أشهر من انتخابات تركيا في مايو (أيار) 2023، كشف أردوغان النقاب عن شعار حملته الانتخابية، “قرن تركيا”، أمام جمهور حي وصل عدده إلى الآلاف. وتضمّن العرض أوركسترا وجوقة أدّت أغنية تحتوي على مقطع غنّته بأسلوب موسيقى الراب:
كنت طائراً بجناح مكسور
بقيت صامتاً طوال قرن من الزمن
لكن كفى، كفى، اكسر هذا الصمت
عش حياتك حراً، كن حراً دائماً!
وتقول لازمة الأغنية، “فليبدأ قرن تركيا – ليس غداً، بل اليوم!” وفي الختام ألقى أردوغان خطاباً منمقاً طناناً نموذجياً، وصف فيه بعض سياساته الداخلية، على غرار تحويل الكنيسة البيزنطية الشهيرة في إسطنبول، آيا صوفيا، إلى مسجد، بأنها “تحدٍّ للهيمنة العالمية”، وتعهد بجعل تركيا “من بين أفضل عشر [دول] في العالم في مجال السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماسية”.
كان الهدف من هذا العرض نقل رؤية أردوغان للجمهورية التركية في الذكرى المئوية لتأسيسها: قوة صاعدة على أبواب السلام والازدهار خرجت منتصرة من معاركها المتعددة مع الإمبرياليين وأصبحت أخيراً جاهزة لتأخذ موقعها الصحيح كقوة عالمية. في هذا التصور، وبوجود أردوغان في سدّة الرئاسة، انتهى بحث تركيا عن الهوية الذي استمر لعقود. فهي قوة تحررت من الهيمنة الغربية، لم تعد تسعى للحصول على موافقة الغرب، ولم تعد تطمح إلى المثل الليبرالية الغربية، ولم تعد تعتمد على الغرب.
في تركيا ما قبل أردوغان، كانت هوية تركيا الأطلسية موضع تقدير ودعم، ليس بصفتها ضرورة جيوسياسية فحسب بل أيضاً باعتبارها إرثاً لمؤسس تركيا، مصطفى كمال أتاتورك، الذي قال إن بلوغ “مستوى الحضارة المعاصرة” كان المهمة التي يتعين على الجمهورية الفتية تحقيقها، والهدف الذي أدى على مدى عقود إلى تعزيز الحداثة والتغريب [أي الاتجاه نحو الغرب والنقل عنه] من القمة إلى القاعدة. ومع ذلك، بالكاد يدافع اليوم أي شخص يعمل في الشأن العام عن الأفكار أو المؤسسات الغربية. فالمعلقون والسياسيون في قنوات التلفزيون يشملون بشكل روتيني الولايات المتحدة مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي ويسخرون منها جميعاً باعتبارها جهات منافقة واستغلالية ومصممة على إخضاع تركيا. كذلك، مُنع الليبراليون الأتراك المؤيدون للغرب من الظهور في البرامج التلفزيونية الليلية ومن التعبير في صفحات الرأي في الصحف. حتى أن تركيا غادرت مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”، وهي حدث موسيقي مبتذل على مستوى أوروبا لا يزال يعرض منذ عام 1956.
واستطراداً، هناك تحول مماثل مرتقب في السياسة الخارجية التركية. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، حاولت تركيا حماية نفسها من التهديد الدائم للتوسع السوفياتي من خلال ترسيخ نفسها في المؤسسات الأوروبية الأطلسية ومحاولة مجاراة الديمقراطيات الغربية المتقدمة والمزدهرة. وقد نظرت واشنطن إلى تركيا في ظروف الحرب الباردة على أنها دولة حدودية مفيدة في الحرب ضد الشيوعية والنفوذ السوفياتي. لم تكن تركيا قط غربية أو ديمقراطية بالكامل. ولكن خلال فترة الحرب الباردة، كانت رغبة النخب العلمانية في البلاد في إرساء الدولة في الغرب كافية بالنسبة إلى صانعي السياسة في الولايات المتحدة.
اليوم، تختلف الصورة تماماً. منذ أن تولى أردوغان زمام السلطة في عام 2002، وبخاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكومته في عام 2016، تدهورت علاقة واشنطن مع أنقرة بشكل مطرد. وهي الآن أقل صحة من العلاقات التي تربط الولايات المتحدة ببعض القوى غير الأعضاء في الناتو. والسياسيون الأتراك، بمن فيهم أردوغان، غالباً ما يصنّفون الولايات المتحدة بغضب خصماً لا شريكاً. عندما فرضت واشنطن عقوبات على تركيا في عام 2020 بسبب شرائها أنظمة صواريخ أرض-جو “أس -400” من روسيا، على سبيل المثال، وصف أردوغان القرار الأميركي بأنه “هجوم صارخ” على السيادة التركية، وادعى أن “الغرض [من العقوبات] هو منع الخطوات التي اتخذتها بلادنا في الصناعة الدفاعية، وإبقائنا في حالة من التبعية”. في الوقت نفسه، في واشنطن، يشكك بعض صانعي السياسة الأميركيين علانية في التزام تركيا بحلف شمال الأطلسي ويخشون اقتراب أنقرة من موسكو.
لكن هذا الغضب المتبادل بدأ أخيراً في التلاشي والتحول إلى ما يشبه القبول. في الواقع، يدرك المسؤولون الأتراك الآن أن ابتعادهم عن الناتو ليس انحرافاً غير طبيعي بل وجهة نهائية. فتركيا في عهد أردوغان تعمل على أساس أن الغرب في حالة انحدار وأن عالماً متعدد الأقطاب آخذ في الظهور، وهو ما يوفر ظاهرياً مجالاً لصعود تركيا إلى مكانة القوة العظمى. لكن تركيا لا تريد تبديل المعسكرات من خلال الابتعاد عن حلف شمال الأطلسي والاتجاه نحو منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة دفاعية وأمنية أوراسية شكلتها الصين وروسيا في عام 2001 في محاولة لمنافسة الناتو. عوضاً عن ذلك، تريد تركيا أن تبقى على صلة مع كلا المعسكرين وأن توسّع في الوقت نفسه نفوذها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتبسط قوتها الاقتصادية على نطاق أكبر. وعلى رغم أن أردوغان يسعى إلى انفصال واضح عن الغرب عندما يتعلق الأمر بالأيديولوجيا والثقافة والهوية، إلا أنه يحاول أيضاً لعب دور متوازن ومدروس بعناية بين القوى العظمى، على أمل إيجاد مزيد من الفرص التي يمكن لتركيا أن تمارس فيها نفوذها.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لا تستطيع تغيير مجرى التاريخ وإعادة دمج تركيا في الغرب أو الاتحاد الأوروبي. ومحاولة تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي ليست في حالة احتضار فحسب؛ بل ماتت وشبعت موتاً. لقد ولت أيام وقوف رئيس أميركي إلى جانب القادة الأتراك وإعطاء المواعظ بشأن حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال بإمكان واشنطن بناء علاقة فعالة مع “دولة ما بعد هيمنة الغرب” التي تحولت تركيا إليها. قد تكون أنقرة بعيدة كل البعد من مكانة الحليف المثالي، وهي لن تتأثر بالمناشدات الداعية إلى القيم المشتركة أو بأهمية ما تعتبره واشنطن نظاماً دولياً قائماً على القواعد. لكن براغماتية أردوغان وطموحاته الإقليمية وطبيعته التي تميل إلى عقد الصفقات تجعل من الممكن إنشاء علاقة مثمرة.
أعزّ الأعداء وألد الأصدقاء
في جوهرها، كانت استراتيجية إدارة بايدن تجاه تركيا تتمثل في الإبقاء على مسافة مناسبة وآمنة من أنقرة. وهذا يعني تقليل وتيرة الدبلوماسية على المستوى الرئاسي التي ميزت معظم حقبة ترمب، وغالباً ما تسببت في تدهور العلاقات. على وجه العموم، حقق نهج بايدن نجاحاً، إذ خفّض سقف التوقعات لدى الجانبين وأخفى الاختلافات. وقد حافظت الإدارة على روابط مع تركيا، في القضايا ذات الأهمية الملحة فحسب، مثل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021 والاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الذي سمح للأخيرة بشحن الحبوب عبر البحر الأسود. ولعب أردوغان دوراً رئيساً في الصفقة من خلال إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسماح لشحنات الحبوب بالخروج من ميناء أوديسا الأوكراني، لمدة عام على الأقل. وكان أردوغان مهماً باعتباره أحد المقربين من بوتين.
بيد أن التعاون الأميركي – التركي بشأن التحديات الجيوسياسية الأوسع كان محدوداً أو معدوماً. ولا تزال إدارة بايدن قلقة سراً بشأن نهج تركيا الإقليمي الحازم والصارم، لا سيما تهديداتها بالتوغل في سوريا من أجل مهاجمة الميليشيات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المعروف اختصاراً بالـ”بككه” (PKK)، أي الفصيل الكردي المؤيد للاستقلال الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة على حد سواء كتنظيم إرهابي. ومما يثير القلق أيضاً تصعيد أنقرة لحربها الكلامية مع اليونان بشأن الحدود البحرية ودعم تركيا القوي للحملة العسكرية الأذربيجانية ضد أرمينيا، الأمر الذي أثار قلق واشنطن لأنه فتح إمكانية نشوب صراع شامل آخر عملياً بجوار الحرب في أوكرانيا.
تبدو العلاقة الأميركية – التركية أشبه بالطلاق الودي أكثر من كونها تعاوناً متبادل المنفعة.
لكن واشنطن أبدت ضبط النفس في ردها على هذه التحركات من أجل تجنب إثارة المواجهة. وكجزء من تحقيق انفراج في العلاقة مع إدارة بايدن، قامت أنقرة أيضاً بكبح “دبلوماسية الزوارق الحربية” [gunboat diplomacy أي استخدام السفن الحربية البحرية لتحقيق مكاسب دبلوماسية من خلال الضغط على الجهات الأخرى] في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال إيقاف التنقيب عن مصادر الطاقة قبالة سواحل قبرص وتخفيف التوترات بشأن حفر الآبار القبرصية في المياه المتنازع عليها. واستكمالاً، كانت تركيا حذرة من استهداف القوات أو المنشآت الأميركية بشكل مباشر في سوريا وامتثلت على مضض لاتفاقية عام 2019 مع واشنطن التي حددت المناطق الإقليمية الخاضعة لسيطرة الأكراد وتلك الخاضعة لسيطرة تركيا. وعلى رغم العداء لأميركا على نطاق واسع بين الجمهور التركي، فقد تجنب أردوغان إلى حد كبير المواجهة المباشرة مع إدارة بايدن.
لكنّ البعد لا يجعل القلب دائماً أكثر ولعاً وشوقاً، والسلام البارد بين الولايات المتحدة وتركيا يبدو وكأنه طلاق ودي وليس تعاوناً متبادل المنفعة. في غضون ذلك، في العقد الماضي، ازدهرت العلاقات الروسية – التركية بشكل عام ونجت حتى الآن من اختبار الضغط والإجهاد الذي فرضه الغزو الروسي لأوكرانيا. في الواقع، امتنع أردوغان عن أي انتقاد مباشر للفظائع الروسية، وكثيراً ما دعم رواية موسكو بأن الغرب هو الذي أشعل غزو أوكرانيا. وفي سبتمبر (أيلول) 2022 صرّح أردوغان: “يمكنني القول بوضوح إنني لا أجد موقف الغرب [تجاه روسيا] صحيحاً”. وقد رفضت تركيا الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا وحافظت على صلات اقتصادية وسياسية مع الكرملين، أصبحت أمتن بسبب علاقة أردوغان الشخصية الوثيقة مع بوتين.
في الوقت نفسه، يبقى التنافس الاستراتيجي قائماً بين أنقرة وموسكو، إذ تدعمان أطرافاً متعارضة في حروب بالوكالة في ليبيا وسوريا. وعلى رغم رفضه تبني الرواية الغربية حول الحرب في أوكرانيا ومعاقبة روسيا، فقد وقف أردوغان من الناحية العملية إلى جانب كييف في حربها ضد موسكو، وأقام علاقات صناعية دفاعية وثيقة مع أوكرانيا، وقام بتزويدها بالأسلحة، حتى أنه دعم محاولة أوكرانيا الحصول على عضوية في الناتو. ففي نهاية المطاف، لا تريد تركيا أن ترى سيطرة روسية على جناحها الشمالي.
دددد.png
الاحتفال بإعادة انتخاب أردوغان، إسطنبول، مايو 2023 (هانا مكاي / رويترز)
أكثر الأطراف حياداً
على غرار عدد كبير من القوى الوسطى، تسعى تركيا إلى تجنب التبعية الاستراتيجية من خلال المناورة والتنقل بين القوى العظمى. لكن وضعها عويص بشكل خاص، وقد تكون أكثر طرف يلتزم الحياد، فهي ليست مشتتة بين دول عدة تفوقها قوة فحسب، بل هي محتارة أيضاً بين الاستبداد والديمقراطية، وأوروبا وأوراسيا، والعلمانية ذات الميول الغربية والقومية المحافظة.
تشير مجالس الوزراء التي يختارها أردوغان إلى نيته في أن يسلك هذا المسار المعقّد، معتمداً استراتيجية تحوطية. وفي ذلك الإطار، يمثل وزير المالية محمد شيمشك، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ونائب الرئيس جودت يلماز، ووزير العدل يلماز تونج، ومدير الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالن، فصيلاً داخل النخبة التركية يعتقد أن بإمكان تركيا تعزيز موقعها، وتحسين اقتصادها، والتحايل على الهيمنة الروسية بمهارة أكبر إذا كانت علاقاتها أفضل مع الولايات المتحدة وأوروبا. لكنهم أيضاً حلفاء مخلصون لأردوغان منذ فترة طويلة، يثق بهم للعمل مع نظرائهم الغربيين من دون التنازل عن المصالح التركية.
ويُعتبر هذا، بشكل عام، تطوراً إيجابياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين، إذ إن تركيا تقع في صميم عدد من تحديات السياسة الخارجية الرئيسة التي تواجهها واشنطن. إن موقع تركيا الاستراتيجي على البحر الأسود – الذي يربط روسيا والشرق الأوسط وأوروبا – يجعل البلاد لاعباً مهماً في الحرب في أوكرانيا وعاملاً حاسماً في الجهود الغربية المبذولة لاحتواء روسيا. إذا بدأت المفاوضات بين كييف وموسكو، فقد يتبيّن أن علاقة أردوغان مع بوتين هي وسيلة نفوذ مهمة للغرب.
وبالنسبة إلى واشنطن وحلفائها تمتد أهمية تركيا إلى ما وراء منطقة البحر الأسود، إذ يمكن أن تساعد أنقرة أيضاً في الحفاظ على الاستقرار في القوقاز، على سبيل المثال، حيث يمكنها دفع حلفائها الأذربيجانيين للتوصل إلى اتفاق سلام مع أرمينيا. وينطبق الشيء نفسه على العراق وسوريا، حيث يساعد الوجود التركي واشنطن في الحفاظ على حد أدنى من النفوذ. أخيراً، تأمل واشنطن في أن تتمكن تركيا من المساعدة في إنشاء بنية مستدامة لنقل الطاقة تسمح لأوروبا بأكملها بالاستفادة من الموارد الهائلة المحتملة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
تقبّل الأمر الواقع
لكل هذه الأسباب، يجب على واشنطن أن تسعى إلى جعل علاقتها مستقرة مع أنقرة، على رغم حقيقة أن تركيا اعتنقت هوية تتجاوز الهيمنة الغربية في الداخل وموقفاً متحرراً من سيطرة الغرب في سياستها الخارجية. وهذا يعني التحرك نحو عقلية موجهة أكثر نحو الصفقات.
والجدير بالذكر أن المساومة الناجحة في قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس بشأن عضوية السويد في الناتو قد تشكّل نموذجاً. من الواضح أن أردوغان كان آنذاك في مزاج صفقاتي، وفي مقابل دعم محاولة استوكهولم الانضمام إلى الحلف، طالبت تركيا بتنازلات ليس من السويد فحسب (بما في ذلك إنهاء حظر تصدير الأسلحة السويدية غير الرسمي المفروض على تركيا، وقانون مكافحة الإرهاب السويدي الأكثر قسوة، وترحيل عدد من طالبي اللجوء المرتبطين بحزب العمال الكردستاني) بل أيضاً من الولايات المتحدة. وراء الكواليس، دفعت إدارة بايدن الكونغرس الأميركي إلى بيع طائرات “أف-16” F-16 لتركيا، وهي طائرات كانت أنقرة ترغب في شرائها منذ سنوات. ومن أجل تسهيل الأمر، توصل البيت الأبيض إلى صفقة ثلاثية تضمنت بيع طائرات مقاتلة من طراز “أف-35” F-35 إلى اليونان. في النهاية، جعل الاتفاق الجميع راضين جداً، حتى لو لم يتوافق مع المعايير المتّبعة في طريقة تعامل الحلفاء مع بعضهم البعض.
وقد سلطت هذه الواقعة الضوء أيضاً على مدى أهمية أردوغان، الذي لا يزال صانع القرار الوحيد بشأن أهم قضايا السياسة الخارجية التركية. في الحقيقة، يسعى أردوغان إلى الحصول على اعتراف وشرعية دوليين ويشعر بالاستياء من المسافة التي يبقيها قادة الغرب بينه وبينهم. لكنه على دراية أيضاً بالبيئة الجيوسياسية المتغيرة حول تركيا ويدرك حاجة تركيا إلى الحفاظ على العلاقات مع الغرب.
واستطراداً، يفتخر الزعيم التركي بنفسه لكونه أهم دبلوماسي في البلاد، لكنه غالباً ما يكون عاجزاً عن تحقيق هذه المهمة إذ إن القادة الغربيين بمعظمهم، خلال السنوات القليلة الماضية، تجنبوا الاجتماع به. وكجزء من صفقة انضمام السويد في الناتو، منحت إدارة بايدن أردوغان البروز الذي كان يتوق إليه، وعقدت معه اجتماعاً ثنائياً بارزاً في فيلنيوس، لا بل حتى نشرت مقطع فيديو لبايدن يشيد بأردوغان ويشكره. هناك حديث عن زيارة للبيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام، وقد التقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أخيراً بشيمشك، القيصر المالي التركي [الذي يملك سلطة كبيرة في الموضوع المالي لتركيا]. وفي ظل حالة الضعف الاقتصادي التي تسيطر على تركيا، يوفر هذا النوع من الاهتمام الأميركي تطمينات قيّمة للمستثمرين.
ومن الطبيعي أن تدابير موقتة أكثر تبادلية ستتسم بطابع انتهازي وقصير الأجل. والهدف من ذلك هو إيجاد صفقات حازمة تصلح للجانبين وغير مثقلة بمطالب الولاء الدائم أو الحظر على العلاقات التركية مع روسيا أو الصين. ويبدو أن هناك ثلاثة مجالات جاهزة على الفور لمثل هذه الصفقات، وهي التعاون الاقتصادي وسوريا وحقوق الإنسان.
صديق في وقت الضيق
قد تعتقد تركيا أنها لم تعد بحاجة إلى المظلة الأمنية الغربية أو لم يعد بإمكانها الاعتماد عليها، لكن اقتصادها لا يزال مترابطاً ومتداخلاً بشكل كبير مع الأسواق الغربية. في الواقع، لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر سوق تصدير لتركيا وأهم مستثمر بالنسبة إليها. ويمر الاقتصاد التركي بتراجع حاد، ويعود ذلك جزئياً إلى سوء إدارة أردوغان الشخصية للاقتصاد على مدى السنوات القليلة الماضية. لقد استنزفت سياسات أردوغان احتياطيات المصرف المركزي التركي، وخفضت دخل الفرد بشكل كبير، وقلصت من قيمة العملة. ولكن منذ إعادة انتخابه، يبدو أن أردوغان قد غيّر النهج الذي يعتمده، إذ عيّن شيمشك، وهو مصرفي سابق في شركة “ميريل لينش” Merrill Lynch وداعماً للسوق، وزيراً للخزانة والمالية، وعيّن حفيظة غاية أركان، الرئيسة التنفيذية المشاركة والرئيسة السابقة لبنك “فيرست ريبابليك” First Republic Bank، كحاكمة للمصرف المركزي.
وعلى رغم ذلك، لا تزال الأسواق التركية عرضة للتقلبات، ولا يزال المستثمرون الدوليون يراقبون لمعرفة ما إذا كان الفريق الجديد يمكنه تغيير المسار وجعل تركيا آمنة للاستثمار الأجنبي. ستحتاج أنقرة في النهاية إلى تمويل دولي لتكون قادرة على سداد ديون قطاعها الخاص وتجنب أزمة ميزان المدفوعات. ومن دون مؤشرات واضحة على الدعم والتمويل الغربيين، سيظل الاقتصاد التركي متقلباً لا بل مترنحاً على حافة الانهيار.
يمكن أن يتضمن هذا الدعم إحياء فكرة زيادة التجارة السنوية الإجمالية بين الولايات المتحدة وتركيا إلى 100 مليار دولار، وهو هدف أعلنته إدارة ترمب في عام 2019 ولكن سرعان ما تراجعت عنه. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، يمكن لواشنطن أن تعلن اعتزامها توسيع التجارة، والانخراط مع منظمات الأعمال المستقلة في تركيا، وتشجيع الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات حول تحديث اتفاق التجارة الحالي مع تركيا الذي عفا عليه الزمن؛ ففي نهاية المطاف، أوروبا هي المستثمر الأول في الشركات التركية والسوق الأكبر للسلع والخدمات التركية. يمكن للولايات المتحدة أيضاً أن تدفع بروكسل لبدء مفاوضات مع أنقرة بشأن دمج تركيا في خطط الاتحاد الأوروبي المعنية بالتحول الأخضر، والتي تشمل تطوير الطاقة المتجددة من حوض البحر الأبيض المتوسط.
في المقابل، يمكن لتركيا أن توقف استعراضات القوة والتباهي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه وأن توفّر لليونان وقبرص علاقات أكثر استقراراً. في الحقيقة، تبذل تركيا جهداً كبيراً بالفعل من أجل مساعدة أوروبا في إدارة الهجرة. وبفضل موارد الطاقة الوفيرة والعمالة الرخيصة فيها، يمكن لأنقرة أيضاً أن تحجز موقعاً لنفسها على الخريطة باعتبارها قاعدة إنتاج للولايات المتحدة وأوروبا أثناء محاولتهما “الحد من الأخطار” في علاقتهما الاقتصادية مع الصين من خلال تقليل اعتمادهما على المنتجات الصينية. وصحيح أن تركيا ليست عملاقاً في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وليست لديها صناعة أشباه موصلات، ولكن عندما يتعلق الأمر بمجموعة كبيرة من السلع الأخرى، يمكن أن تلبي جزءاً كبيراً من حاجات أوروبا.
الطريق إلى دمشق
تشكّل سوريا مصدر إزعاج أساسي بين أنقرة وواشنطن. والمسألة الأساسية هي معارضة تركيا لتحالف واشنطن مع الأكراد السوريين. في غضون ذلك، تدعم روسيا نظام الأسد في سوريا، الذي تعتبره تركيا دولة ضعيفة لن تتمكن يوماً من استعادة شرعيتها بالكامل أو السيطرة على جميع أراضيها. لكن أنقرة وموسكو تتشاركان الرغبة في منع الحكم الذاتي الكردي ورؤية القوات الأميركية تغادر شمال سوريا.
ومن أجل تحقيق هذين الهدفين، نفذت تركيا عدداً من التوغلات العسكرية في سوريا واستهدفت قادة الإدارة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا بهجمات استخدمت فيها طائرات من دون طيار. من وجهة نظر واشنطن، هذه الخطوات مزعزعة للاستقرار، لأنها تثير مخاوف من نشوب صراع كردي تركي أوسع، وتضعف قدرة الأكراد على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش).
إذا أرادت الولايات المتحدة وتركيا تحقيق استقرار في العلاقات، فسيتعين عليهما في النهاية التحدث عن سوريا ومستقبلها. وسيكون على كلا الجانبين اتخاذ خطوات كانا قد تجنباها حتى الآن. وستشكّل زيادة المساعدات الأميركية للاجئين السوريين في تركيا وشمال سوريا خطوة أولى جيدة تتخذها واشنطن. كذلك، يجب على الولايات المتحدة تشجيع الأكراد السوريين على تطبيع العلاقات مع نظام الأسد والموافقة على الاندماج في الدولة السورية مقابل نوع من الحكم الذاتي الإقليمي. ولكن لا يمكن لواشنطن أن تكون الراعي الوحيد لتجربة الحكم الذاتي الكردي في سوريا. إذا كانت هناك صيغة تسمح للأكراد السوريين بإنشاء حكم ذاتي إقليمي ضمن حدود الدولة السورية المستقبلية، فلن يكون أمام تركيا خيار آخر سوى قبولها، طالما أن أي اتفاق مقترَح سيضمن أن حزب العمال الكردستاني لن يكون له نفوذ داخل الإدارة الكردية في المنطقة. ويمكن أن تؤدي مثل هذه الصفقة أيضاً إلى الانسحاب النهائي للقوات الأميركية من سوريا والبدء في إعادة إعمار شمال سوريا بأموال دولية، مع تخصيص الحصة الأكبر من الاستثمار حتماً للمقاولين الأتراك.
في مقابل هذه الخطوات من جانب واشنطن، ستحتاج تركيا إلى دعم اتفاق بين القادة الأكراد والنظام في دمشق، والسماح بالتجارة والنقل بين مختلف المناطق داخل سوريا، وقبول أي ترتيب دستوري يتفق عليه السوريون في نهاية المطاف.
لا تحبس أنفاسك
أوضح أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية أنه غير مهتم بالإصلاحات السياسية في الداخل وصبره قليل تجاه المحاضرات الغربية حول حقوق الإنسان. وبالتالي فإن التحسينات القصيرة الأجل في مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في تركيا غير مرجحة، بغض النظر عما يفعله الغرب.
لكن براغماتية أردوغان ونهجه من تبادل الصفقات أسفرا في بعض الأحيان عن نتائج في قضايا حقوق الإنسان البارزة عندما ضغطت واشنطن بشدة. وتشمل تلك النتائج إطلاق سراح نشطاء حقوقيين من السجن في عام 2017، كانوا قد زُجّوا خلف القضبان بتهمة دعمهم المزعوم للانقلاب الفاشل ضد أردوغان عام 2016، والإفراج عن الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل والقس الأميركي أندرو برونسون من السجن عام 2018. في المرتين المذكورتين، حدثت في أعقاب الدبلوماسية الهادئة مساومةٌ سافرة حصلت فيها تركيا على تنازلات غير ذات صلة، بما في ذلك تحديث منظومات الأسلحة والحصول على دبابات ليوبارد من ألمانيا.
بإمكان واشنطن، لا بل ينبغي عليها، أن تبقي المحادثة بخصوص حقوق الإنسان مع تركيا حية وأن تساوم بشدة من أجل تأمين الإفراج عن سجناء سياسيين مثل عثمان كافالا، زعيم المجتمع المدني الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن المؤبد في أحد السجون التركية بتهم ملفقة. ولكن من الأفضل إجراء تلك المحادثات على انفراد مع أعضاء الدائرة المقربة من أردوغان، ومع توقعات واضحة بشأن الفدية التي تنوي واشنطن تقديمها.
بالطبع، يجب أن تستمر واشنطن أيضاً في دعم تطلعات المواطنين الأتراك الذين يريدون ديمقراطية أفضل، ويجب أن تبدي ثباتاً في رسائلها العامة حول مثل هذه الأمور. وبطريقة موازية، يتعين على الولايات المتحدة أن تكون متواضعة بشأن ما يمكن أن تحققه وألا تدع تلك الجهود تقف في طريق إحراز تقدم في قضايا محددة. في الوقت الحالي، قد يكون دعم المجتمع المدني، وتعميق التبادلات الثقافية والتكامل الاقتصادي، والتعاون مع شريحة واسعة من المؤسسات التركية (بما في ذلك الجامعات والبلديات) أكثر فاعلية من إصدار تهديدات علنية للنظام.
ما الذي سنجنيه من ذلك؟
لن يتغير أردوغان، ولن تكون تركيا ما بعد الغرب حليفاً تقليدياً عبر الأطلسي. في الواقع، تملك تركيا مجموعة مصالح خاصة بها، بعضها مشترك مع واشنطن، والبعض الآخر لا. في المقابل، لدى الولايات المتحدة علاقات مستقرة مع عدد من الشركاء الذين تجد صعوبة في التعامل معهم، ولا يجمعها بهم توافق كامل. يمكن أن تكون العلاقات الأميركية – التركية في وضع أفضل يعمل لمصلحة الاقتصاد التركي، ويساعد أنقرة على تحقيق التوازن ضد روسيا، ويمنح واشنطن مزيداً من الثقة مع تنامي نفوذ الصين في الشرق الأوسط.
تُعدّ تركيا في عهد أردوغان نموذجاً أولياً لنوع القوة المتوسطة التي يجب على واشنطن أن تتوقع ظهورها في كثير من الأحيان في عصر المنافسة الجيوسياسية المقبلة. هذه القوى، التي لا تُعتبر لا حليفاً ولا عدواً، لن تفهم صراع واشنطن مع بكين وموسكو من الناحية الأخلاقية أو الأيديولوجية. بدلاً من ذلك، سوف تسعى إلى الحفاظ على استقلالها من جميع الجوانب وستسأل نفسها باستمرار، ما الفائدة من ذلك بالنسبة إلينا؟ ستحتاج الولايات المتحدة إلى العثور على إجابات على هذا السؤال تتجاوز التغنّي الفارغ بنظام قائم على القواعد لا يؤمن به أحد فعلياً. إن إنشاء علاقة أكثر واقعية مع تركيا ما بعد الغرب، علاقة قائمة على التبادلات المفيدة للطرفين، سيكون بمثابة نقطة بداية جيدة.
• أسلي أيدينتاسباس زميلة زائرة في مركز شؤون الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينغز، وزميلة رفيعة الشأن في السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وكاتبة عمود في صحيفة “واشنطن بوست”.
• جيريمي شابيرو هو مدير البحوث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وزميل رفيع الشأن غير مقيم في معهد بروكينغز. خلال إدارة أوباما، عمل في فريق تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأميركية واحتل منصب كبير مستشاري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية.