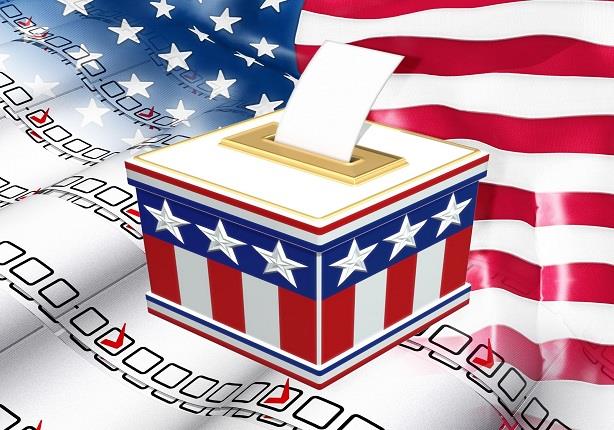
قاربت الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية على الانتهاء؛ وأصبح من اليقين فيها أن دونالد ترامب وهيلاري كلينتون سوف يكونان المرشحين المتنافسين على دخول البيت الأبيض. تحليل هذه المنافسة من حيث البرامج والشخصية والسياسات المتوقعة سوف يكون موضوعًا للتقدير والتحليل خلال الفترة المقبلة تقريبًا من كل المراقبين والمحللين للسياسة العالمية والولايات المتحدة وسياستها الخارجية خاصة. ففضلاً عن الإثارة التي تذخر بها هذه الانتخابات، وفصولها المتعددة، التي تشبه المسلسلات التلفزيونية الحريفة، فإن العالم يهتم فعلاً بالولايات المتحدة. ولا يعود ذلك فقط لحب أو كراهية الدولة الأميركية، ولكن لأن لها من التأثير على حالة وأقدار العالم أكثر من أي دولة أخرى. وأذكر أن أحد سفراء كندا في القاهرة قال لي إن وضع بلاده كمن ينام إلى جوار الفيل، بحيث يكون عليه ألا يستغرق في النوم، لأن تقلبات الفيل إلى جواره يمكنها أن تكون مميتة، وأكثر من ذلك فإن عليه طول الوقت أن يتابع حالة الفيل النفسية وعما إذا كان سعيدًا أو مكتئبًا، وحالته الصحية وعما إذا كان عليلاً أو مزدهرًا. ولعل حالة كندا ليست فريدة، فمراقبة الفيل هي حالة كل دول العالم التي تتشابك مصالحها الأمنية والاقتصادية بشكل أو آخر مع الولايات المتحدة.
من هذه الزاوية، فإن الانتخابات التمهيدية التي تقترب من الانتهاء تعطي إشارات وعلامات فريدة من نوعها، بل إنها تخالف في كثير من قواعدها الرؤية الديمقراطية للسياسة التي تحاول الولايات المتحدة تصديرها وتعليمها للعالم. فالأصل في هذه الرؤية أنه حتى يصلح ويصح النظام الديمقراطي، فلا بد أن يكون في الدولة كتلة حرجة وكبيرة تمثل ما يسمى التيار الرئيسي، الذي يتفق على أساسيات لا يختلف عليها أحد. ويكون الخلاف في العادة من ناحية على التطبيق، ومن ناحية أخرى على السرعة، ومن ناحية ثالثة في أوقات الأزمات على الاشتباك أو الانسحاب أو العزلة. وفي العموم فإن الاتجاهات الرئيسية في السياسة الأميركية مستقرة، وحينما تطورت فإن ذلك جرى على مدى قرنين أو أكثر من الزمان، عبر محطات الاستقلال والحرب الأهلية والحربين العالميتين، وصدور قانون الحقوق المدنية وحرب فيتنام. ولم يكن للتطور علاقة وثيقة بنوعية الحزب الحاكم ساعتها جمهوري أو ديمقراطي، وإنما جرت عملية التوافق على الاستراتيجيات الرئيسية، بحيث جرى تبادل السلطة دون انقلاب جوهري في الحياة السياسية.
هذا النوع من التوافق العام جرى تمزيقه خلال الحملات الانتخابية التمهيدية. فالشائع طوال المرات السابقة أن النظام السياسي الأميركي عمل باستمرار على استبعاد التيارات المتطرفة يمينًا ويسارًا، سواء من الشيوعيين أو هؤلاء الذين يقتربون من الفلسفات النازية والعنصرية. وفي نفس الوقت، فإن الأكثر تطرفًا في الحزبين وهو ناحية اليمين في الحزب الجمهوري، وناحية اليسار في الحزب الديمقراطي، جرى استبعاده من الحزب، أو كانت هزيمته ساحقة في الانتخابات العامة. جرى ذلك بالنسبة لباري جولد ووتر في الحزب الجمهوري عام 1964، كما حدث لهمفري في الحزب الديمقراطي عام 1968 وماكجفرن عام 1972. النظام هكذا كان حريصًا على استبعاد التيارات المتطرفة، ومن دخل السباق فعليًا، فإن المسافة بين المرشحين لم تكن جذرية، أو تمنع ناخبين من أي من الحزبين من التصويت لصالح المرشح الآخر من الحزب المنافس.
هذه المرة يبدو الأمر مختلفًا بشكل كبير عن السوابق التاريخية، فدونالد ترامب يمثل ظاهرة خاصة خارجة عن الأعراف الكبرى في السياسة الأميركية. فهو الرجل الذي طالب باستبعاد 11 مليون مقيم في الولايات المتحدة إلى بلادهم الأصلية في أميركا الجنوبية، مع بناء حائط بين أميركا والمكسيك تدفع ثمن بنائه الأخيرة، ومنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. ولم يكن موقف الرجل محددًا فقط من دول الجنوب ومواطنيهم، وإنما امتد لكي يراجع عددًا من الثوابت والرواسي الرواسخ في السياسة الأميركية مثل العلاقة مع حلف الأطلنطي، والعلاقات الأميركية مع اليابان وبريطانيا والمملكة العربية السعودية. وأثناء الحملة الانتخابية فإن ترامب أسقط الكثير من الآداب المتعارف عليها في السياسة الأميركية، فكانت له عباراته الفجة التي تحط من شأن النساء والسود والأميركيين من أصل إسباني، وأولئك من المنتمين لأصول عربية أو للديانة الإسلامية. ولم تطرف له عين عندما راح يكيل الإهانات لكل المنافسين الجمهوريين. والمدهش بعد ذلك كله أن الرجل فاز في الانتخابات التمهيدية، مجبرًا كافة منافسيه على الانسحاب؛ والأكثر من ذلك أهمية أنه ضغط على «المؤسسة» الجمهورية لكي تتخلى عن موقف المعارضة له، وتتحرك تدريجيًا مؤيدة إياه.
الحالة في الحزب الديمقراطي لم تكن مختلفة من حيث الجوهر. ورغم أن هيلاري كلينتون، وهي الخارجة من قلب «المؤسسة الديمقراطية»، ظلت على تفوقها طوال الحملة الانتخابية، فإنها ظلت في حالة المنافسة مع عضو مجلس الشيوخ بيرني سوندورز حتى الانتخابات التمهيدية الأخيرة في كاليفورنيا. ولكن المعضلة هنا ليس استمرار المنافسة، فقد حدث ذلك حتى مع هيلاري كلينتون عندما نافست عضو مجلس الشيوخ باراك أوباما عام 2008 حتى آخر نفس في الحملة الانتخابية. الخلاف هذه المرة أن المسافة بين كلينتون وسوندورز كانت واسعة للغاية، حيث اندفع الأخير باتجاه اليسار الاشتراكي مع الجهر بالدعوة إلى ثورة على المؤسسات المالية الأميركية، من أول البنوك وحتى شركات «وول ستريت» أو شارع المال، ومعها الشركات الأميركية الكبرى التي تمثل الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الأميركي. وبشكل محدد فإن سوندورز دفع بشدة بموضوعات تدخل في إطار ما هو معروف في الفكر الاشتراكي بشكل عام، والماركسي بشكل خاص، أن لها علاقة بالصراع الطبقي. رسالة المرشح هنا لها علاقة مباشرة بتقليب الطبقات الاجتماعية على بعضها بعضًا، وهي من الأمور شبه المحرمة في الخطاب السياسي الأميركي. نتيجة كل ذلك أن هيلاري كلينتون أصبحت في موقع لا تحسد عليه، فلكي تفوز على دونالد ترامب فإن عليها أن تجذب إلى صفها الأصوات التي اجتذبها سوندورز إلى صفه، وهؤلاء سوف يضغطون من أجل أن يكون برنامج الحزب الانتخابي أبعد ما يمكن في اتجاه اليسار. أما إذا اختارت الطريق الآخر الذي يمر بمسار التوافق الأميركي العام، فإنها في هذه الحالة سوف تخسر الانتخابات كلية.
الانتخابات التمهيدية على كلا الجانبين الجمهوري والديمقراطي نزعت بقوة في اتجاه «الشعبوية» والعزف على الأوتار الحساسة لأفكار «العزلة» عن العالم، والحالة الاقتصادية للطبقات العمالية التقليدية والعاملة في صناعات تتراجع مكانتها الاقتصادية، والموجودة بكثافة في ولايات مهمة مثل أوهايو وميتشغان وبنسلفانيا وإنديانا. ومن الغريب أنه على بعد الشقة بين ترامب وسوندورز على اليمين واليسار، فإنهما من الناحية العملية تلاقيا على سياسات في الأمن والتجارة ومع العالم، تتناقض جوهريًا مع ما كان سائدًا في السياسة الأميركية. فكلاهما يريد إلقاء أعباء ضخمة على الحلفاء، وينحو إلى نوع من السياسات الحمائية التجارية، وكذلك تضييق النطاق على الشركات الكبرى الأميركية في استثماراتها الداخلية والخارجية. في كل الأحوال، فقد يكون على كل العالم مراقبة حالة الفيل الأميركي في تقلباته الجديدة.
د.عبدالمنعم سعيد
صحيفة الشرق الأوسط
