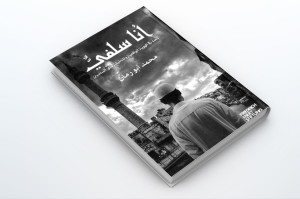“أنا سَلَفِي”: بحث في الهوية الواقعية والمتخيَّلة لدى السلفيين”، يقوم على فكرة “أن السلفية ليست أمرًا محدثًا ولا غزوًا دينيًّا” للمجتمع العربي، فهي “تيار عريض له تراثه الفقهي والفكري والدعوي”، و”حالة معاصرة لها حضورها الملحوظ في مختلف مناحي الحياة العربية”. ويقرر محمد أبو رمان وفقًا لذلك أن هدف الدراسة هو “الاقتراب من المجتمع السلفي وتقريبه إلى القارئ من خلال روايته الذاتية عبر منهج يقوم أساسًا على المقابلات الخاصة مع شخصياته وأفراده” الذين قدَّم كل منهم علاقته مع التيار السلفي من خلال سرده لسيرته الذاتية المتصلة بهذا الخصوص.
وهذا الكتاب ليس هو الأول لأبو رُمَّان، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية وشؤون الإصلاح السياسي، ذي الباع الطويل نسبيًّا في تتبع التيارات “الجهادية” خاصة تلك التي كانت على صلة بالأردن، وقد يكرِّر في مؤلَّفه هذا بعض المعلومات “حول الجماعات والحركات السلفية الأردنية”، كما يقول هو نفسه، لكنَّه الأول له من نوعه من حيث المنظور “السردي” وتناول “الهوية السلفية” “سوسيولوجيًّا”، ويستهدف عينة من الشخصيات “السلفية الأردنية” ربما تجاوزت بنشاطها ميدان الأردن سواء من حيث المشرب الذي استقت منه تعاليمها وتجاربها، أو نشطت فيه والتبشير بأفكارها.
تقسِّم الدراسة السلفيين نظريًّا في الأردن إلى ثلاثة أقسام: الاتجاه التقليدي، الاتجاه الحركي، والاتجاه الجهادي، وبالتالي فإن اختيار النماذج التي تعرَّض الكاتب لسيرتها لا تخرج عن أيٍّ من هذه الثلاثة. وحذَرًا من الاعتراضات العلمية حول صحة التمييز بين هذه الاتجاهات والقواسم المشتركة بينها فإن الكاتب يقترح أن هذا التقسيم هو “أفضل المتاح لتمييز الاتجاهات الفاعلة في المشهد السلفي” الأردني. وتتناول القراءة النقدية لهذا الكتاب البحثَ في الاتجاهات الثلاثة من خلال سؤال “الهوية”، والبحث عن أسباب جاذبية التوجه السلفي لمعتنقيه، مع ملاحظة أن النقد قد يختلط أحيانًا مع النص الأصلي للكتاب.
السلفية كما تقدم نفسها
يدرك المؤلِّف أن تعريف السلفية إحدى المعضلات التي ما زالت تواجه الباحثين لاسيما أن المصطلح فضفاض جدًّا، ويدخل فيه من حيث الاستعمال والاستدلال تاريخيًّا وواقعيًّا، الأكثر تشددًا واعتدالًا، فقهيًّا أو سياسيًّا، ربما لهذا اقتصر على تلك التي تقترب من “الوهابية”، فمدرسة المنار التاريخية مثلًا، التي من أهم روادها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا والمعروفة باسم “السلفية الإصلاحية”، لا تدخل تحت السلفية التي هي قيد البحث والتناول في هذا الكتاب، مع الإشارة إلى أن العلامة الفارقة فيها كانت تجاوز النص المذهبي والانفتاح على الاجتهاد.
وبخصوص القسم الأول، هناك التيار الوهابي الرئيسي الذي ينتسب للسلفية، والعلامة الفارقة فيه فضلًا عن تجاوز المذهبية والعودة “للنص”، هي العودةُ لفهم “السلف الصالح” خاصة في القرون الأولى من عُمر الرسالة والحفاظ على النقاء العقدي لاسيما عقيدة التوحيد ونفي كل أشكال “الشرك بالله” عنها، سواء في العبادة أو السياسة أو الاجتماع. وينتمي لهذا التوجه باعتبار توجهه السلمي (أي التيار السلفي السلمي) ما قد يوصف بـ”السلفية العلمية” في إشارة لأولوية “العلم الشرعي” فيها أو السلفية الجامية نسبة إلى أمان الله الجامي الذي ركَّز على عدم جواز الخروج على ولي الأمر. وهذان التياران سمَّاهما الكتاب: “التيار التقليدي” لامتزاجهما توجهًا واحدًا في الأردن. والقسم الثاني هو “السلفية الحركية”، وهي في الأغلب استدراك في الشِّقِّ السياسي والدعوي على “السلفية التقليدية” لقبولها بالعمل المؤسسي واقترابها من العمل الفكري والسياسي.
وبخصوص القسم الأخير، فقد أحدث بعض “التيار الجهادي” في الثمانينات من القرن الماضي في أعقاب حقبة “الجهاد الأفغاني” نقلة نوعية في فهم كلٍّ من “السلفية” و”الجهاد” معًا، فلم تعد السلفية التقليدية كافية لهذا التيار كما روَّج لها آباؤها، ولم تقنعه مقولات “الجهاد”، كما أرستها التيارات الإسلامية الفكرية والسياسية السائدة -مثل حركة الإخوان المسلمين أو حزب التحرير الإسلامي وسواهما- واستفاد من الجماعات الجهادية المصرية وربما من الجزائرية أيضًا ومن تلك التي كان لها تجربة “أمنية أو عسكرية خاصة” في دولها، وبهذا أصبح الخلط بين كل ما يتصل بمصطلحي “السلفية” “والجهادية” أمرًا شائعًا وسائغًا إلى حدِّ الفوضى.
ومن هنا، وأخذًا بالاعتبار ما نال فكرة “السلفية” والمنتسبين إليها من تشظٍّ وتناسل وتحولات، تنشأ أهمية كتاب “أنا سلفي” -أو ما قد يُنسَج على منواله- ولو في السياق الأردني على الأقل، الذي يقترح عمليًّا الانتقال من النقاش النظري لتقرير “من هو السلفي” إلى أرض الواقع حيث تعيد السلفية تعريف نفسها ولو بطريقة غير مباشرة، من خلال “سردية” يقصُّ فيها “السلفي” من هو سلوكيًّا كما هو معرفيًّا، وكيف كان وإلى أين يمضي من خلال منظور “سوسيولوجيا الهوية”.
واختار الكاتب لهذه الغاية مجموعة من الشخصيات والنماذج التي “تبنَّت” يومًا، أو ما زالت، النهجَ السلفي، كما وضع استبيانات وصل عددها إلى 32 استبيانًا، ليجيب جميعها من خلال أهلها على سؤال مركزي أساسي: من “هو السلفي”؟ ليستعرض بذلك نماذج أردنية تحولت إلى النهج السلفي بشقيه التقليدي والجهادي إضافة إلى أخرى تجاوزته إلى نماذج إسلامية أخرى أو إلى خارجه حتى وصلت إلى حدِّ العلمنة.
جاذبية التوجه السلفي التقليدي
استنطق الكتاب في فصله الأول نماذج سلفية عدَّة لتجيب على سؤال: “كيف صِرتُ سلفيًّا؟”، ويقرر في سياق حوار مع 9 أشخاص من سلفيي “حي الطفايلة” أن ما أقنعهم بالدعوة السلفية هو حرصها على العلم الشرعي وتحريها الأدلة الصحيحة في هذا المضمار، وتركيزها على الشؤون الدينية وعدم التعصب لحزب وعدم خلط الدين بالسياسة، وهؤلاء يمثِّلون على الأغلب السلفية التقليدية. وفي نفس السياق يستنطق نماذج أخرى تتصف ببعض السمات الخاصة بها، فهناك الأكاديمي السلفي الدكتور معاذ العوايشة المتخرج في كلية الشريعة، والذي انتهت به تجربته إلى ضرورة عدم تقديس “المشايخ على حساب المنهج”، وينتقد تركيز شيوخ التيار على “التصفية” المتصلة بتنقيح العلم الشرعي، وضرورة إعادة الاعتبار “للتربية” التي أُهملت كثيرًا، ويدعو للعمل الجماعي المؤسسي في تجاوز للخطوط الحمراء التي دأب عليها التيار السلفي، ليكون أكثر تأثيرًا. وهناك عمر البطوش الذي مثَّل نموذجًا متقدمًا في خرق موقف التيار السلفي التقليدي من العمل السياسي، ورأى أن لا تناقض بين السلفية والعمل السياسي السلمي وأن هذا الأخير ليس بالضرورة أن يكون عصبية، كما ذهب إلى القول بأن لا إجماع على “عدم جواز الخروج على الحاكم” إلا إذا ظهر منه كفر بواح، وأنه موضع اختلاف الفقهاء وإن كان لا يقول هو نفسه بجواز الخروج على الحكام.
ويركِّز الكتاب في محاولته لتفسير سبب جذب النهج السلفي للمؤمنين به، على ما سماه “الغواية العلمية” لأن من يحظى “بالعلم الشرعي” يحظى “بسلطة” على قلوب الناس، خاصة وأن “الشيخ الرئيس” لهذا التيار في الأردن كان يتصف بكونه العالم الاستثنائي، “المحدِّث ناصر الدين الألباني”، حيث ترجع إليه “علميًّا” بصورة من الصور، كل الظواهر السلفية في الأردن، سواء كانت على رأيه أو خالفته في حياته أو من بعد مماته.
جدل السلفية الجهادية
يتتبع المؤلف جذور “السلفية الجهادية” في الأردن بدء من أوائل التسعينات؛ حيث “ظهرت جماعات عنف إسلامية” غير مرتبطة تنظيميًّا، ويجمعها خيط فكري يتصل بتوجه سلفي عام متأثر بأفكار سيد قطب لاسيما الحاكمية وكفر القوانين الوضعية.
ويؤرَّخ للحظة الولادة الفعلية “للسلفية الجهادية” من خلال كتب عصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي) التي من أبرزها: “كتاب ملَّة إبراهيم وأساليب الطغاة في تمييعها”، وهي الأفكار التي تمثَّلَها أبو مصعب الزرقاوي رغم الخلاف الذي نشب بين الطرفين لاحقًا، وكانت تربط بين “التوحيد” كما تعرفه السلفية والذي من موجباته “تكفير الحاكم بغير الشريعة الإسلامية”، والجهاد سبيلًا وحيدًا للتغيير دون هوادة.
ويشير الكتاب إلى شخصية أخرى كان لكتاباتها أثر كبير على السلفية الجهادية الأردنية في نفس الفترة، ألا وهي عمر محمود عثمان (أبو قتادة الفلسطيني)، إضافة إلى شخص آخر أقل أثرًا ولم يمكث في الأردن إلا قليلًا، وهو عبد المنعم أبو حليمة (أبو بصير الطرطوسي). هذه الشخصيات المشار إليها هي من الأكثر سيولة في الإفتاء والتنظير للتيار الموسوم بالجهادي في السنوات الأخيرة، كتيار نقدي يستهدف السائد بغية “تصويبه” أو “تهذيبه”، والملاحظ أنها اعتمدت على “الجاذبية العلمية” في تأسيسها لنهجها “الجهادي” لتُضفي عليه “العلمية” في وجه المخالفين وتؤكد موثوقيته وحُجيته، كما أغفل الظروف السياسية والفكرية التي جعلت من “التيار الجهادي” الفكر المفضل لبعض السلفيين أو محط إعجابهم وتعاطفهم، بل لم يقترب الكتاب في استقرائه للسلفية الجهادية من سيرة هذه الرموز أو من يدانيها في التأثير، بذريعة التعرف على “تجارب إنسانية من الحياة اليومية” لسلفيين أقل أهمية، وبدون شك أن كل هذا فوَّت على المتتبع فرصة فهم بعض الديناميات التي أسهمت في تحول السلفية من طورها التقليدي إلى طورها الجهادي، سواء على المستوى الأردني أو ما يتعداه.
وفضَّل أبو رمان اختيار نماذج أخرى، منها على سبيل المثال منيف سمارة، وهو من الشخصيات الأكثر تعبيرًا نسبيًّا عن السلفية الجهادية في الكتاب، فهو يرى منهج السلفية الجهادية منهج “الطائفة المنصورة” إلا أنه يميِّز بين “الواجب” وهو التغيير، و”الممكن” أي عدم القدرة عليه لاسيما في الأردن، وبالتالي فإن التخلي عن العمل المسلح بخصوص هذه الحالة لا يعني التخلي عن المنهج، كما أن الأولوية هي للجهاد في سوريا. وهو في هذا الشأن ليس بعيدًا عن توجه أبي محمد المقدسي، بل إن هذا التوجه هو إحدى السمات التي تميِّز “النصرة” عن “تنظيم الدولة الإسلامية”، حتى إن الأخيرة تعتبر ذلك انحرافًا عن المنهج من “النصرة” وأنصارها.
ما خلا ذلك لا نجد في الكتاب سِيرًا لنماذج تعبِّر حقيقة عن “التيار الجهادي” بروايتها الخاصة دون تحفظ، وربما هذا منطقي لأن الأسباب الأمنية تحول دون أن يعلن أولئك عن أنفسهم صراحة، ولكن من الواضح أيضًا أن أغلب هذه النماذج تتميز ببعض الخصوصية عن “التيار الجهادي” ولها استدراكات أو مؤاخذات على بعض ممارساته، فكيف تكون سِيَرها معبِّرة عنه؟ فهذا بدون شك يحول دون أن يحقق الكتاب هدفه في ما يتعلق بعرض هوية “التيار الجهادي” كما هي، ونجد أنفسنا أمام آراء خاصة جدًّا بأصحابها ولا تضيف الكثير من هذا الجانب رغم غناها الفكري وربما الفقهي، لا بل قد يظهر بعض “مساوئ” هذا التيار في سياق نقدي، لتحرم الكتاب من فرصة التركيز على وجه “الجاذبية” لدى السلفية الجهادية ومقداره وأطواره ونحوه.
السلفية الحركية والبحث عن طريق
يضم التيار الثالث غالبية السلفيين الذين قبلوا خلافًا للسلفية التقليدية بالعمل التنظيمي السياسي وبمشروعية المعارضة، ويؤمنون بالعمل على تغيير النظام وإقامة الشريعة وقد يقولون بتكفير الحكام أو دون ذلك ولكن دون تبني العمل المسلح.
وتعود جذور هذا التيار في الأردن بحسب الكتاب إلى عمر محمود (أبي قتادة) وحسن أبي هنية اللذين راسلا “شخصيات من التيار السلفي الصحوي الصاعد في السعودية مثل سفر الحوالي”، وتكونت لديهما رؤية مخالفة للشيخ الألباني في منتصف الثمانينات والذي كانت له نظريته المعروفة “التصفية والتربية”، الا أن هاتين الشخصيتين أصبحتا خارج هذا التيار. ويستطلع الكتاب في هذا السياق النماذج السلفية التي وقعت على خط الافتراق ما بين التيار التقليدي والجهادي وأهم ما يجمعها أنها تبحث عن “طريق ثالث”، منها على سبيل المثال: زايد حماد، الذي شارك في تأسيس جمعية الكتاب والسنَّة وعايش مرحلة تمايزها عن التيار الجهادي بل هو من أقصى هذا التيار من الجمعية، بهدف إعادة تعريفها في “السياق الإصلاحي لا الثوري” والعمل المدني السلمي والدعوي والخيري لا الانشغال بالمواجهات الفكرية مع الآخرين أو المواجهة مع الدولة. ونموذج آخر هو هشام الزعبي، مؤسس “جمعية الاعتصام”، الذي يرى أن جمعية الكتاب والسنَّة “أصبحت قريبة من الدولة” وتحرص على عدم إزعاجها، في حين أن جمعيته “تحرص على عدم استعداء الدولة” فقط.
وما يهدف المؤلف لقوله من هذه النماذج: إن ما يقع منها ما بين التيارين التقليدي والجهادي ليس ناضجًا كفاية ليكون طريقًا ثالثًا، لأن إجماعه على اعتماد الوعاء “التنظيمي والحركي” كأحد وسائل العمل يقابله غموض في موقفه الأيديولوجي من الحاكمية (كما نظَّر لها سيد قطب) لاسيما موقفه من الحكومات: هل هي “كافرة أم عاصية”؟ وما يترتب على ذلك من تحديد منهج التغيير باعتماد “المسار الديمقراطي أم السلمي أم التربوي أم الدعوي”.
ووفق هذا التوصيف قد يستنتج البعض أن هذا التيار هو الأقل جذبًا من بين التيارات السلفية بسبب “غموض الرؤية” لديه وقلة مراجعه ورموزه في الأردن، ولكن واقعًا لا يمكن الجزم بذلك على صعيد الأردن، بلا ربما نجده على خلاف ذلك على صعيد العالم العربي خاصة بعد “الثورات العربية”؛ حيث أثبت “الغموض العقائدي”، إذا جاز التعبير، في حالة الإخوان المسلمين أنه عنصر جذب لجمهور أوسع وأنتج بيئة داخلية أكثر تسامحًا الأمر الذي لم يتوقعه مخالفوه عمومًا، وكان في ذلك على النقيض من “التيار السلفي الذي يُصر على “الوضوح العقائدي”. وبعبارة أخرى: إن “غموض الرؤية” لدى السلفية الحركية -سواء كان نتيجة حيرة أم لا- بإمكانه أن يكون دينامية تسامُح ليشكِّل عامل جذب وحشد لشرائح أوسع من المجتمع الأردني أو العربي السلفي أو المتدين.
خاتمة
يبدو أن كتاب “أنا سَلَفي” لأبي رمان قد أسهم في تعقيد الإجابة عن سؤال الهوية لاسيما السلفية بدلًا من تبسيطه؛ وذلك لأسباب يمكن الإشارة لأبرزها:
• أولًا: أنه أراد من نماذج محددة أن تقدِّم له تفسيرًا عن سبب تبنِّيها “للسلفية” أو لماذا تحولت عن سلفيتها في سياق مواجهتها لتحديات وأزمات متعددة محلية وغير محلية. وفضلًا عن كونها ليست كافية فقد بدت وكأنها استثناء من “النموذج السلفي” القياسي، لأن السلفية تقر بالتعددية في داخلها ولو بنسب متفاوتة اعترافًا منها بتأثير الزمان والمكان وإمكانات النص. ويمكن القول في هذا السياق: إن الأزمات المؤثّرة على السلفية كـ”هوية” هي نفسها التي ستؤثر على أي “هوية أخرى صعودًا وهبوطًا، أو الإيمان بها أو التخلي عنها، أو حتى إغنائها أحيانًا، سواء كان سلفيًّا أو إخوانيًّا أو علمانيًّا أو غير ذلك. وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك أزمة هوية في الأردن مرتبطة بثنائية “فلسطيني-أردني” وأخرى حول شرعية “الدولة القُطرية” وحدود “سايكس-بيكو” وحول موضع الدين برمته من الدولة.. وهكذا دواليك.
وفضلًا عمَّا سلف فقد اقترب بطريقة ما الأسلوب المتبع -في تناول النماذج التي اختارها الكتاب- من ذاك السرد الذي تعتمده الجماعات الدينية لإدانة معتقد أو الانتقاص منه في سياق صراع مذهبي (سني/شيعي)، أو ديني (مسلم/مسيحي) ولو لم يقصد ذلك؛ حيث الحديث عن قصص المهتدين المتحولين من مذهب أو دين إلى آخر.
• ثانيًا: التأسيس النظري لفكرة أنَّ “السلفية” هوية قائمة بنفسها لم يظهر تأثيره في معالجة هذه النماذج، لاسيما أن المنظور المنهجي الذي افترضه -على ما فيه من فوائد واضحة في تفسير بعض سلوك “التيارات السلفية”- ليس فعَّالًا حينًا وليس كافيًا حينًا آخر للتمييز بين أشكال السلفية نفسها أو حتى تمييز السلفية عن سواها من التيارات الإسلامية بدقة أو عن معتقدات جمهور الناس؛ حيث افترض في هذا الصدد أن “السلفية آلية تأكيد على الهوية في مواجهة العولمة”، وأن “أزمة الهوية” هي إحدى أدوات تفسير الصعود السلفي، إضافة إلى ترسيم علاقة الفرد السلفي مع جماعته بوصفها “مرجعيته” الخاصة التي تحدد سلوكه، وهذه الافتراضات تحمل بذور أحكام مسبقة وغالبًا ما تم استخدامها، وإن بتفاوت، فحكمت على “التيار الإسلامي” برمته -وربما على المجتمعات العربية- بوصفه تيارًا سلفيًّا ماضويًّا انتقائيًّا إزاء الحداثة وما إلى ذلك، أي استخدامها للمقارنة بين البيئة الدينية مع حالة من خارجها تمامًا بهدف إدانتها.
• ثالثُا: بدا الكتاب أحيانًا في سياق “السرد” نفسه كأنه يضع “هوية غير سوية”، أي السلفية في مقابل تصور آخر “للهوية” السوية دون أن يحدد أيًّا من معالم هذه الأخيرة؛ فالسَّلَفي منغلق اجتماعيًّا ومتشدد دينيًّا، ويعاني من أزمة هوية ويشعر بالانتقاص في مواجهة “العولمة”، وأحيانًا تملؤه العقد النفسية كما هو مثال “الجهادي الصغير مؤيد” الذي كما يقول: “لم يكن متاحًا أمامه ما يفعله المراهقون الآخرون من وسائل تصريف الطاقة المكبوتة والهائلة سواء في التدخين أو الحديث عن الفتيات أو حتى مشاهدة الأفلام الإباحية أو غيرها من الممارسات التي يرى التيار الجهادي حرمتها…”. وهذا التصوير بالطبع يصلح استخدامه لإدانة كل التيار الإسلامي بل ربما السائد في الثقافة العربية حيث يصبح الداعي لسبيل “الجهاد” هو الغريزة المكبوتة، وفيه مجازفة ومبالغة كبيرة، وهو قد يكون مألوفًا عندما يكون الكاتب من الضفة الأخرى المقابلة تمامًا كأن يكون “غربيًّا” مثلًا، بل ولا يقف على نفس الأرض التي تنتمي إليها التيارات السلفية.
• رابعًا: من الملاحَظ أن هناك شخصيتين ذُكرتا في أكثر من موضع في الكتاب باعتبارهما شخصيتين قياديتين في التنظير للسلفية وتأسيسها في الأردن أو إرساء بعض مفاهيمها خارجه، وحظيت على الأقل إحداهما بحماس استثنائي ألا وهي شخصية حسن أبو هنية، أحد الباحثين المتخصصين بالتيارات الإسلامية راهنًا؛ فهو بحسب “السرد” أول من دعا إلى عولمة الجهاد، وأول من أدخل البُعد المؤسسي على العمل السلفي الأردني، ومن أوائل مؤسسي السلفية الحركية في الأردن، مع تقرير ما له من صلة مع أبي قتادة الفلسطيني، الطرف الثاني المعني بالرواية، واللافت أن رواية هذا الأخير الشخصية غابت عن الكتاب، فقد كان شريك أبي هنية في السلفية الحركية ومن أبرز المتحولين نحو “الجهادية”، وفي هذا السياق هي الأدعى بالتناول والبحث ومن صميم مقصود الكتاب.
وفي الختام، إن كان طموح “أنا سَلَفي” نحو تفسير “الهوية السلفية” موضع جدل فإنه كان أكثر دقة في بيان العلامات الفارقة في التيارات السلفية ومذاهبها، ومن ذلك ذكره “الغواية العلمية” كإحدى السمات الجاذبة فيها لا بل هي الأهم في هذا الشأن. ولا يزال الكتاب رواية استثنائية تشرح سلوك شخصيات كان لها حظوظ متفاوتة من المشرب “السلفي” من خلال روايتها لسيرتها الذاتية، وسيضيف الكثير سواء على صعيد محاولة فهم هذا التيار وتعريفه أو رصد سبل تطوره أو تقلب بعض معتنقيه بين التيارات الإسلامية الأخرى أو الخروج عنها جميعًا، فضلًا عن خوضه بشجاعة في “الهوية الواقعية والمتخيَّلة لدى السلفيين” وما في ذلك من استدعاء لبحوث أخرى أكثر دقة في هذا الاتجاه لدراسة نفس هذا التيار أو سواه من التيارات الأخرى.