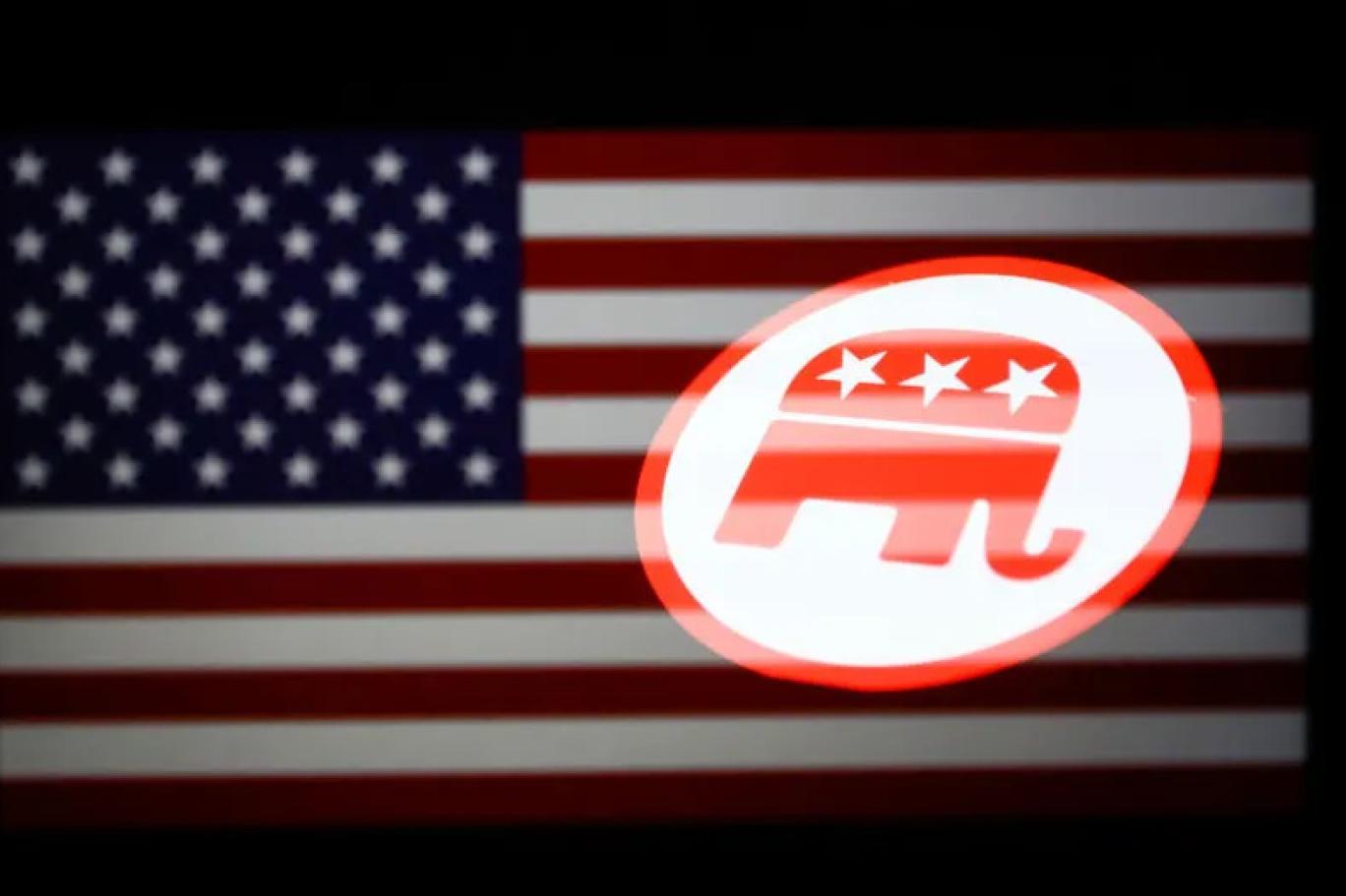من الصعب تذكر مرحلة أكثر اضطراباً وفوضوية في تاريخ الحزب الجمهوري الأميركي من تلك التي نشهدها حالياً، ولعل فترة رئاسة أندرو جونسون فقط بين عامي 1865 و1868 من اقترب من هذا المستوى. فالزعيم الفعلي للحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترمب، يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة. وبعد مرور تسعة أشهر على تولي كيفين مكارثي، النائب [الجمهوري] عن ولاية كاليفورنيا، منصب رئاسة مجلس النواب، أُقيل على يد ثمانية أعضاء من حزبه، مما أدى إلى انطلاق مسابقة تنافسية معقدة بين مختلف الأطراف تركت مجلس النواب مشلولاً لأسابيع قبل أن يتمكن عضو غير معروف من جمع الأصوات الكافية ليحل مكانه. كما قام الجمهوريون في مجلس النواب بالتلاعب بفكرة إغلاق الحكومة والمخاطرة بالتخلف عن سداد الدين الوطني بموجب تشريعات لا تمتلك أدنى فرصة بالحصول على الدعم حتى من زملائهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في حين كان ترمب ينشر الأكاذيب حول انتخابات عام 2020 ويضع استراتيجيات حول استعمال السلطة التنفيذية الأميركية كسلاح ضد خصومه.
في الواقع، يتجلى الاضطراب الذي يعانيه الحزب الجمهوري بصورة خاصة، وخطرة في آن، في مجال السياسة الخارجية. على مدى عقود من الزمن ومنذ عام 1952، كان الحزب الجمهوري يتمتع برؤية دولية واضحة نوعاً ما، تتلخص في تعزيز الأمن الأميركي والقوة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه دعم توسيع الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم. وكان ذلك يعني بناء جيش قوي والتعاون مع الحلفاء من أجل النهوض بالمصالح المشتركة وزيادة قوة الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية وتعزيز التجارة الحرة وضمان المنافسة الدولية العادلة للشركات الأميركية والدعوة إلى سيادة القانون في موضوع الهجرة ومعارضة الاستبداد، خصوصاً في الحالات التي يتحدى فيها المستبدون المصالح الأميركية بصورة مباشرة.
لكن التزام الجمهوريين بهذه المبادئ ضعف بشكل ملحوظ. فترمب يتذبذب بين الرغبة في إبراز قوة الولايات المتحدة في الخارج وبين الانعزالية، وهو الذي تعهد أخيراً بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ووقف استيراد السلع الصينية ونشر الجيش الأميركي في الشوارع الأميركية لمكافحة الجريمة وترحيل المهاجرين و”طرد” “دعاة الحرب” و”أنصار العولمة” من الحكومة الأميركية. في المقابل، يعرب زعماء محافظون آخرون، مثل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، عن عدائهم الصريح تجاه الاستمرار في الوفاء بالالتزامات الأميركية الدولية. بطريقة موازية، قدم معظم المرشحين الرئاسيين من الحزب الجمهوري دعماً غير مشروط لإسرائيل بعد هجوم حركة “حماس”، ويبدو أن ترمب أعجبه ذلك. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، هناك انقسام بين ساسة الحزب، إذ صوت ما يزيد بقليل على نصف الجمهوريين في مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) 2023 على وقف المساعدات الأميركية المخصصة للدفاع عن كييف ضد الغزو الروسي.
إذاً، لا يبدو أن الوقت مناسب لإعادة إحياء منظور الأممية الجمهورية التقليدية داخل الحزب الجمهوري [تشير الأممية إلى نهج السياسة الخارجية الذي يتميز بالتزام التحالفات الدولية والتجارة الحرة والمشاركة النشطة في الشؤون العالمية]. وإلى حد ما، تعكس مواقف قادة الحزب الجمهوري تحولاً انعزالياً واضحاً بين ناخبيهم. وفي هذا الإطار، وجد استطلاع أجرته مؤسسة “سيفكس دايلي تراكينغ” Civiqs Daily Tracking في أغسطس (آب) 2023 أن 77 في المئة من الناخبين الجمهوريين المسجلين يوافقون على ضرورة تقليل الولايات المتحدة من اضطلاعها بحل المشكلات في الخارج. ويبدو أن تطوير سياسة خارجية واضحة ليس أمراً ملحاً بالنسبة إلى الجمهوريين. ففي أبريل (نيسان) 2023، ووفق استطلاع أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” سئل ناخبون محتملون للحزب الجمهوري عن أهم القضايا والعوامل التي يستندون إليها في تقييم المرشحين للرئاسة، فكانت المرتبة الرابعة من نصيب السياسة الخارجية جنباً إلى جنب مع موقف المرشح في شأن الجريمة. وبحلول أغسطس 2023، صنف ناخبو الحزب الجمهوري السياسة الخارجية باعتبارها أدنى أولوياتهم بين 14 موقفاً سياسياً، واعتبروا أن المواقف المتعلقة بالاقتصاد والتضخم والهجرة وغيرها، أكثر أهمية.
لكن في الواقع، من المفترض أن تشكل السياسة الخارجية أولوية قصوى، فالعالم يزداد خطورة، والسياسة الخارجية تؤثر بصورة مباشرة في حال الاقتصاد المحلي، وبذلك في سبل عيش الأميركيين. إن تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في الخارج ووجودها في المؤسسات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي، هو بمثابة رادع للعدوان الأجنبي الذي قد يضر بالاقتصاد الأميركي. كما أن توسيع التجارة يساعد على خلق منافسة دولية عادلة للشركات الأميركية. علاوة على ذلك، فلقد لعبت السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس جو بايدن دوراً في مفاقمة الوضع الاقتصادي الذي يضعه الناخبون الجمهوريون على رأس أولوياتهم. فإدارة بايدن تعمل انطلاقاً من النظرية القائلة إن السياسة الخارجية الأميركية قد خذلت الطبقة الوسطى وتحتاج إلى الإصلاح من خلال حماية السوق والإعانات الحكومية، لكن هذا النهج أدى إلى تأجيج التضخم واضطراب الأسواق وعرقلة التجارة وتوتر العلاقات مع حلفاء واشنطن.
تحتاج الولايات المتحدة إلى حزب جمهوري قوي وديناميكي. ولكي يقدم الحزب استراتيجية أكثر تماسكاً لمعالجة التحديات التي تواجهها البلاد، سوف يحتاج إلى أن يركز بصورة واضحة على سياسته الخارجية. وتظل الأممية المحافِظة التقليدية هي أفضل وسيلة لحماية الأمن القومي الأميركي وإدارة الاقتصاد. وفي الواقع، ربما من الممكن أن يرحب الناخبون بفكرة اعتماد أجندة سياسة خارجية أممية، إذا قدمت هذه الأجندة إليهم بشكل مقنع. في ذلك السياق، كشف استطلاع للرأي أجراه “معهد ريغان” في يوليو (تموز) 2023 عن أن “غالبية كبيرة من الأميركيين يعتقدون بأن بلادهم يجب أن تقود العالم وتستثمر في القوة العسكرية وتعزز التجارة الدولية وتدعم الحرية والديمقراطية، وتقف إلى جانب أوكرانيا إلى أن تفوز في حربها ضد العدوان الروسي”. في المقابل، فإن أولئك الذين يصفون أنفسهم على أنهم ناخبو ترمب اعتبروا أنفسهم أمميين، لا انعزاليين، وعندما أوضح منظم الاستطلاع كيف أسهمت المعونات المرسلة إلى أوكرانيا في تعزيز أمن الولايات المتحدة، زاد دعمهم لتلك المساعدات بنحو الثلث، من 50 في المئة إلى 64 في المئة.
فالأميركيون، بمن في ذلك المحافظون، ما زالوا متمسكين بهويتهم التاريخية: إنهم أمميون مترددون، لكنهم على رغم ذلك أمميون في جوهرهم وصميمهم. هم لا يستجيبون بصورة إيجابية للنداءات المبهمة الداعية إلى الحفاظ على “النظام الدولي”. لكنهم يدركون أنه إذا سمح العالم للصين بأن تضع القواعد، فإن الحريات الأميركية سوف تصبح أقل أماناً، وسوف تتضرر الأعمال التجارية الأميركية، وسيصبح حلفاء الولايات المتحدة عرضة للخطر. لا يحتاج الناخبون إلى جمهوريين يذعنون للترمبية أو يتفاعلون مع استطلاعات رأي تشير إلى دعم محدود للأممية، بل ما يحتاجون إليه في الحقيقة هو أن يقدم لهم الجمهوريون رؤية شاملة حول ما يحدث في العالم وكيف ينوي الحزب حماية البلاد وضمان ازدهار الأميركيين. ولا يمكن تقديم مثل هذه الرؤية من دون وجود سياسة خارجية واضحة.
خطط حماية
على رغم تخلي بايدن عن أفغانستان، فقد أبلت إدارته بلاءً حسناً في حشد الدعم لأوكرانيا وتعزيز التحالفات الدفاعية الأميركية في المحيط الهادئ ومساعدة إسرائيل في الرد على هجوم “حماس” الإرهابي. لكن هناك ثغرة كبيرة في جوهر سياسة بايدن الخارجية، وهي ناجمة عن الاقتصاد الحمائي [سياسة اقتصادية تدعو إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية من خلال تدابير مثل التعريفات الجمركية وحصص الاستيراد والحواجز التجارية الأخرى]. في قلب السياسة الخارجية لإدارة بايدن، يوجد اعتقاد بأنه على رغم وفرة مصادر الديناميكية والحيوية الأميركية، على غرار أسواق رأس المال الخاص والعام التي تشهد أحجام تداول كبيرة، وسياسات الهجرة القانونية المتساهلة نسبياً وجامعاتها ذات المستوى العالمي والحماية القوية من الإفلاس بموجب الفصل 11 [قسم من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة يتناول إعادة تنظيم الشركة المتعثرة مالياً]، وقوتها العاملة المبدعة والماهرة بصورة فريدة، إلا أنه لا يمكن للشركات الأميركية أن تزدهر محلياً أو تنافس على الصعيد الدولي ما لم تمولها الحكومة وتحميها من المنافسة.
إن العواقب المترتبة على هذا المفهوم الخاطئ تماماً هي جيوسياسية واقتصادية على حد سواء. لقد فشل بايدن في التأكيد على انضمام الولايات المتحدة مجدداً إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارية مع 12 دولة آسيوية ديناميكية وقع عليها الرئيس باراك أوباما لكن ترمب تنصل منها. وعوضاً عن ذلك، عرض بايدن بديلاً فارغاً في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، اتفاق غامض لم يتردد البيت الأبيض في الاعتراف بأنه “ليس اتفاقاً تجارياً”. كذلك، تتخلى الإدارة عن فرصة لخفض التعريفات وتعزيز معايير العمل والبيئة بالنسبة إلى الواردات، وهي بذلك توفر مكاسب مباشرة للصين: ففي 2021، تقدمت الصين بطلب الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ لتحل محل الولايات المتحدة.
وقد أدت قيود “شراء السلع الأميركية” التي فرضتها إدارة بايدن إلى الضغط على سلاسل التوريد، ومعاقبة الشركات الأجنبية مثل “سامسونغ” و”تويوتا” اللتين خلقتا عدداً كبيراً من الوظائف في الولايات المتحدة، وأثارت غضب الحلفاء الذين ستحتاج إليهم الولايات المتحدة في صراعها المستقبلي مع الصين. وعلى رغم أن بايدن اعتبر أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب فاشلة وتأتي بنتائج عكسية، إلا أنه لم يلغِها. ومع أن الجنوب العالمي يبدي لهفة لتنشيط التجارة والاستثمار الدوليين، إلا أن فريق بايدن يتنازل عن هذه الفرص التجارية للشركات الصينية. وهذا لا يؤدي إلى تفويت الفرص الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم إعطاء الدول النامية سبباً كافياً لدعم الولايات المتحدة عندما تستنجد واشنطن بتلك الدول في جهودها الرامية إلى مساعدة أوكرانيا وإسرائيل.
في المرحلة المقبلة، إن موقف بايدن في السياسة الخارجية سيمنع الولايات المتحدة من تحقيق اقتصاد كبير يمكن أن يضاهي اقتصاد الصين أو يتفوق عليه، خصوصاً مع تعميق بكين تعاونها مع موسكو وطهران. في الواقع، ينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين هو إجبارها أو تحفيزها على أن تصبح من أصحاب المصلحة والمشاركين المسؤولين في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية، أي أن تلعب وفقاً للقواعد الدولية. لكن إدارة بايدن، في سبيل منع الصين من الحصول على تقنيات حيوية مثل أشباه الموصلات المتقدمة، دعت إلى نهج “ساحة صغيرة وسياج عال” الذي يحمي عدداً محدوداً من التقنيات، بيد أنه يصدر تهديدات شديدة بفرض عقوبات ثانوية ضد الخصوم والحلفاء على حد سواء إذا لم يحدوا أيضاً من مبيعاتهم إلى الصين. ويخاطر هذا الموقف بتنفير الحلفاء الذين يشاركون الولايات المتحدة الأهداف الأمنية، ويستثمرون في الشركات الأميركية، ويشترون كميات هائلة من المنتجات الأميركية، ويتباهون بشركاتهم المتطورة التي تحتاج الشركات الأميركية إلى ابتكاراتها التكنولوجية وقدراتها التصنيعية. على سبيل المثال، أعربت لاهاي وطوكيو عن استيائهما لأن واشنطن انفردت بقرار فرض قيود على أدوات صنع الرقائق وطالبت الحلفاء بأن يحذوا حذو الولايات المتحدة.
يطالب حلفاء الولايات المتحدة بوضع استراتيجية اقتصادية أميركية تساعدهم في تقليل اعتمادهم على الصين.
كان يتعين على واشنطن أن تفرض منذ فترة طويلة قيوداً أكثر صرامة على التمويل الأميركي للتقنيات العسكرية الصينية وتقلل الاعتماد على المنتجات الصينية في المجالات الحيوية مثل الأدوية. في الواقع، إن اعتماد نهج أفضل تجاه الصين سيتضمن تقديم فوائد تجارية للدول الحليفة في هيئة حلف شمال الأطلسي الاقتصادي، وتشجيع الحكومات الحليفة على منع الشركات من الاندفاع إلى الأسواق التي تقيدها الحرب الاقتصادية الصينية، وتحفيز الطلب العام على المنتجات التي تواجه عقوبات من الصين. ويجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تمنح مزيداً من التراخيص للدول الصديقة لكي تخولها إنتاج سلع مهمة لصناعة الدفاع الأميركية.
في سياق متصل، أشار استطلاع أجراه “مجلس شيكاغو للشؤون العالمية” في سبتمبر 2023، إلى أن 74 في المئة من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع، وهو أعلى مستوى تقريباً سجل على الإطلاق، يعتقدون بأن التجارة مفيدة للاقتصاد الأميركي. في المقابل، يرى 80 في المئة منهم أنها مفيدة لمستوى معيشتهم، فيما يعتقد 63 في المئة بأنها مفيدة لخلق فرص العمل. وفي استطلاع “معهد ريغان” في يوليو 2023، اعتبر 58 في المئة من المشاركين أن التفاوض على صفقات تجارية مواتية يجب أن يشكل أولوية في السياسة الخارجية، وأيد 62 في المئة من المشاركين الجمهوريين التوقيع على اتفاق تجاري مع الدول الآسيوية حين قيل لهم إن الاتفاق يهدف إلى مواجهة القوة الاقتصادية الصينية.
لم تكن المشكلة في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه العولمة في الأعوام الـ20 الماضية تكمن في سماح واشنطن بتجارة مفرطة، بل في سماحها بتجارة تفتقر إلى المعاملة بالمثل، وهذا النوع من التجارة لم يخلق فرصاً متكافئة في المنافسة بين الشركات الأميركية ونظيراتها الأجنبية، بخاصة الصينية. لقد أدى العجز في الميزان التجاري مع الصين إلى خسارة الولايات المتحدة 3.7 مليون وظيفة في الفترة الممتدة من عام 2001، وهو العام الذي انضمت فيه الصين إلى منظمة التجارة العالمية، إلى عام 2018. وتكبد قطاع التصنيع 75 في المئة من هذه الوظائف المفقودة، أي ما يعادل 2.8 مليون وظيفة. وبعدما سمحت واشنطن لبكين بالاستفادة من مزايا التجارة الحرة من دون أن تطلب منها التزام القواعد، أثرت عواقب التجارة غير المتكافئة مع الصين في كل الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة، إذ إن بكين استمرت في تقديم إعانات صناعية وسرقت الملكية الفكرية وأجبرت الشركات على الدخول في مشاريع مشتركة وقيدت الوصول إلى أسواقها، وهي ممارسات لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
إضافة إلى فرض مزيد من القيود على الصين، يتعين على الولايات المتحدة أن تدخل في محادثات تجارية أكثر جدوى مع إندونيسيا والفيليبين وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة. ويذكر أن افتقار واشنطن الحالي إلى استراتيجية اقتصادية فاعلة يزيد من الاعتماد المفرط على الوسائل العسكرية. فالحلفاء لا يريدون حرباً مع الصين ولا يريدون شن حملة أخلاقية ضد الاستبداد. وهم يدعون إلى تطبيق استراتيجية اقتصادية تساعدهم في تقليل اعتمادهم على الصين والبقاء في حال ازدهار. إن السياسة التجارية الفاعلة والمبدعة لن تخلق “ساحة” أكبر فحسب (مجموعة أكبر من البلدان التي تلتزم قواعد ومعايير عادلة)، بل أيضاً سياجات أعلى، من خلال تشجيع مزيد من التعاون الطوعي ضد الصين وغيرها من الدول عندما تدخل في ممارسات غير عادلة.
الدرع المكسور
ليس هناك ما يوحد الأميركيين أكثر من الاعتقاد بأن الجيش الأميركي يجب أن يكون قوياً. أظهر استطلاع أجراه “معهد ريغان” أن 92 في المئة من الجمهوريين و81 في المئة من المستقلين و79 في المئة من الديمقراطيين يعتقدون بأن الحفاظ على قوة الجيش الأميركي أمر ضروري من أجل الحفاظ على السلام والازدهار في البلاد. ويعتقد أكثر من 70 في المئة من الأميركيين بأن على واشنطن أن تزيد إنفاقها على الدفاع.
ولكن هناك تفاوتاً متزايداً بين الالتزامات العسكرية التي تتعهد بها الولايات المتحدة من جهة والموارد [الأموال] المخصصة لدعم تلك المساعي العسكرية من جهة أخرى. ففي مارس (آذار) 2023، أعلن بايدن بفخر أنه طلب موازنة بقيمة 842 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية باعتباره أكبر طلب من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة في زمن السلم، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3.2 في المئة في الإنفاق الاسمي. ومع ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى أعلى من ذلك المسجل خلال الجزء الأكبر من عام 2023، شكل الطلب خفضاً فعلياً في الإنفاق الدفاعي للعام الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، أُنفق مبلغ 109 مليارات دولار، أي ما يعادل ثُمن موازنة الدفاع الأميركية [12.5 في المئة من موازنة الدفاع الأميركية] المعتمدة في 2022، على أمور لا تساعد في القتال والانتصار في الحروب، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة، على غرار بحوث سرطان الثدي.
وبالعودة إلى الوراء، كان إهمال الحكومة الأميركية للجيش مشكلة تسبب بها كلا الحزبين. ففي 2011، ساعد الجمهوريون في إقرار “قانون مراقبة الموازنة” Budget Control Act الذي أدى على مدى الأعوام الـ10 التالية إلى اقتطاع 600 مليار دولار من موازنة وزارة الدفاع. وفي حال دخل اتفاق الموازنة الذي فاوض عليه مكارثي مع بايدن في مايو (أيار) 2023 حيز التنفيذ في ربيع عام 2024، فإنه سيخفض القوة الشرائية الدفاعية بمقدار 100 مليار دولار أخرى. وما لم يحدث تغيير جوهري في نهج حكومة الولايات المتحدة الذي تعتمده في تمويل الدفاع، فإنها ستفشل في ردع خصومها، وقد تخسر حربها المقبلة.
11.jpg
حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس والمدير التنفيذي السابق في شركة التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي في ميامي، فلوريدا، نوفمبر 2023 (رويترز)
في 2015، كانت لدى البحرية الصينية 255 سفينة قادرة على المشاركة في العمليات القتالية. اليوم أصبح لديها 370. في المقابل، لا تملك البحرية الأميركية إلا 291، وتخطط إدارة بايدن لخفض هذا العدد إلى 280. إذاً، ربما يكون الافتقار إلى الاستعداد العسكري هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأمن القومي الأميركي في الوقت الحاضر. وفي الحرب ضد الصين، من الممكن أن تنفد الذخائر الأساسية لدى القوات الأميركية في غضون أسبوع.
من حسن الحظ أن الصين أو روسيا لم تتحدَّ حتى الآن الولايات المتحدة بصورة مباشرة على نحو يستدعي دخول واشنطن في صراع مباشر. لكنهما تقتربان من فعل ذلك. بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان من حسن الحظ أن المملكة المتحدة والاتحاد السوفياتي صمدا لوقت كافٍ حتى تتمكن الولايات المتحدة من زيادة التجنيد العسكري وتوسيع قاعدتها الصناعية الدفاعية استعداداً للانضمام إلى الحرب. وقد يفترض الأميركيون أن الولايات المتحدة تمتلك هامشاً مماثلاً الآن، ويشكل هذا الافتراض إغراءً خطراً جداً بالنسبة إلى خصومها.
ومع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأت النداءات المثيرة للعواطف في شأن الشجاعة الأوكرانية والتخريب الروسي تفقد تأثيرها. في الواقع، تراود الجمهوريين مخاوف مشروعة: هم يريدون خفض الإنفاق الفيدرالي، وضمان أن لا يختلس المسؤولون الأوكرانيون الفاسدون أموال المساعدات الأميركية، وفهم المرتبة التي ينبغي أن تحتلها مساعدة أوكرانيا في التسلسل الهرمي للمصالح الأميركية.
ليس هناك ما يوحد الأميركيين أكثر من الاعتقاد بأن على الجيش الأميركي أن يكون قوياً
لكن بايدن يقدم لكييف مساعدات تكفيها لمتابعة القتال فحسب، لا لتحقيق الفوز. ولكن هناك حجة قوية يمكن أن يقدمها المحافظون لمصلحة الدعم الأميركي المستمر، لا بل حتى المتزايد، لأوكرانيا. مقابل خمسة في المئة فقط من موازنة الدفاع الأميركية لعام 2023 ومن دون وقوع خسائر في صفوف الأميركيين، يخوض الأوكرانيون الحرب التي كان يخشى حلف شمال الأطلسي أن يضطر إلى خوضها. ويجب أن يعلم الناخبون أن 60 في المئة من المساعدات الأميركية لأوكرانيا تذهب إلى الشركات الأميركية التي تصنع الأسلحة المرسلة إلى كييف. إضافة إلى ذلك، كشف التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا عن أوجه قصور خطرة تغلغلت، بتسهيل من واشنطن، إلى القدرات الأميركية الدفاعية. في الحقيقة، تقوم أوكرانيا في بعض النواحي بدور ملهم وتحذيري يشبه ذلك الذي اضطلعت به المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، مما يسمح للولايات المتحدة بأن تحدد المجالات التي قد يكون فيها الجيش الأميركي غير مستعد بما يكفي لتنفيذ مهمات عسكرية ربما تطلب منه في المستقبل.
ولا شك في أن تخصيص تمويل كافٍ للدفاع سيتطلب إصلاحاً في برامج المستحقات والامتيازات. لا يرغب أي من الحزبين في المساس ببرامج المستحقات الحالية، تحديداً الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، على رغم أن كلفها أصبحت باهظة، فهي تشكل 63 في المئة من الإنفاق الفيدرالي بعدما كانت 19 في المئة عام 1970. ويشار إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه البرامج تحد من الإنفاق الاستنسابي في واشنطن، وبطريقة موازية فإن الفائدة التي يتعين على البلاد أن تدفعها على ديونها الوطنية الضخمة ستؤدي إلى تقييد وتقليص ما يمكنها إنفاقه على البرامج الدفاعية والمحلية. يبلغ الدين الفيدرالي الأميركي 33 تريليون دولار. ووفق وكالة “موديز أناليتكس” Moody’s Analytics [المعنية بتحليل المعلومات المتعلقة بالأخطار المالية والاقتصادية]، فإن مدفوعات الفائدة الفيدرالية على هذا الدين ستتجاوز مدفوعات الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2025 أو 2026.
واستطراداً، إن المرشحين الرئاسيين الجمهوريين الوحيدين اللذين يعترفان بضرورة إصلاح برامج المستحقات هما حاكمة ولاية كارولاينا الشمالية السابقة نيكي هايلي وحاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي. لكن اعترافهما بذلك يعدّ بداية ممتازة. سبق أن وضع المشرعون خططاً لطريقة خفض الإنفاق على المستحقات في التوصيات التي قدمتها “اللجنة الوطنية للمسؤولية والإصلاح المالي” المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 2010. ويحتاج كلا الحزبين إلى تغيير موقفهما إزاء إصلاح برامج المستحقات، لكن من المرجح أن يستمر الديمقراطيون في تجاهل المشكلة ما لم يجدد الجمهوريون التزامهم وتصميمهم على إنشاء أسس متينة ومستدامة لبرامج المستحقات في سبيل تحرير الأموال وتخصيصها للدفاع وغيره من الأولويات المحلية.
أخطاء في طريقة إدارة الحدود
وفقاً لمحللين في “مركز برينان” Brennan Center، وهو مركز بحوث غير ربحي متخصص في القانون والسياسة العامة، ثمة كثير من الأميركيين لا يفهمون سبب عدم قيام الجيش الأميركي بحماية حدود الولايات المتحدة. من الممكن انتهاج سياسة جمهورية أفضل في هذا المجال، في الواقع، ترتبط السياسة المتعلقة بالهجرة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الخارجية وسلامة الاقتصاد في الولايات المتحدة. ووجد استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في يناير (كانون الثاني) 2021 أن 68 في المئة من الأميركيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة لا تقوم بعمل جيد في إدارة حدودها. وهذا صحيح، فمنذ يناير 2020، حاول ما يقدر بنحو 200 ألف مهاجر العبور إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية كل شهر عبر الحدود المكسيكية، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى في الأعوام الـ20 الماضية. وخلافاً للتغطية الإعلامية التي يطغى عليها التهويل، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين هي من البالغين، ليس من القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
واستكمالاً، إن قانون “بوس كوميتاتوس” Posse Comitatus Act الصادر عام 1878 يحظر على الجيش الأميركي القيام بدور الشرطة المحلية. فالجنرالات المنهكون بالفعل لا يريدون تولي مهمة حماية حدود الولايات المتحدة، ويترددون في بدء عمليات قد تقلل مستوى الاحترام الذي يكنه الأميركيون للجيش. ولكن من أجل حشد مزيد من الدعم لتدخلات الولايات المتحدة في الخارج، يحتاج القادة السياسيون إلى إظهار قدرتهم على تعزيز الجهود والموارد المخصصة لأمن الحدود. في ذلك الإطار، وجد استطلاع مركز “بيو” في يناير 2023 أن غالبية الأميركيين يؤيدون منح وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أموالاً إضافية في سبيل تأمين الحدود الأميركية- المكسيكية.
ويتطلب تحقيق ذلك أكثر من مجرد موارد مالية وموظفين إضافيين. في الواقع، قدرت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن أكثر من 60 في المئة من المهاجرين الجدد ليسوا من المكسيك أو أميركا الوسطى، بل يبدأون رحلتهم من أماكن أبعد مثل كولومبيا وكوبا وبيرو وفنزويلا ثم يسافرون عبر المكسيك. لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعزز استثماراتها في المراقبة والتقنيات الأخرى التي تزيد من قدرتها على تتبع تحركات المهاجرين عبر أميركا الوسطى والقيام بعمليات اعتراض خارج الحدود الأميركية- المكسيكية، وفي محاكم جديدة معنية بالهجرة من أجل معالجة طلبات اللجوء بسرعة أكبر، وفي مزيد من التعاون مع المكسيك في سبيل منع المهاجرين من عبور أراضيها، وفي مزيد من التنسيق مع بلدان المهاجرين الأصلية من أجل المساعدة في حل المشكلات التي تعجل في حدوث هجرة جماعية وتسهيل عودة المهاجرين الذين لا يستوفون المعايير الأميركية الخاصة بالهجرة.
إن الفشل في تنظيم الهجرة على النحو المناسب يدفع الولايات المتحدة إلى إهمال فرصتها الجيوسياسية الكبرى الحالية المتمثلة في تعزيز التعاون في أميركا الشمالية. ويذكر أن الساسة الأميركيين لا يولون الاهتمام الكافي للجوانب السلبية المترتبة على غرق المكسيك في الجريمة، ولا يتصرفون بطريقة مبتكرة بما يكفي لجعل كندا والمكسيك والولايات المتحدة تستخدم إطار عمل مشتركاً للطاقة والعمالة والتصنيع. ومع وجود سياسة هجرة أكثر شفافية، يمكن نقل سلاسل التوريد إلى المكسيك بسهولة أكبر، مما يخفف من إمكان أن تستخدم الصين تلك السلاسل كأداة تخدم مصالحها الخاصة، ومن الممكن تعزيز شبكات الطاقة المتداعية في كاليفورنيا وتكساس من خلال زيادة واردات وصادرات الطاقة من كندا والمكسيك. إذا خلقت الولايات المتحدة فرصاً تسمح للدول المجاورة بتحقيق الازدهار، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الاقتصاد الأميركي بصورة مباشرة، فسيرى الأميركيون منافع تشكيل العالم على نحو يعزز الأمن والازدهار. وقد لا يكون الأميركيون على استعداد لدعم فرص التعاون التي يوفرها موقع بلادهم الجغرافي قبل أن يصبحوا متأكدين تماماً أن الولايات المتحدة تسيطر على حدودها.
مرحباً أيها العالم
إن العالم الذي أنشأته واشنطن وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية جعل الولايات المتحدة أكثر أماناً وثراء. لكن الأميركيين بحاجة إلى أن يتم تذكيرهم بأنه في حال لم تعمل الولايات المتحدة على فرض هذا النظام الدولي، فإن طرفاً آخر سيفعل ذلك. ومن المحتمل أن يكون هذا الطرف هو الصين. وفي الحقيقة، إذا تولت الصين زمام الأمور فإنها قد تخلق عالماً خطراً تستطيع فيه هي وحلفاؤها الاستبداديون مثل روسيا وإيران حشد القوة العسكرية والاقتصادية من أجل فرض رؤية قمعية [نظام قمعي] على العالم.
تتمثل الأهداف المهمة والكبيرة في الانضمام مجدداً إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ والتفاوض وضمان إقرار المعاهدات التجارية الأخرى وزيادة الإنفاق الدفاعي المترافق مع إصلاح برامج المستحقات وخفض الدين الوطني وتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومساعدة البلدان التي تناضل من أجل الحفاظ على حريتها. ويشير فريد كاغان، الباحث في “معهد أميركان إنتربرايز” إلى أن “لا أحد يريد أن يموت من أجل النظام الدولي”. فهو مفهوم غير واضح.
لكن إقناع الناخبين بسياسة خارجية أممية قد لا يكون بالصعوبة التي يتصورها بعض السياسيين إذا قدموا للشعب حججاً أكثر واقعية تتوافق مع المصلحة الوطنية الأميركية. في الوقت الحاضر، تطلق إدارة بايدن وعدد من القادة الجمهوريين نداءات معادية للمهاجرين [أهلانية] تخدم المصالح الذاتية، فينشرون مزاعم كاذبة بأن النزعة الأممية جعلت الولايات المتحدة أضعف أو أن الاهتمام بالمصلحة الوطنية الأميركية يعني تجاهل بقية العالم. وهذا لا يمت للحقيقة بِصلة، إذ إن الخيارات الدولية التي تتخذها الولايات المتحدة هي التي تحدد وضعها وظروفها الداخلية. في الوقت الحالي، يتخذ قادة الولايات المتحدة خيارات غير متسقة في السياسة الخارجية تجعل البلاد أقل أماناً وازدهاراً، وهي خيارات سيكون التراجع عنها في المستقبل موجعاً أكثر بعد.
وراء الاستقطاب الحزبي في الولايات المتحدة يكمن ارتباك عام وإحباط. لقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز “بيو” في الفترة الممتدة بين يونيو (حزيران) ويوليو 2023 أن 16 في المئة فقط من الأميركيين يثقون بالحكومة الفيدرالية، وهو أدنى مستوى مسجل منذ 70 عاماً في نتائج استطلاعات الرأي. في المقابل، لم يوافق إلا 10 في المئة فحسب على أن السياسة جعلتهم مفعمين بالأمل. في أغسطس، وفي استطلاع أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أشار 93 في المئة من الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية إلى أن الولايات المتحدة تسير في “الاتجاه الخاطئ”. وهذه نتائج محبطة، ولكنها تمثل في الوقت نفسه فرصة كبيرة، تفتح مجالاً لاعتماد سياسات جيدة وواضحة من أجل كسب مزيد من الزخم، لأن الأميركيين غير راضين على الإطلاق عن الوضع الذين يعيشونه حالياً.
لا يكمن الحل في تبني سياسات تتخلى عن التجارة، وتضعف المؤسسة العسكرية الأميركية، وتترك الحدود الأميركية- المكسيكية في حال من الفوضى، وتتوقف عن تقديم المساعدات للحلفاء الجديرين بالحصول عليها. في الواقع، ما زال الأميركيون راغبين بشدة في ضمان أن تقوم الولايات المتحدة بدور قيادي في العالم، سواء من أجل مصلحة البلاد أو من أجل سلامتهم الخاصة وازدهارهم الفردي. وعلى قادة الولايات المتحدة أن يظهروا أنهم يعرفون كيف يحققون ذلك.