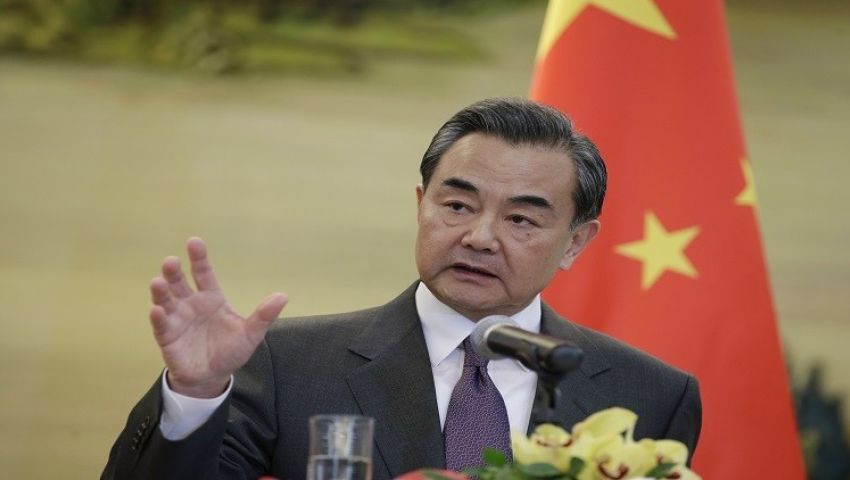قبل نحو عقدين، كنتُ قد ذهبتُ لتناول العشاء في مطعم يدعى “بكين” في حي الزمالك بالقاهرة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. وخلال ما أتذكره بطريقة غامضة كعشاء صاخب، طُلب من الحشد في المطعم أن يصمتوا لأن ضيفاً خاصاً وصل إلى المكان. كان القادم هو السفير الصيني في مصر، الذي أخذ المنصة، مع امرأة صينية شابه –مترجمته- التي حولت الماندرينية الصينية بلا عناء إلى لغة عربية فصحى لا تشوبها شائبة. وقد أخذ رفاقي في العشاء، وهم خليط من طلاب الدراسات العليا الأميركيين، والمصريين-الأميركيين، بمهارات المترجمة. فبعد كل شيء، هناك قلة من الأميركيين الذين يمكن أن يحققوا إنجازاً مماثلاً مع اللغة العربية. ثم واصلنا بعد ذلك احتفالنا بسنة الأرنب.
بالنظر إلى الوراء، رمزت العربية الجميلة للشابة الصينية إلى استثمار بكين طويل الأمد من أجل بناء دور أقليمي صيني في الشرق الأوسط. وقد فهم قادة الصين في ذلك الوقت أنهم سيريدون أن يكون لهم، عند نقطة ما، صوت أكبر في المنطقة. وقد بدت هذه الفكرة، وراءاً في أواخر التسعينيات، معقولة، وإنما بعيدة كثيراً وراء الأفق. وعندما كان ذكر الصين يأتي في محادثة، كان المسؤولون المصريون عادة ما يقولون: “ليست الصين بديلاً عن الولايات المتحدة”. ثم ينتظرون لحظتين طويلتين، ويضيفون مع ابتسامة متكلفة، “بَعد”.
هل وصلنا الآن إلى تلك اللحظة؟ يوم 10 تموز (يوليو)، افتتح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني-العربي بخطبة مطولة ومثيرة عن التعاون، والتشارك، وحلو على قاعدة “كاسب-كاسب” لبكين والعالم العربي معاً. وبعد بضعة أسابيع، طار الرئيس إلى أبو ظبي في زيارة دولة للإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني في نحو ثلاثة عقود، ووقّع مجموعة من الاتفاقيات التي معظمها اقتصادية. وجاء المؤتمر وزيارة شي في وقت شهد الكثير من الاهتمام بالشرق الأوسط وما وراءه في مبادرة شي، “الحزام والطريق” –وهي خطة غير متبلورة وعديمة الشكل لوضع الصين في مركز الحكم العالمي، وعلى الطريق عكس وجهة تدفق السلع والخدمات والأفكار التي جعلت الغرب متفوقاً على مدى القرون القليلة الماضية.
إذا كنتَ من أنصار الحتمية الاقتصادية، فإن الصينيين أصبحوا في الحقيقة لاعبين في الشرق الأوسط. ولكن، قم بتوسيع نطاق التحليل وسترى أن خطط الصين الكبرى لم تقطع شوطاً بعيداً فيما وراء اللغة العربية الجميلة.
لا شك في أن الحِرفية الاقتصادية للدولة الصينية حقيقة واقعة، وتنطوي على إمكانية أن تصبح أكثر أهمية باطراد بالنسبة للشرق الأوسط. وفي خطابه في تموز (يوليو) في بكين، أمام ما لا يقل عن 300 مشارك –بمن فيهم رئيس دولة واحد على الأقل وحفنة من وزراء الخارجية من الشرق الأوسط- تعهد شي بتقديم ما يعادل 20 مليار دولار من القروض للمنطقة، ونحو 90 مليون دولار إضافية في شكل مساعدات لسورية واليمن والأردن ولبنان من إجل إعادة الإعمار ورعاية اللاجئين، ومليار دولار أخرى للعالم العربي لتصب في اتجاه “الاستقرار المجتمعي”. وتأتي هذه الدفعات كإضافة إلى استثمارات رئيسية صينية في كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، من حيث تتم إعادة تصدير 60 في المائة من الصادرات الصينية إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. كما استهدفت الصين تركيا غير العربية مع المملكة العربية السعودية، كقطعتين رئيسيتين في مبادرة “الحزام والطريق”، واللتين ستوفران للصين وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، على التوالي.
واجهت الصين رد فعل عنيف في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشأن فكرة عن “استعمار جديد” ربما تمثله، وإنما ردة فعل أقل من ذلك في العالم العربي، وليس بالتأكيد من المسؤولين هناك. وفي بواكير وأواسط السنوات التي مضت من الألفية الجديدة، سوف تدمع أعين المسؤولين المصريين لدى التحدث عن الصين. ولم يكن هذا مفاجئا، فقد حل الحزب الشيوعي الصيني أحجية بدا أنها فاتت على الرفاق في الحزب الوطني الديمقراطي المصري –كيف يمكن توليد نمو اقتصادي بعيد الأمد من دون إقلاق التماسك الاجتماعي ومع الاحتفاظ بقوة الحزب. وفي وقت أقرب، لاحظ مسؤول كبير من دولة خليجية أن الاستقطاب السياسي لواشنطن جعلها غير جديرة بالاعتماد عليها، بل وحتى شريكا خطيرا في سعي العالم العربي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وأعلن المسؤول: “إنك إذا جلست حيث نجلس، فسوف تؤسس مستقبلك الاقتصادي على الشراكة مع الصين”.
يستطيع الصينيون أن يجلبوا الكثير من الموارد لحمل ما يسمونه تعاون “الربح للجانبين” في الشرق الأوسط. وسوف تعود الموانئ، والمطارات، واللوجستيات، و”المراكز” الجديدة، والمناطق التجارية التي خُطط لإقامتها أو التي تحت الإنشاء، بالفائدة على هذه البلدان (ما لم يتم إثقالها بديون كبيرة مثلما حدث مع عدد من الدول الزبونة لبكين في أفريقيا)، بينما ستجني الصين الفوائد من البنية التحتية الجديدة وموارد الطاقة الغزيرة للمنطقة، والتي ستسهل نموها المتواصل.
مع ذلك، فإن استنتاج أن استثمار الصين في الشرق الأوسط يعني أن بكين ستصبح لاعباً جيو-استراتيجيا في المنطقة -كما يقترح عدد كبير من التقارير والتحليلات- ربما يكون متقدما حتى على تقدير الصينيين أنفسهم. وهناك بطبيعة الحال سابقة تاريخية لهذا التقييم: جاء الاحتلال البريطاني إلى مصر -في جزء منه- لاستيفاء الديون المترتبة على الخديوي إسماعيل للمصارف الأوروبية.
مع ذلك، يبدو الصينيون أكثر اهتماماً بنزعة التجارة المربحة الانتهازية منهم بأن يصبحوا حلالاً للمشاكل ومزوداً للأمن الإقليمي. وتعرض نظرة متفحصة في خطاب شي في تموز (يوليو) أو إعلان السياسة الصينية للعام 2016 حول الشرق الأوسط نقاشا مفصلا للحِرفية الاقتصادية للدولة، لكنهما يقدمان الحد الأدنى مما يتصل بالسياسة والدبلوماسية أو الأمن في المنطقة. وبالتأمل في تصريحات هؤلاء المسؤولين، يتضح أن الغزوة الصينية في هذه المجالات كانت فاترة في أحسن الأحوال. فقد أعلنوا دعمهم لحل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ وقاوموا الجهود الأميركية لوقف صادرات النفط الإيراني، وهو أمر متوقع بالنظر إلى كمية الطاقة التي تستوردها بكين من طهران؛ وأعلنوا معارضتهم للتطرف والإرهاب. وهناك منطق معين في وجوب أن تتدخل الصين -بالنظر إلى حجم اعتماديتها على الهيدروكربونات من الشرق الأوسط- في شؤون الأمن والسياسة في المنطقة.
ولكن، مع كل ذلك، ما الذي فعله الصينيون حقاً؟ استضافوا وفوداً منخفضة المستوى نسبياً من الفلسطينيين والإسرائيليين في بكين في العام 2017، وكرروا دعمهم لحل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية –وهي نقطة انطلاق محكوم عليها بالفشل مسبقاً. وأنشأت بكين قاعدة بحرية في جيبوتي –في موقع استراتيجي عند باب المندب حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن- وزارت سفنها الحربية بعض موانئ الشرق الأوسط. وربما تستبق هذه الأنشطة دوراً أكثر نشاطاً في المستقبل. أما في الوقت الراهن، فليس من الواضح حتى ما إذا كان الصينيون يمتلكون ما يكفي من الموارد العسكرية لتأسيس وجود مستدام في المنطقة. ويبدو أن إجابة بكين على محاربة التطرف هي جمع الإيغور العرقيين المسلمين في معسكرات إعادة التأهيل، وهي قضية ظلت حكومات الشرق الأوسط صامتة بشأنها.
لا أحد في الشرق الأوسط يتوقع من الصينيين أن يكونوا مزوداً للأمن، فهذا ما تفعله الولايات المتحدة، والصينيون سعداء جداً بالاستفادة من الوضع القائم. وبينما أظهرت واشنطن شهية أقل للتورط عسكرياً في المنطقة، تطلعت دول الشرق الأوسط إلى موسكو أو أخذت على عاتقها مهمة تأمين مصالحها في سورية واليمن.
على النقيض من التعليقات اللاهثة والمنبهرة التي تتحدث عن الصين كقوة صاعدة في العالم العربي، فإن نهج بكين القائم على الحد الأدنى من الاستجابة لدراما الشرق الأوسط وصدماته لصالح القضايا الاقتصادية، هو ضرب من الدهاء حين يتعلق الأمر بطموحات الصين الأوسع إطاراً. وبعد يوم من إطلاق الولايات المتحدة 59 صاروخ كروز على سورية بينما كان الرئيسان، ترامب وشي، يستمتعان بتناول كعكة شوكولاتة في مار ألاغو، اتصلتُ بصديق في بكين لمعرفة شيء عن رد الفعل الصيني. وقد ضحك الصديق وقال لي أن أحداً في العاصمة الصينية لم يكن معجباً بشكل خاص بالعرض الأميركي لتكنولوجيا حقبة الثمانينيات. وأضاف: “وإلى جانب ذلك، فإن كل شيء يُبقي الولايات المتحدة غارقة في أزمات الشرق الأوسط هو جيد للصين. إنه يعني قدراً أقل من الموارد التي تستطيع واشنطن أن تخصصها لبحر الصين الجنوبي”. يبدو هذا منطقياً تماماً –وقد حان الوقت لأن تدرك بقية العالم ذلك.
ستيفن إيه. كوك
الغد