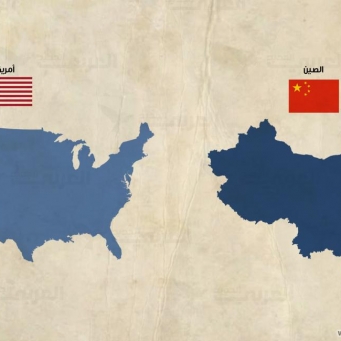
لم يفوّت الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في كلمته التي ألقاها في الثلاثين من الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، ضمن احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي في الصين، فرصة توجيه رسائل تحذير شديدة اللهجة إلى خصوم بلاده، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية. قال بينغ إن “زمن التنمّر على الصين ولّى إلى غير رجعة”، وإن “كل من يجرؤ على القيام بذلك سيُسحَق رأسه ويُخضب بالدماء على سور الفولاذ العظيم الذي صنعه ما يربو على 1.4 مليار صيني”. وشدّد على أن النهضة التي تشهدها بلاده، عسكرياً واقتصادياً، هي “مسيرة تاريخية لا رجعة فيها”. جاء ذلك موازياً لحملة أميركية مكثفة تسعى إلى شيطنة الصين وتقديمها أنها التحدّي الجيوسياسي الأبرز للولايات المتحدة.
معروف أن التوتر الأميركي – الصيني يعود إلى عام 1949، وذلك عقب سيطرة الشيوعيين على الحكم بزعامة ماو تسي تونغ. ولم تفلح محاولات الولايات المتحدة منذ عام 1972، تحت إدارة ريتشارد نيكسون، في كسب الصين إلى جانبها ضد الاتحاد السوفييتي، على الرغم من أنها اعترفت بجمهورية الصين الشعبية عام 1979، وأقرّت مبدأ “صين واحدة”، بمعنى أن تايوان جزء منها، من دون القبول بضمّها بالقوة. ومع ذلك، نجحت إدارة نيكسون في منع حدوث تحالفٍ بين بكين وموسكو، مستفيدة من توترات إيديولوجية بينهما. وشهد العقدان الماضيان تصاعداً أكبر في منحنى التوتر الأميركي – الصيني، وتضاعف أكثر خلال سنوات إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. إلا أن هذا التوتر اكتسب مزيداً من الزخم مع وصول جو بايدن إلى الرئاسة، وإعلان البيت الأبيض، رسمياً، عبر وثيقة “التوجيهات الاستراتيجية المؤقتة” في شهر مارس/ آذار الماضي، أن الصين تمثل “المنافس الوحيد المحتمل القادر على الجمع بين قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل تحدٍّ مستدام لتحقيق الاستقرار، ونظام دولي مفتوح”. بمعنى آخر، التحدّي الروسي يصبح هامشياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة إذا ما قورن بنظيره الصيني.
ثمَّة من يرى أن الولايات المتحدة والصين عالقتان اليوم في “حربٍ باردة”، لكن أساسها التنافس التجاري والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، لا الإيديولوجي. وحسب الخبراء أنفسهم، فإن الطبيعة المشحونة للعلاقات المشتركة ما هي إلا تعبيرٌ عن طبيعة التغييرات التي يشهدها ميزان القوى الدولي، بما قد يُؤذن بإرساء أسس نظام عالميٍّ جديد، لا تبقى فيه اليد العليا للولايات المتحدة، وهذا أكثر ما تخشاه هذه الأخيرة. عملياً، الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي، تليها الصين، كذلك فإن الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية عالمية، تليها روسيا فالصين. إلا أن بكين تقلّص الفارق الاقتصادي بشكل مطّرد مع واشنطن، وهي قد تتجاوزها خلال عقد واحد أو أقل، كذلك فإنها تبني ترسانةً عسكريةً ضخمةً قادرة على تحدّي الولايات المتحدة في المحيط الجيوستراتيجي الصيني، وقد تكون قادرةً على منافستها عالمياً خلال عقدين ونصف عقد.
اتهامات أميركية للصين بقرصنة تكنولوجيا شركاتها، المدنية والعسكرية، وعدم احترام الملكية الفكرية، فضلاً عن اتهاماتٍ بعدم احترام حقوق الإنسان
تتعدّد جبهات المنافسة بين العملاقين الدوليين، فهناك الميزان التجاري بينهما، الذي يميل بشدة إلى مصلحة الصين، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى شنِّ حرب تعريفاتٍ جمركيةٍ في محاولة لتعديل ذلك الاختلال، وقد حافظت إدارة بايدن على هذه التعريفات. أيضاً، هناك التنافس على بحرَي الصين الجنوبي والشرقي، اللذين ترى فيهما الصين، وتحديداً في البحر الجنوبي، منطقتين اقتصاديتين خالصتين لها وأنها تملك السيادة عليهما، وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة بشدّة، وتصرّ على أنهما وممرّاتهما المائية مناطق دولية خالصة، تخضع لقانون البحار الدولي. وبالتالي إن حرية الملاحة الدولية مضمونة فيهما. ومعلوم أن ثلثي التجارة العالمية يمرّ عبر ذَيْنكَ البحرين. ثمَّ هناك التنافس على النفوذ في شرق آسيا. وكذلك التنافس على الهيمنة الاقتصادية العالمية، ومحاولة الولايات المتحدة احتواء مبادرة الصين الاقتصادية الدولية المعروفة بـ”الحزام والطريق”. وهناك الاتهامات الأميركية للصين بقرصنة تكنولوجيا شركاتها، المدنية والعسكرية، وعدم احترام الملكية الفكرية، فضلاً عن اتهاماتٍ بعدم احترام حقوق الإنسان، إلخ.
ملخص ذلك أن الولايات المتحدة ترى أن الصين تهدّد “قواعد النظام الدولي الذي يضمن الاستقرار العالمي”، وأنها، حسب بايدن، تسعى إلى أن تصبح أغنى وأقوى دولة وفرض استبدادها القمعيِّ على العالم، وهو ما لن تسمح به واشنطن. في المقابل، وكما أشار بينغ في خطابه سابق الذكر، تشعر بكين بالإهانة جراء أكثر من قرنٍ من الاستخفاف الغربي والياباني بها، الذي وصل إلى حد غزوها واستعمار أجزاء منها في القرنين التاسع عشر والعشرين. وكانت بريطانيا قد شنّت حربين على الصين في القرن التاسع عشر، تعرفان بـ”حرب الأفيون”، ساندتها فرنسا في الثانية، وتمكّنت قواتهما من دخول بكين نفسها، وأبقت بريطانيا على احتلالها هونكغ كونغ من 1841 حتى 1997. واحتلت اليابان بعض جزر الصين، بينها تايوان، أواخر القرن التاسع عشر، وفي 1931 احتلت إقليم منشوريا، واستمر احتلالها لها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، التي كانت اليابان ضمن الدول التي خسرتها بعد التدخل الأميركي والسوفييتي إلى جانب قوات الحلفاء. ولا تُخفي الصين شعورها بالإهانة أيضاً من تعامل الولايات المتحدة معها، على مدى عقود، أنها ضعيفة اقتصادياً وعسكرياً، وهذا ما أجبرها في بعض الأحيان، في الماضي، على الاستجابة لضغوط أميركية، كالإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان أو قبول شروط واشنطن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
ثقة الصين بنفسها كبيرة، وتعتقد بقدرتها على تحدّي واشنطن. ولهذا، ترفض قواعد النظام الدولي القائم، وتراه محابياً للولايات المتحدة
لكن ثقة الصين بنفسها كبيرة اليوم، وهي تعتقد بقدرتها على تحدّي واشنطن. ولهذا، ترفض قواعد النظام الدولي القائم، الذي تراه محابياً للولايات المتحدة، و”يحظى بدعم عدد قليل من الدول”. وكان المسؤول الأعلى عن السياسة الخارجية الصينية، يانغ جيشي، قد عبّر عن هذا التصور خلال ردّه على اتهامات من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، في الاجتماعات الأميركية – الصينية في مدينة آنكريج في ولاية ألاسكا الأميركية في مارس/ آذار الماضي، بقوله: “الولايات المتحدة لا تملك المؤهلات لتقول إنها تريد التحدّث إلى الصين من موقع قوة”، متهماً واشنطن بالتعالي.
على أي حال، يتصاعد التوتر بين العملاقين، وثمَّة مخاوف من وقوع حربٍ مدمرة بينهما، سواء خطأً أو بشكل مقصود، قد تقود إلى حرب عالمية ثالثة. قد تكون جزيرة تايوان التي تصرّ الصين على أنها جزء منها وأنها ستستعيدها، ولو بالقوة، فتيل الصراع. ومعلومٌ أن الولايات المتحدة ملتزمة منذ عام 1979 “قانون العلاقات مع تايوان”، الذي يتيح لها “مساعدات وخدمات دفاعية بأي كمية ضرورية لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس على النحو الذي يحدّده الرئيس والكونغرس”.
السؤال المطروح راهناً: هل ستتمكّن الصين فعلاً من إطاحة الولايات المتحدة عن عرش الهيمنة الاقتصادية والعسكرية عالمياً؟
أسامه أبو أرشيد
العربي الجديد
