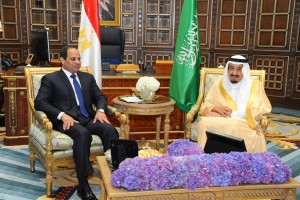
هناك ما يشبه الإجماع على أن العلاقات السعودية المصرية يسودها غموض من النوع الذي لا يخدم أياً من طرفيها. كل منهما يقول للآخر ما يود سماعه، ويفعل ما يرى أن يفعله. مصر يثير قلقها ظل «الإخوان». والسعودية أقل قلقاً من ذلك بكثير. يخيّم الغموض على قطبي العالم العربي على رغم المصالح المشتركة الكبيرة بينهما، وعلى رغم كل التصريحات الإيجابية التي تصدر من كليهما في كل مناسبة. لماذا هذا الغموض؟ هل السعودية هي السبب في ذلك؟ أم مصر؟
مصر هي السبب. هي من يريد للعلاقة مع السعودية أن تبقى غامضة، قابلة لأن تتسع للموقف ونقيضه. ومرد ذلك إلى دور افتقدته مصر وتحلم باستعادته، لكنها لا تجد إلى ذلك سبيلاً. تقول القاهرة إن أمنها من أمن الخليج، وهذا صحيح، لكنها تتبنى مواقف تتناقض مع هذه المصلحة. على الناحية الأخرى، أمن الجزيرة العربية والخليج هو من أمن مصر أيضاً. كان الأمر كذلك في الماضي ولا يزال، خصوصاً في هذه المرحلة المضطربة التي لم يعرفها العالم العربي من قبل. عندما وقفت السعودية مع مصر قبل انقلاب 2013 وبعده، إنما فعلت ذلك انطلاقاً من إدراك عميق لخطورة اضطراب الأمن في مصر بعد انهيار العراق وسورية. لا تحتمل السعودية أن تنزلق مصر إلى حال من عدم الاستقرار، ولو حصل مثل هذا التطور فإن حمل مواجهة انهيار المشرق العربي على هذا النحو ستقع مسؤوليته على السعودية بشكل رئيس، إن لم يكن عليها بمفردها، وهذه مسؤولية لا تستطيع تحملها دولة واحدة.
كل الكتابات المصرية تقريباً عن الموضوع أخيراً، تعيد أيضاً سبب غموض العلاقة مع السعودية إلى الموقف المصري، لكنها تفعل ذلك ليس من باب إقرار بصوابية الموقف السعودي وأحقيته أبداً، وإنما من باب العتب على القيادة المصرية لقبولها بتحجيم أو تقييد الدور المصري على هذا النحو. هنا تكمن معضلة العلاقة في الظروف الإقليمية الراهنة. النخبة المثقفة تريد أن تستعيد مصر دورها القيادي في الإقليم كما كان عليه في النصف الأول من القرن الماضي. يعبّر الموقف الرسمي المصري من الأزمات التي تعصف بالمنطقة عن الرؤية ذاتها، لكن غموض هذا الموقف وزئبقيته يعبّران أيضاً عن إحباط ناتج -كما يبدو- من إدراك متمكن بأن إمكان استعادة هذا الدور القيادي لم تعد متاحة كما كانت عليه من قبل، فمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقبله عهد محمد مرسي القصير، لم تعد مصر في العهد الملكي، ولا مصر في عهد عبدالناصر. والعالم العربي الآن يبتعد كثيراً من العالم العربي كما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين. أصبح من الواضح أن استعادة مصر دورها القيادي تتطلب تغييراً في مصر قبل أي مكان آخر يضعها في مقدم المنطقة كما كانت عليه من قبل. لا أحد يعترض على استعادة مصر دورها، لكن السياسة والأدوار القيادية فيها لا تتحقق بالأماني والتعلق بأحلام تعود لماضٍ بعيد. لم تعد مصر في مقدم المنطقة، لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا حتى في التنمية والعلم. عصر عمالقة مصر بالمعايير المصرية انتهى. باتت الدولة في مصر تعاني مما تعانيه دول عربية كثيرة، تعترف بأن التغير أصاب مجتمعها كما أصاب المنطقة والعالم، لكنها تنتظر من هذا التغير أن يتأقلم معها، لا أن تتأقلم هي معه ومع مقتضياته. والمدهش أنها في حال إنكار أن هذا الوضع يزيد من ابتعادها عن الدور الذي تنتظر استعادته.
المدهش أكثر أن مصر تدرك أنه بعد انهيار العراق وسورية لا يمكن إنقاذ المنطقة إلا بتعاون مع السعودية، وهو تعاون يتطلب رؤية مشتركة للحلول والمخارج من المآزق التي تحيط بها. لكن تخشى مصر، كما يبدو، وهي في وضعها السياسي والاقتصادي الصعب الآن، أن التوصل إلى رؤية مشتركة مع الرياض والذهاب في التعاون معها إلى أقصى مدى قد يصب في صالح اعتراف إقليمي بتبلور قيادة سعودية للمنطقة على حسابها، وبما يعزز حجم التغير الذي أصابها وأصاب المنطقة ومداه. هذا مجرد احتمال، وخشية مصر من الاحتمال تعبّر عن التغير الذي أصابها قبل غيرها. تريد مصر المساعدات المالية السعودية والخليجية، لكنها لا تريد أن يكون لهذا ثمن عليها أن تدفعه ضمن معادلة المصالح العربية المتبادلة، ليس للسعودية ولا لدول الخليج العربي، وإنما لمتطلبات هذه المصالح المشتركة. هل بقاء الأسد مثلاً، بعد كل الدمار الذي أطلق شرارته الأولى وكل الدماء والمآسي السورية التي تسبب بها ليبقى في السلطة، هو مصلحة سورية وعربية؟ تخشى مصر من أن يؤدي سقوط الأسد إلى استيلاء «الإخوان المسلمين» على الحكم في سورية، وإلى إضعاف دور الجيش السوري لمصلحة دولة مدنية، بما قد يضع الجيش المصري ودوره المركزي في مصر في حال من الحرج. في المقابل يغيب عن بال القيادة المصرية أن قيام دولة مدنية (مقابل عسكرية ودينية) وعلمانية تتسع للجميع سيضع أيضاً ضغوطاً على السعودية، وقد تفرض تداعيات ذلك عليها تأقلماً وإصلاحات لن يكون من السهل تفاديها. إذاً الثمن هنا لن تدفعه مصر لوحدها. والسؤال في هذه الحالة: لماذا تبدو السعودية، وهي الأكثر محافظة بإرثها الوهابي، مستعدة لمواجهة هذا الاحتمال وما قد ينطوي عليه سياسياً وفكرياً، من مصر التي يفترض أنه انطلق منها التنوير في العالم العربي قبل أكثر من قرن؟ هذا سؤال يختزل حجم التغير، وما انتهى إليه هذا التنوير.
سؤال آخر: هل من المصلحة العربية السماح أو التساهل مع السياسة الإيرانية في نشر فكرة الميليشيا على أساس طائفي كمنافس للدولة في العالم العربي بشعار مزيف اسمه «المقاومة»؟ هذا ما تفعله إيران في العراق، وفي سورية، وقبل ذلك في لبنان، وبعده في اليمن والبحرين؟ أليس في التصدي لهذا الدور الإيراني المدمر مصلحة عربية قبل أن يكون مصلحة سعودية؟ بعض الكتاب في مصر لا يرى الأمر من هذه الزاوية. الشاهد الأبرز على ذلك ما قاله الصحافي الشهير محمد حسنين هيكل لصحيفة «السفير» اللبنانية، بأن قتال «حزب الله» في سورية «هو من أجل بقائه ودفاعاً عن نفسه وعما يمثله في لبنان». مضيفاً أن في هذا «ما يؤكد مشروعيته في أنه يقاوم، وليس في أنه جزء من مشروع إيراني. إيران قد تستفيد من ذلك، وكذلك مصر، برغم أننا لا نعترف بذلك، فنحن نستفيد من كل بؤرة مقاومة معطِّلة لتسوية شاملة في لحظة ضعف العالم العربي وتهاويه بهذه الدرجة». لا أظن أنني أبالغ إذا قلت إن هذا كلام عفّى عليه الزمن. والغريب أن يصدر مثله من هيكل تحديداً. فالرجل من الذكاء وسعة الاطلاع بما يجعله ليس في حاجة إليه. ثم إنه هو قومي ناصري. والقومية ترتكز في أصلها وفصلها على فكرة الدولة، وطنية وقومية، وأولويتها على ما سواها. هل يقبل هيكل بأن تنشأ ميليشيا مماثلة في مصر؟ والأكثر غرابة هو قوله إن قتال «حزب الله» في لبنان يؤكد مشروعيته، وإنه ليس جزءاً من مشروع إيراني. في هذا يغالط هيكل نفسه. فالحزب ديني، بقيادة وكوادر دينية، وبمرجعية دينية وسياسية في إيران، وليس حتى في لبنان أو سورية، ويتم تمويله وتدريب وتسليح كوادره من قبل «الحرس الثوري» الإيراني. ترى هل أن إيران تفعل كل ذلك كجمعية خيرية لصالح المقاومة العربية؟ الحقيقة أن الحزب يدافع عن نظام دموي يقتل شعبه قبل قيام الثورة بعقود. والحزب إنما يفعل ذلك لأن رئيس النظام شيعي علوي، وبقاؤه مطلوب كحاجز أمام وصول الأغلبية السنية للحكم في سورية. لأن وصول هذه الأغلبية سيخرج إيران من سورية. وهيكل من أوائل من قالوا بذلك. كيف يصبح قتال الحزب في سورية على هذا النحو تعبيراً عن استقلاله ومشروعيته؟
موقف هيكل لا يمثل بالضرورة رؤية الحكم في مصر. لكن غموض موقف هذا الحكم من مثل هذه المسائل الحيوية يعطي الانطباع بأنه يتكامل على نحو ما، من دون أن يتطابق، مع ما يقوله البعض من النخبة المثقفة. وهذا يؤكد أولاً بأن تضارب الرؤية السياسية مع مصالح معترف بها ينتهي إلى تزاوج مصالح مشتركة مع الآخرين، وسياسات رمادية لا تخدم أحداً. ويؤكد ثانياً عدم قدرة الدول العربية على عقد تحالف بينها يستند إلى رؤية استراتيجية مشتركة. ومن هذه الثغرة تأتي تدخلات خارجية تعبث بمقدرات المنطقة. تطلب منا مصر أن ننتظر إعادة تأسيس ريادتها. هل تستطيع ذلك وهي لم تخرج من عباءة العسكر لأكثر من قرن من الزمن؟
خالد الدخيل
صحيفة الحياة اللندنية
