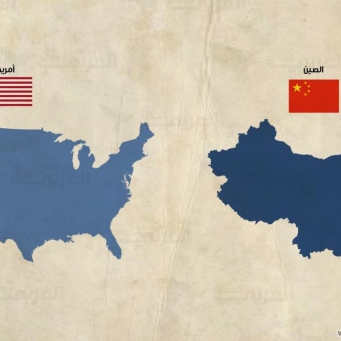
ناقش مقال الأسبوع الماضي للكاتب، بإيجاز، خلفيات التوتر الأميركي – الصيني، وتنافسهما على الريادة العالمية، ومساعي الصين لوراثة هيمنة الولايات المتحدة دولياً، خصوصاً في الجانب الاقتصادي خلال عقد واحد، وربما مزاحمتها عسكرياً في العقدين والنصف المقبلين. وفي هذا المقال، سيحاول الكاتب، بإيجاز أيضاً، أن يجيب عن سؤال ما إذا كانت الصين قادرة على تحقيق الهيمنة الاقتصادية عالمياً، على أن يعود إلى سياق المنافسة على الهيمنة العسكرية في المستقبل القريب وآفاقها.
بداية، فَلْنُذَكِّر بما أورده مقال الأسبوع الماضي أن واشنطن، وحسب وثيقة “التوجيهات الاستراتيجية المؤقتة” الصادرة عن البيت الأبيض، في شهر مارس / آذار الماضي، ترى أن الصين تمثل “المنافس الوحيد المحتمل القادر على الجمع بين قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل تحدٍ مستدام لتحقيق الاستقرار، ونظام دولي مفتوح”. هذا ليس موقف إدارة جو بايدن وحدها، بمعنى أنه لا يخضع لاعتباراتٍ سياسيةٍ وحزبيةٍ وانتخابية، بقدر ما أنه يمثل موقف المؤسسة الأميركية بمكوناتها كافة، السياسية والحزبية والأمنية والاستخباراتية والعسكرية والفكرية والإعلامية. وثمَّة شبه توافق أميركي أن الصين التي تتضاعف قوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية بسرعة كبيرة تشكل تهديداً جيوسياسياً لمكانة الولايات المتحدة قوة عظمى عالمياً. من هذا المنطلق، تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، في أبريل/ نيسان الماضي، بمشروع قانون تحت عنوان “قانون المنافسة الاستراتيجية لعام 2021″، حظي مباشرة بدعم المُشَرِّعين من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، ويهدف عملياً إلى احتواء الصين.
أجندة الإصلاح الاقتصادي في الصين تتباطأ جرّاء الحروب التجارية مع واشنطن والتعريفات الجمركية والقيود التي تحدّ من قدرة بكين على الحصول على مواد أولية
في المقابل، لا تتردّد بكين، راهناً، في مساعيها إلى تعميق هواجس واشنطن، متخلية في ذلك عن عقود من محاولاتها التهوين من شأن قدرتها على منافسة الولايات المتحدة. وكان مقال الأسبوع الماضي قد ذكّر بتحذيرات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في كلمته التي ألقاها في الثلاثين من الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، ضمن احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي في الصين، من أن “زمن التّنمر على الصين ولى إلى غير رجعة”، وبأن من سيحاول ذلك ستبوء جهوده بالفشل، ذلك أن المنحى التصاعدي للصين نحو العظمة “لا يمكن إيقافه”. ولا تخفي بكين قناعتها الراسخة من أن “الشرق ينهض والغرب يتراجع”، ومن ثمَّ، فإنها ليست في وارد الانكفاء أمام الضغوط، أو الرضوخ لأي محاولات ابتزازٍ وترهيب، حتى ولو كانت صادرة عن الولايات المتحدة نفسها.
لكن، وعودة إلى السؤال الذي افتتح به هذا المقال، هل تملك الصين القدرة اليوم، أو في المدى المنظور، على إطاحة الهيمنة الاقتصادية الأميركية فعلاً؟ هذا سؤال صعب، ولا يمكن أبداً تقديم إجابة حاسمة فيه، فالأمر لا يخضع لمعادلة أبيض أسود، بل ثمّة معطيات ومتغيرات وسيناريوهات عدة متداخلة ومتباينة، ستلعب دوراً كبيراً في تحديد الإجابة النهائية.
معروفٌ أن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر عالمياً، بحجم يتجاوز اثنين وعشرين ونصف تريليون دولار سنوياً، يليه الصيني، بحجم يتجاوز الستة عشر ونصف تريليون دولار سنوياً. معيار القياس المعتمد هنا هو الناتج القومي الإجمالي. أما إذا أخذنا بمعيار “تعادل القدرة الشرائية” مقياساً، والذي يعتمد القوة الشرائية وكلفة المعيشة داخل كل بلد، بعد تحديد سعر الصرف بين العملات محل الاهتمام، فإن الصين هي الاقتصاد الأكبر عالمياً. على أي حال، وبعيداً عن التعقيدات الاقتصادية والمالية هنا، فإن المعيار الأكثر اعتماداً في حساب اقتصاديات الدول هو الناتج القومي الإجمالي الذي يعطي للولايات المتحدة أفضليةً أكبر بكثير اليوم من الصين. المشكلة، أميركياً، أن كثيراً من نماذج التنبؤ الاقتصادي المستقبلية تقول إن الصين سوف تصبح الاقتصاد الأكبر عالمياً عام 2031.
حشدت إدارة بايدن وراءها الاتحاد الأوروبي واقتصادات السبع الكبرى، في محاولة لاحتواء الصين اقتصادياً
ومع ذلك، ليس الأمر بهذه البساطة، ولا يعني أبداً أن المنافسة الاقتصادية قد حُسمت لصالح الصين، إذ ثمَّة متغيرات ومعطيات قد تقلب نماذج التنبؤ المستقبلية رأساً على عقب. من ذلك، مثلاً، أن أجندة الإصلاح الاقتصادي في الصين تتباطأ جرّاء الحروب التجارية مع الولايات المتحدة والتعريفات الجمركية والقيود والعوامل الأخرى التي تحدّ من قدرة بكين على الحصول على بعض المواد الأولية اللازمة لصناعاتها، أو التكنولوجيا المتقدّمة في بعض المجالات الحساسة، أو حتى الوصول إلى الأسواق العالمية، كبعض دول أوروبا والهند. وعلى الرغم من أن الصين هي أسرع الدول تعافياً من جائحة كورونا، إلا أن خطط التحفيز التي اتبعتها رفعت ديونها إلى مستوياتٍ قياسية. ثمَّ هناك احتمال أن الصين تبالغ في تضخيم بيانات ناتجها القومي الإجمالي، لتقليص حجم الفارق مع الولايات المتحدة. وبالتالي، قد تكون الفجوة الاقتصادية بين البلدين أوسع مما تقوله. مثيرو هذه الشكوك يحيلون إلى مصداقية الصين التي يرونها مضروبة، وإلى غياب الشفافية عندها.
أيضاً، يشير الخبراء إلى أن الصين تواجه مستقبلاً غير مؤكّد في منافستها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك إذا ما أخذنا بالعوامل الثلاثة التي تحدّد معدلات النمو الاقتصادي: حجم القوة العاملة، مخزون رأس المال، والذي يشمل البنى التحتية وشبكات الاتصال والمواصلات والمصانع، وأخيراً الكفاءة الإنتاجية. معروفٌ أن عقوداً من سياسة “طفل واحد” في الصين أسّست لمجتمع هرم، وهو ما حذا ببكين إلى التخلي عنها في السنوات الأخيرة، ولكن ذلك يصطدم بتغيراتٍ ثقافية جديدة بين الأجيال الشابة تساهم في عرقلة مساعي الدولة. وعلى الرغم من أن الصين هي الدولة الأكثر توسّعاً في بناها التحتية ومصانعها وتكنولوجيا اتصالاتها وشبكات مواصلاتها، إلا أن سنوات من الاستثمارات الواسعة والسريعة تسبّبت في مدن مهجورة، ومبان خالية، واختلالات عميقة بين المناطق الحضرية والريفية. أما التحدّي الأكبر الذي تواجهه الصين في سياق خططها الاقتصادية فيتمثل في أن مستوى كفاءتها الإنتاجية، القائمة على المزج بين العمالة ورأس المال، ببلغ 50% فقط من نظيرتها الأميركية. بل تقول التوقعات المستقبلية إن كفاءة الصين الإنتاجية ستصل إلى نسبة 70% فقط، مقارنة بالأميركية عام 2050.
لا تتردّد بكين في مساعيها إلى تعميق هواجس واشنطن، متخلية عن عقود من محاولاتها التهوين من شأن قدرتها على منافسة الولايات المتحدة
الأكثر أهمية من كل ما سبق ضرورة الأخذ في عين الاعتبار أن الولايات المتحدة لن تقف جامدة أمام التحدّي الاقتصادي الصيني. من ناحية، التعافي الاقتصادي الأميركي جراء حزم التحفيز لمعالجة آثار جائحة كورنا يسير بوتيرة متسارعة جداً، مع ضرورة ملاحظة أن حزم التحفيز تلك أثقلته بديون ضخمة. ومن ناحية أخرى، حشدت إدارة بايدن وراءها الاتحاد الأوروبي واقتصادات السبع الكبرى، في محاولة لاحتواء الصين اقتصادياً، وهي أطلقت بالشراكة معهم، في الشهر الماضي (يونيو/ حزيران) مبادرة اقتصادية كبرى، تسعى إلى تطويق مبادرة الصين العالمية “الحزام والطريق”، والتي تبلغ كلفتها مئات المليارات من الدولارات. إلا أن التحدّي سيكون في قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ ذلك عملياً. أضف إلى ذلك، أن بايدن يحاول اليوم إطلاق مشروع ضخم لتحديث البنية التحتية الأميركية، وهو ما سيوسّع القوة العاملة في بلاده. إلا أن ذلك غير مضمون أيضاً، فهذا الأمر محل خلافات ومماحكات حزبية ديمقراطية – جمهورية.
باختصار، مستقبل المنافسة الاقتصادية بين الدولتين لا يمكن التنبؤ اليقيني فيه، إذ إنها عملية تخضع لمتغيرات وتحديات موضوعية وذاتية. وحتى إن تمكّنت الصين من حسم التنافس الاقتصادي مع الولايات المتحدة لصالحها بعد عقد، فإن المنافسة على القوة العالمية الأولى عسكرياً مسألة أخرى أكثر تعقيداً.
أسامة أبو أرشيد
العربي الجديد
