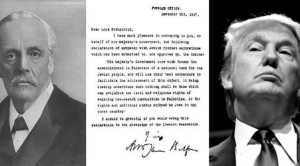“عاشت أميركا… تسقط أميركا”، هذا هو الحال الذي يعتمل داخل نفوس العرب، فمن ترامب الذي “نحبّه” عندما يداعب مشاعرنا في إعلان عدائه إيران، إلى ترامب ذاته الذي نكرهه،
ونحن نتلقى الصفعات واحدة تلو الأخرى منه، في مجال حقوق الفلسطينيين. والمنصف في الأمر الاعتراف أنه ليس هو من تلاعب بمشاعرنا، وربما لم يسع إليها، أو أنها ليست على جدول أعماله أساساً، منذ بدأت مسيرة شهرته، حين لم يكن على قائمة التنافس الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، ومروراً بتحولاته السياسية، المتنوعة، وبرنامج دعايته الانتخابية الذي لم يلامس فيه أي حلم عربي كان، أو “إسلامي”، وانتهاء بوعده “المشؤوم” في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، بخصوص نقل السفارة الأميركية إلى القدس. هذا الوعد الذي أطلقه في حين لا تزال مكرمات بلاد الخليج عالقةً على جنبات ثيابه وأهل بيته الذين شاركوا وباركوا مقتل نحو ستين فلسطينياً، على وقع خطوات ابنته “الفاتنة” إيفانكا التي أزاحت الستارة عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في القدس المحتلة في 14 مايو/أيار الجاري، لتكون أول دولة تعترف بالديانة جامعا لشعب تقوم على أساسه دولة دينية يهودية، توازي، إن لم تتفوق على، الدولة الإسلامية إيران، المماثلة لها في قوامها وجامعتها (الدين) وسلوكها نحو العرب، والتي تدّعي أميركا خصومتها والسعي إلى تحجيم دورها، بدعوى إخلالها بالسلم والاستقرار الدوليين، وتخليص العالم من شرورها القادمة عبر سلاحها النووي.
وفي الحالين، الولايات المتحدة الأميركية التي نستنجد بها لتخلصنا من جرائم إيران واحتلالها مذهبيا وعسكرياسورية والعراق، هي نفسها التي تساند الاحتلال الإسرائيلي، وتبرّر جرائمه في فلسطين، وتصون مصالحه في مجلس الأمن، وتعزّز قوته العسكرية والاقتصادية على حساب انتزاع القدرات العربية، وتدميرها منهجياً لمصلحة التفوق الإسرائيلي، ما يجعل السؤال مبرّراً عن إمكانية أن يكون لإدارة ترامب اليوم أي دور في إرساء الأمن والسلام الدوليين في منطقتنا العربية، في ظل انحيازه التام لإسرائيل، وتبنّيه فرضية وجودها الأسطورية الخارجة عن منطق بناء الدول في العصر الحديث.
أقصد أن الحديث عن “خيانة” للإدارة الأميركية، أو عن تراجع لها، هو فقط لتبرير الأخطاء الجسيمة التي انطوت عليها مراهنة بعضهم على الولايات المتحدة الأميركية التي لم تدّع يوما أنها تحابي مصالح العرب وحقوقهم، بل أكدت على الدوام أنها لا تهتم إلا بمصالحها الخاصة، وضمن ذلك مصالح إسرائيل في المنطقة، أي أن الذين راهنوا عليها، وبنوا سياساتهم على أساس توهماتهم عنها، هم الذين يتحملون المسؤولية، في هذا الخصوص.
قد يحيل بعضهم توهماته إلى تصريحات الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وأركان
إدارته، لكن تلك الإدارة التي تتحمل جزءا كبيرا عن مآلات الصراع السوري، والمآسي الناجمة عنه، أرسلت إشارات عديدة واضحة تفيد بأنها غير معنية بإنهاء الصراع السوري، أو بترحيل نظام الأسد، وحصل ذلك مرارا في سكوت وزير خارجيتها، جون كيري، عن تفسيرات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لبيان جنيف، ثم عن عبثه بمسار مفاوضات جنيف، أي أن الولايات المتحدة هي التي سهلت وغطت الدور الروسي، السياسي والعسكري، كما سهلت سابقاً استيلاء إيران على العراق سياسياً واقتصادياً، وما كان لإيران التي تحمل شعار “الموت لأميركا” أن تصل إلى الحدود السورية مع الكيان الإسرائيلي إلا بقرار صامت أميركي، يوظف من جديد الوجود الإيراني لمصلحة خلط الأوراق، وانتزاع الأولويات العربية من المواجهة مع إسرائيل إلى المواجهة مع إيران.
تبيّن كل الدلائل بوضوح أن الولايات المتحدة لم تكن تريد إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر أوسلو، وإنما تغيير مسار الصراع وتحجيم أهداف الفلسطينيين ومحاصرتها ضمن حدود قصر حكم السلطة الفلسطينية (“المقاطعة” في رام الله)، كما الحال بالنسبة للصراع في سورية، فحيث كان يمكن للإدارة الأميركية، والتي بدأت تدخلاتها بالثورة السورية مع الأسابيع الأولى لانطلاقتها 2011، من خلال التصريحات وحراك السفارة الأميركية في دمشق، أن تنهي الصراع، وتلزم النظام بالخضوع إلى تسويةٍ سياسيةٍ عادلةٍ وعاجلة، إلا أنها اختارت الطريق الأطول والأصعب على السوريين، لاستنفاذ قواهم بصفتهم طرفين متصارعين، ولتوسيع عدد الأطراف، بما يضمن تحقيق “الفوضى الخلاقة” التي لاتزال تتشكل في المنطقة كاملة، في وقت تحتفي هي بالقدس، أحد أخطر ملفات الصراع العربي الاسرائيلي، عاصمة للدولة اليهودية.