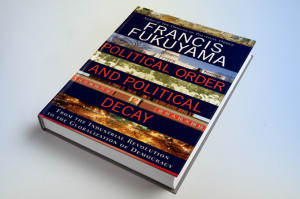
تتجلَّى أهمية الكتاب في عرضه لحالة الديمقراطية والنظام السياسي عبر العالم، بدءًا بالولايات المتحدة الأميركية ووصولًا إلى العالم العربي مرورًا بالدول الآسيوية، والأوروبية، والإفريقية، كما يشرح فوكوياما أسباب التآكل السياسي وتراجع الديمقراطية ويقدم الوصفة المناسبة لمرافقة تحدي العولمة والخصائص الرئيسية للدولة القوية والحديثة المبنية على الحوكمة الفعالة. علاوة على ذلك، يمكن إدراج رؤية الكاتب عن العالم العربي في إطار أفكار وآراء مجموعة أميركية ذات نفوذ عال؛ حيث ينتمي فوكوياما إلى المستشرقين الجدد الذين يفسِّرون الظواهر العربية بشكل مختلف عن مفكري الوطن العربي، كما يُعتبر مستشارًا للتيار اليميني بالولايات المتحدة الأميركية وأحد مناصري البرامج السياسية للحزب الجمهوري والمحافظين الجدد، فقد وقَّع بجانب شخصيات كديك تشيني ودونالد رمسفيلد على مشروع القرن الأميركي الجديد سنة 1997، على الرغم من إعلانه عدم انتخاب جورج بوش الابن أمام جون كيري ومساندته لباراك أوباما أمام جون ماكين.
يتناول الكتاب قضايا رئيسية يمكن تلخيصها في عدة محاور، بدأت بتقديم قراءة شاملة عن واقع الديمقراطية بمختلف أنحاء المعمورة، مركِّزًا على العديد من البؤر الساخنة، أهمها: التحولات الديمقراطية بالعالم العربي، والانتقال السياسي بالدول الإفريقية، والنماذج الديمقراطية الرائدة في أوروبا. وقد عالج الكاتب هذا المحور عبر توصيف للحالة الديمقراطية بكل منطقة مستعرضًا المتغيرات الحالية مع الغوص في تجارب ملموسة كحالة التغيير الديمقراطي بكل من مصر وتونس واستخلاص للعديد من الدروس أو الممارسات الجيدة حسب تعبير الكاتب عن نماذج أوروبية. أما المحور الثاني فيتعلق بدراسة الكاتب للممارسة الديمقراطية بالولايات المتحدة الأميركية؛ حيث ينتقد المبادئ التي وضعها الآباء المؤسسون معتبرًا إيَّاها متجاوزة كما يلوم النخب الأميركية، متمثلة في الأحزاب السياسية ومجموعات الضغط، على تجريف الممارسات السياسية وإفراغها من محتواها الديمقراطي. وبذلك، يدفعنا لمراجعة ما كان سائدًا عن النموذج الأميركي كمعيار للديمقراطية باعتباره جامعًا للديمقراطية التمثيلية، والتشاركية، والمباشرة. بالإضافة إلى محور أخير يناقش فيه الكتاب المنظومة الديمقراطية مع مفهوم الدولة من حيث هويتها، وغايتها، وإسهاماتها في بناء حضارة الأمة.
وعلى هذا الأساس، فخلال تناول الكتاب لواقع الديمقراطية بالعالم، عرَّج فوكوياما على المنطقة العربية عبر فصل بعنوان «من 1848 إلى ربيع العرب»، مفسِّرًا ما حدث من ثورات شعبية على أنه نتاج تحسن في مستويات التعليم وانفتاح اقتصادي أفرز طبقة وسطى واعية ومتعطشة لقيم الحرية ومبادئ الديمقراطية؛ مما يقف حجرة عثرة أمام استمرار الأنظمة الاستبدادية والديكتاتوريات العسكرية. ويذكر الكاتب أنه «مثل مظاهرات أوكرانيا قبلها، كانت مظاهرات تونس ومصر تريد حكومات حرة، وحكَّامًا يمثلون الشعب…». كما أشاد بأنه في منطقة سئم الناس من حالة الجمود السياسي فيها، كان ربيع العرب أحسن من «ربيع اليابان»، عندما تحققت الحرية والديمقراطية بالقوة من خلال انهزام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وفرض الأميركيين الديمقراطية عليها، بعد قرون من حكم الأباطرة. لكن سرعان ما انقلب على رؤيته الوردية للثورات العربية حين تأسَّف على نتائجها التي جلبت أنظمة غير محبَّذة لدى الغرب، بل يزيد أن الأنظمة السابقة كانت أفضل بكثير للولايات المتحدة من مخرجات الثورة مختتمًا هذا الفصل بتشبيه الوضع العربي بربيع أوروبا الذي كان طويلًا، معقَّدًا وفوضويًّا أحيانًا ومشدِّدًا على أنه «لابد من وقت طويل حتى يعرف الناس أهمية الانتخابات الحرة، وأهمية احترام رأي الأغلبية، وأهمية حماية الأقليات.. إسقاط الحكام الديكتاتوريين كان سهلًا، لكن، أهم من ذلك، زرع ورعاية بيئة ثقافية تحترم الحرية».
ومما يجب التوقف عنده، أن فوكوياما ربط الانتفاضات الشعبية بالعالم العربي باتساع الطبقة الوسطى فقط وهذا إغفال كبير لمجموعة من الأحداث انطلاقًا من الأعطاب السياسية المتجلِّية في انتشار ظاهرة القائد الواحد المتفرِّد بالسلطة وحزب النظام المتوغِّل في أجهزة الدولة مع اندثار للعقد الاجتماعي الرابط بين الحاكم والمحكومين لتنظيم الشأن العام، ثم غياب المشروعية السياسية عبر هيمنة الهاجس الأمني على الفعالية الاقتصادية والمشروع التنموي؛ مما أدى إلى هدم ركيزة الحق والقانون وكذلك الإقصاء الواسع لباقي الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، علاوة على إشكالية التوزيع المجحِف للثروات وتضييع مقدرات الدولة الطبيعية والحقوقية والمعرفية في غياهب الفقر والجهل والمرض، فأصبحنا أمام جبال من الأموال جناها رجال أعمال فاسدون مقربون من السلطة وحقول من الحاجة تؤدي ثمنها أسر معوزة، وشباب يعاني من البطالة وضعف للأجور والرعاية الصحية؛ مما نجم عنه تجسير للهوة في التركيبة المجالية بين المجال الحضري والأرياف، ثم في التوزيع الترابي بين المركز والجهة وكذلك في الهيكل المجتمعي بين الرجل والمرأة وبين الأغنياء والفقراء.
على صعيد آخر، نوَّه الكاتب بالتجربة الانتقالية في تونس وبالتوافق السياسي بين ما أسماه: الأحزاب الإسلامية المعتدلة والجماعات السياسية العلمانية على صياغة دستور ديمقراطي مبني على سيادة القانون، كما أكَّد فوكوياما أن الإسلام ليس عدوًّا للديمقراطية، وأن الأحزاب الإسلامية كانت خير مثال للقوى المطالبة بالمشاركة السياسية. بينما أبدى تخوفاته من مستقبل القارة الإفريقية في ظل انعدام الاستقرار واستفحال الديكتاتورية والنزعات الطائفية داخل العديد من الدول، موضِّحًا أن التناوب الديمقراطي المستقر للأحزاب السياسية على السلطة شيء راسخ في بعض الدول الإفريقية مثل غانا، على العكس من بلدان أخرى، مثل: ليبيريا، وسيراليون، وجمهورية إفريقيا الوسطى التي تواجه عقبات هائلة تهدد وحدتها ونسيجها المجتمعي. ويشير الكاتب إلى أنه في حالة هذه الدول يجب توطيد مفهوم النظام الذي يمتلك السلطة وناصية القرار حتى لو كان مستبدًّا، مستندًا في ذلك إلى أن جشع المستعمرين، وطبيعة المناخ والجغرافيا، والإثنيَّات المتناحرة تعرقل المسار الديمقراطي وتدمِّر بنية الدولة.
ومما يُلاحَظ في هذا الشأن، أن الكاتب يُثنِي على وجود أنظمة حتى لو كانت متسلطة لأنها -حسب رأيه- هي صمام أمان للدولة، وهذا تبرير مجاف للحقيقة يطمس ماهية الدولة التي عرَّفها جون جاك روسو على أنها المجال الذي يحقق فيه الإنسان بُعده الكوني بوجود حقوق الإنسان، ويتناسى ركائز الدولة من ضرورة إقامة نظام ديمقراطي ينظِّم السُّلطة، والتداول السلمي على الحكم، وضمان التعددية الحزبية والمشاركة السياسية، زيادة على أن تحصين الدولة بنظام ديمقراطي متكامل الأركان يحميها من انحرافات وسلوكيات استبدادية، ويُخرجها من دائرة الروابط المجتمعية التي لا تقبل الآخر كالوصاية والتبعية.
وفي سياق متصل، نرى أنَّ الكاتب الذي عبَّر في كتاباته السابقة عن أن الديمقراطية هي مآل العالم ومصير التاريخ، يتراجع في تحليل الوضع في العالم الثالث، متجاهلًا أن الدولة الديمقراطية هي اللَّبنة الأساسية في تكريس المواطنة بالمجتمع من خلال تجسيد الحقوق العامة والحريات الفردية، وأهمها: الحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير، التي ترمي إلى عدم اختزال الوطن في حزب أو قبيلة أو طائفة وأنه لا وجود لأقلية في المجتمع، بل مواطنين متساوين ومساهمين في صنع القرار الوطني.
على جانب آخر، يتطرق الكاتب لقضية الديمقراطية بالولايات المتحدة الأميركية مشخِّصًا الواقع الحالي بأزمة تمثيل، تظهر انعكاساتها في اضمحلال الطبقة الوسطى، والفروق الاجتماعية المطَّردة في الدَّخْل، وتطرف ذوي المصالح الخاصة من أحزاب سياسية وجماعات ضغط. ويقدم الكاتب انتقادات لاذعة للنخبة الأميركية متهمًا إياها بالتواطؤ في تحول الديمقراطية إلى فيتوقراطية، تجعل المؤسسات السياسية الأميركية في تآكل ناتج من الاستقطاب السياسي للأحزاب على أسس أيديولوجية واستعمال جماعات المصالح لحق النقض في السياسات التي لا تناسبها؛ وبذلك، تتفسخ آليات العمل الديمقراطي ويشير بالذات إلى “الماديسونية” التي يتسم بها القانون الدستوري الأميركي، موضِّحًا أن المبادئ التي أُنشئ عليها القانون الأميركي غير فعَّالة ومضرَّة، وخاصة الفصل بين السلطات الذي يتطلب وجود الثقة كعامل رئيسي بين المتنافسين السياسيين لإيجاد توافقات تلبي مصالح الأطراف المتنازعة لكن لا تخدم بالضرورة السياسة العامة للدولة. على هذا النحو، يوصي فوكوياما بالنظام البرلماني على شاكلة بريطانيا حيث يتحمل مجلس الوزراء ورئيسه مسؤوليات استراتيجية وصلاحيات تفوق السلطة التشريعية؛ مما يرفع من نجاعة الحكومة في صناعة واتخاذ القرار.
وفي ذات النطاق، يأتي استخدام الكاتب لتعبير «الفيتوقراطية» ليشير لحق النقض «الفيتو» والذي أصبحت مجموعات الضغط تستعمله؛ الأمر الذي يحول دون تحقيق التوازن بين مؤسسات الدولة الساعية إلى تأمين رقابة دائمة ومتبادلة للتطور المستمر وتصويب المسار. ويتهم الكاتب النخبة الأميركية بالمحاباة واللجوء للقرابة بدل الكفاءة في التعيينات التي تخص مؤسسات الدولة، مبرِزًا أن الاستعانة بالأصدقاء والعائلة يضرُّ الأنظمة العتيدة ويكون أحد ملامح أفولها، ويعطي الكاتب أمثلة كثيرة، منها: سلالة هان في الصين، والانكشاريون في الإمبراطورية العثمانية، وكبار الموظفين في النظام القديم في فرنسا. وفي هذا الصدد، ينقلب فوكوياما على المحافظين الجدد الذين ناصرهم وتحدث باسمهم لسنوات وبشَّرهم في مؤلفه السابق “نهاية التاريخ” بأنهم من سوف يستلمون زمام السلطة بالولايات المتحدة الأميركية، وأن رغباتهم في إعادة صياغة خريطة العالم بالقوة الأميركية ستتحقق عبر فرض الهيمنة تحت شعارات جديدة من قبيل الفوضى الخلاقة والقوة الناعمة، ليعود بطرح تشاؤمي عن مستقبل هذه الجماعات في ظل مجتمع أميركي يسوده التفكك ومنافسة دولية يرى فيها الشر القادم من الصين وروسيا.
على ذات المنوال، يتناول الكاتب المسألة الديمقراطية بدول الاتحاد الأوروبي معتبرًا أن مجمل الدول الأوروبية تعيش حالة ديمقراطية جيدة لكنها غير كافية للارتقاء بالأداء الحكومي، ويعتبر أن الاتحاد الأوروبي يعاني من ضعف الكفاءة السياسية بسبب التوزيع السيئ للسلطات. والمقصود هنا، أننا نجد مؤسسات الاتحاد تتوفر على سلطات واسعة لكنها تُوظَّف في مجالات غير ملائمة بينما هنالك تغييب للسلطات عن اهتمامات أخرى. ويعطي الكاتب مثالًا على ذلك بأنه يمكن لمركز الاتحاد الأوروبي ببروكسل أن يُقلق الناس باستمرار بسنِّ قوانين حول المواد الفلاحية، لكن سلطته ضعيفة -إن لم تكن غائبة- على السياسة الجبائية والنقدية مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية، الشيء الذي يظهر جليًّا في أزمة اليورو التي تمر بها دول الاتحاد. ويغوص الكاتب في كشف الحجاب عن مثالب الاتحاد الأوروبي متجسدة بشكل صارخ في الهوية الأوروبية؛ إذ يسجِّل الكاتب فشلًا كبيرًا في خلق هوية أوروبية موحدة قادرة على إشراك كل مكونات الاتحاد الأوروبي في مشروع جامع، ينبني على حسٍّ تضامني وروح التضحية من أجل الآخرين، ويتساءل الكاتب: إذا كانت الهوية الوطنية تعني استعداد الشخص للموت من أجل المجموعة الأكبر، فمَن المستعد للموت من أجل الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن؟
ومما يجب التوقف عنده هو تطرق الكاتب لإدارة الدولة وكيفية إقامة حضارة للأمة، فانطلق الكاتب من فرضية مفادها أنه لا سبيل إلى ازدهار الديمقراطية ولا إلى نجاح اقتصاد السوق الرأسمالي، إلا في ظل وجود دولة تتمتع أولًا بكفاءة الإدارة، وثانيًا بالانفتاح على العصر، وثالثًا بثقة المواطنين. ويستبعد المؤلف تحقيق الدولة لتلك الفاعلية، فالدول أصبحت بيروقراطية ومثقلة بالقوانين وأضحى توزيع الثروة الوطنية أهم عندها من إنتاجها، مستثنيًا دول شرق آسيا التي أثنى عليها وخاصة كوريا الجنوبية واليابان اللتين تتمتعان بسجل قوي في توفير حوكمة تتسم بالجودة بفضل التأثير الكونفوشيوسي. فبلد، مثل اليابان، قادر على تحديث نفسه بسرعة بفضل تراثه القوي من تفويض الحكومة الممتد ليغطي مناحي المجتمع كافة، مبرزًا أن الأنظمة الاستبدادية التي بها إدارة ذات كفاءة رديئة ناتجة من الفساد والمحسوبية التي يرعاها النظام ومؤسساته. وعلى ضوء ما سبق، يوضح المؤلف أنه لا يكفي أن نؤسس ديمقراطية تشتمل على بيروقراطية قوية؛ فالهند توجد بها بيروقراطية واسعة، لكن توجد بها قواعد كثيرة لا يمكن تطبيق إلا بعضها؛ مما يؤدي إلى تطبيقها بشكل عشوائي من قبل بيروقراطيين يسعون إلى محاباة أصدقائهم وعائلاتهم. كما يشير إلى استثناءات أوروبية نجحت في التأسيس لبيروقراطية فعَّالة كبريطانيا وروسيا مبرِزًا أنها تمكنت من ذلك قبل أن تصبح ديمقراطيات؛ مما حال دون توجه الساسة إلى توزيع العطايا والامتيازات في إطار المحسوبية، ويعود ليعطي الولايات المتحدة الأميركية كنموذج للدول المتطلعة لإرساء حكومة فعالة؛ حيث يرى أن الولايات المتحدة تمكَّنت من الاستفادة من جماعات لديها الحافز القوي من الأفراد التكنوقراطيين لشغل الوظائف في أجهزتها الجديدة.
يعتبر فوكوياما أن الحوكمة الفعالة تعتمد على ثلاثة أعمدة رئيسية: الدولة، وسيادة القانون، والمحاسبة السياسية؛ منوِّهًا بأن الديمقراطية ليست دواء كل داء؛ فالأوتوقراطية شبه الخيِّرة شيء أساسي لتطور الدولة الحديثة. وفي حالات كثيرة، أسفر توسيع حق التصويت في الانتخابات عن نظام المحسوبية الذي ينطوي على قيام النخب السياسية بشراء أصوات من مُنحوا حقَّ التصويت حديثًا؛ مما يؤدي إلى تعزيز السيطرة السياسية من جانب هذه النخب. ويقارن المؤلف بين الدول الإسكندنافية وبعض دول أوروبا منوِّهًا بإنجاز الدنمارك في إنشاء دولة ذات إدارة ناجحة وبين اليونان وإيطاليا اللتين ما زالتا تعيشان في مستنقع المحسوبية.
وفي حديثه عن الحضارة، يبيِّن فوكوياما أن الحضارة ليست بديلًا عن الثراء أو القوة، بل هي مزيج من الثراء، والقوة، والديمقراطية، موضِّحًا أن الأمن هو الركن العتيد في الحضارة فهو أساس الثراء والرخاء مصنِّفًا الدول إلى ثلاثة أنواع: دولة قوية وثرية دون ديمقراطية فهي ديكتاتورية، دولة ديمقراطية دون أمن هي دولة ديمقراطية قصيرة المدى، وأخيرًا، دولة ثرية وقوية وديمقراطية يمكن أن تواجه مشكلة التآكل، مؤكِّدًا أن الديمقراطية هي «نهاية التاريخ»، فإنها لن تنهار، لكنها تتآكل، أو يمكن أن تتآكل.
ويحمل هذا الفصل مجموعة من المغالطات والتناقضات في مواقف الكاتب؛ فالإشادة بالتكنوقراط كعمود فقري لنجاح الإدارة هي إساءة للديمقراطية التمثيلية؛ فالتكنوقراط عبارة عن خبراء لدى من يُنتخب للحكم يديرون ولا يحكمون، وينفذون القرار ولا يصنعونه. والأدهى أننا نجد أن اختيار التكنوقراط يرجع في العديد من الأحيان إلى أنهم غير حزبيين وكفاءتهم هي عدم اتخاذ مواقف في حياتهم والقدرة على التعايش مع القمع والاستبداد وإتقان فنون التسلق والمداهنة للأنظمة. وفي معرض حديثه عن الحضارة وأهمية الأمن، لابد من توضيح أن الدول القوية هي التي تكون فيها الأجهزة الأمنية في خدمة الشعوب وليس الأنظمة وينصف القضاء المظلومين دون تحيز لفئة على أخرى، ويغفل الكاتب الجانب المؤسساتي في بناء الحضارات والدول القوية. وفي كتاب بعنوان “لماذا تفشل الأمم؟ جذور السلطة، والرفاهية، والفقر في العالم” للاقتصادييْن الأميركييْن دارون أسيمو أوغلو وجيمس روبنسن اللذين يعتبران أن نجاح الدول رهين بوجود مؤسسات جامعة تتأسس على مشاركة المواطنين في صياغة السياسات العامة، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، وفصل السُّلطات، واستقلالية القضاء مع تبني منهج المساءلة، والمحاسبة، والنزاهة. وعلى نحو مماثل، تطلق المؤسسات السياسية والاقتصادية الجامعة العنان أمام الكفاءات الوطنية نحو المبادرة الحرة وريادة الأعمال؛ مما يُنتج إبداعًا يرخي بظلاله على عموم الوطن. وعلى النقيض من ذلك، ترمي المؤسسات الاستحواذية إلى استئثار قلَّة متنفذة على السلطات دون رقيب أو حسيب، مما ينجم عنه إقصاء للفئات المجتمعية الأخرى، واندثار لقيم المساواة وتكافؤ الفرص؛ حيث يتم كبح الطاقات المبدعة ويسود الفساد الإداري والمالي؛ الأمر الذي من شأنه إعاقة التنمية والازدهار الاقتصادي. وقدَّم الكاتبان نموذجي الكوريتين: الشمالية والجنوبية؛ فالأولى تعيش في انغلاق سياسي يترتب عليه احتجاز للديناميكية الاقتصادية وانحسار لحرية التبادل التجاري، تؤثر بشكل بليغ على السلم الاجتماعي. في حين نجد كوريا الجنوبية ناجحة في مجابهة الفقر عبر تقديم محفزات استثمارية تخلق ثروة مالية وفرص شغل، فضلًا عن أن تجاوب مسؤوليها مع تطلعات المواطنين جعلها تُنجز قفزات نوعية في قضايا التنمية مرتكزة على أهلية واستحقاق الرأسمال البشري.
إلى جانب ذلك، فإن حديث فوكوياما عن الحوكمة يشوبه العديد من أوجه النقص؛ فالأمم المتحدة تعرِّف الحوكمة كمقاربة تشاركية لإدارة الشؤون العامة، استنادًا إلى تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان رفاه دائم لجميع المواطنين. كما يزيد البنك الدولي على هذا التعريف، باعتبار الحوكمة مجموعة من المؤسسات والعمليات لممارسة السلطة وإشراك المواطنين في تصميم السياسات العامة وصناعة القرار.
إن إقامة حوكمة فعَّالة ليس مرتبطًا فقط بإصدار القوانين التشريعية وإنما عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان شفافية المعلومات، وكذلك، من خلال إشراك المواطنين في إعداد السياسات العامة وصناعة القرار الوطني عبر الاتصال والتنسيق بين مؤسسات الدولة. فالحوكمة هي فلسفة في التفكير وسلوك في التدبير، يكمن عمقها الاستراتيجي في التأثير المباشر على الحياة العامة للمواطنين.
وختامًا، يعتبر فوكوياما أن آفاق الديمقراطية في المجمل جيدة عالميًّا وأن الديمقراطية هي الاتجاه الذي يمضي فيه التاريخ السياسي كما يجادل بأن الرأسمالية تساعد على نشر الحرية وتجعل الفرد فخورًا بمكتسباته، أما فيما يخص الولايات المتحدة الأميركية، فالكاتب يقرُّ بأن الديمقراطية الأميركية تعاني من التآكل مُرجعًا ذلك لغياب الصدمات التي تفيق شعبًا اعتاد على الاستقرار؛ حيث يقول: إن ما يحدث للولايات المتحدة في الوقت الحاضر وبعد سلام طويل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، جنح المجتمع الأميركي مرة أخرى نحو حالة من السلبية، صار مجتمعًا من الصعب حكمه. وهذا يدفعنا للتساؤل إن كان الكاتب يريد من هذا الاستنتاج توجيه القيادة الأميركية إلى خوض حروب تجدد الديمقراطية الأميركية وتضخ ثقافة إنتاج التناقضات التي تعطيها الريادة في العالم.
لقد نال الكتاب إعجاب العديد من الخبراء والأكاديميين الذين يرون فيه قراءة واقعية للأوضاع السياسية بالعالم، بالرغم مما يعاب على الكاتب من تسطيح المعطيات وتغليب النزعات المغامراتية على المنهج العلمي، ناهيك عن الاستغراق في استنباط الحتميات التاريخية للتطلع للمستقبل، والتعاطي مع المنطقة العربية بمنطق المستشرق الذي لا يرى فيها تأثيرًا كبيرًا على التحولات العالمية.
