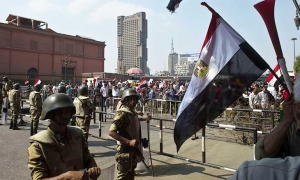لم يكن بمقدور جماعة الإخوان المسلمين أن تصل إلى السلطة في مصر، لولا الثورة الكبرى التي اندلعت في 25 يناير 2011، ولم يكن بمقدور المؤسسة العسكرية أن تعيد إحكام قبضتها على مقاليد السلطة في مصر، لولا الانتفاضة الشعبية التي اندلعت ضد حكم الإخوان في 30 يونيو 2013.
ومع ذلك يصعب الادعاء بأن جماعة الإخوان أصبحت هي الممثل الشرعي والطبيعي لثورة يناير، رغم فوزها بأكثرية المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية، ووصولها إلى قمة هرم السلطة التنفيذية، بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية. كما يستحيل الادعاء بأن المؤسسة العسكرية أصبحت هي الممثل الشرعي والطبيعي لانتفاضة 30 يونيو، وأن السيسي أصبح الأب الروحي لهذه الانتفاضة رغم تمكنه من السيطرة لاحقا على كافة مفاصل السلطة في مصر. فكيف تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة بفضل ثورة لم تقم هي بتفجيرها، وكيف تمكنت المؤسسة العسكرية من العودة إلى السلطة بفضل انتفاضة لم تقم هي بإشعالها، ولماذا فشلت الجماعة في الاحتفاظ بسلطة استمدت شرعيتها من صناديق الاقتراع، بينما نجحت المؤسسة العسكرية في استعادة سلطة كانت قد نزعت منها وتمكنت في نهاية المطاف من إزاحة كافة القوى التي كانت تعترض طريقها؟
لا جدال في أن هذه الأسئلة تطرح إشكالية كبرى ينبغي على المشتغلين بالعمل العام في مصر أن يعملوا على تفكيكها إذا ما ارادوا التوصل إلى تشخيص دقيق لما جرى في مصر خلال الحقبة المنصرمة، ولحقيقة الدور الذي لعبته كل من جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية.
دور الإخوان
يصعب التعرف على حقيقة هذا الدور بدون العودة إلى حالة حراك سياسي مناهض لنظام مبارك، كان قد بدأ قبل سنوات من اندلاع ثورة يناير، وساعدت على تنشيطه بيئة داخلية وخارجية، تزامنت من ناحية، مع تقدم الرئيس مبارك في العمر، ومع محاولات استهدفت من ناحية أخرى، نقل السلطة من بعده لابنه جمال. ولأن النظام الذي قاده مبارك كان قد نجح على مدى ثلاثين عاما في تخريب أو احتواء معظم الأحزاب التقليدية، في مقدمتها حزب الوفد، فقد كان من الطبيعي أن تمسك بزمام المبادرة عناصر مستقلة ومتمردة على الأحزاب التقليدية، وأن تقود حركة «كفاية» حالة الحراك السياسي هذه في البداية قبل أن تنتقل الراية إلى حركات أخرى عديدة، كان من أهمها: «6 إبريل» و«الحملة ضد التوريث» و«الجمعية الوطنية للتغيير» وغيرها. ولفهم طبيعة الدور الذي قامت به جماعة الإخوان في الحياة السياسية المصرية منذ ذلك الحين، يجدر بنا أن نميز بين ثلاث مراحل مختلفة:
الأولى: مرحلة ما قبل ثورة يناير، وفيها بدت علاقة جماعة الإخوان بنظام مبارك غامضة وملتبسة، بسبب النهج الذي تبناه هذا النظام في مواجهتها، وهو نهج تراوح بين الاحتواء والقمع، وزاوج بين استخدام العصا والجزرة في الوقت نفسه. فرغبة مبارك في احتواء جماعة الإخوان دفعته للعمل على إدماجها جزئيا في نظامه، بالسماح لها بشغل عدد كبير من مقاعد البرلمان (88 مقعدا بلغت نسبتها حوالي 20% من إجمالي المقاعد)، وحرصه على تحجيم دورها دفعه لشن حملات اعتقال للعديد من كوادرها بين الحين والآخر. ومن المفارقات أن هذا النهج أفاد الجماعة أكثر مما ألحق بها من ضرر، بل قدّم لها خدمة كبيرة مكنتها من بناء جسور تواصل، ليس فقط مع النظام الحاكم، وإنما مع معظم فصائل المعارضة أيضا. فسياسة الاحتواء أتاحت أمام الجماعة، من ناحية، فرصة لفتح قنوات حوار مع النظام، بينما مكنتها سياسة القمع، من ناحية أخرى، من فتح قنوات اتصال مع معظم فصائل المعارضة، بل الظهور بمظهر القوة الرئيسية للمعارضة السياسية على الساحة، الأمر الذي يفسر ارتباط الجماعة بعلاقات وثيقة ومرغوب فيها مع أجهزة النظام، ومع معظم حركات المعارضة في الوقت نفسه. ولأن هذه العلاقة لم تبن على أسس واضحة أو على قواعد راسخة تسمح ببلورة رؤية مشتركة لنظام سياسي بديل لنظام مبارك، لم تخل هذه المرحلة من حالات شد وجذب، ليس فقط بين الجماعة والنظام، وإنما أيضا بين الجماعة وفصائل المعارضة، خاصة أنها بدت حريصة كل الحرص على ألا يشكل ارتباطها بفصائل المعارضة قيدا على استقلالية قرارها، بدليل إقدامها على خوض انتخابات مجلس الشعب عام 2010 رغم قرار معظم القوى الأخرى بمقاطعتها.
الثانية: مرحلة الثورة وما بعد سقوط مبارك. فمن المعروف أنه لم يكن للشريحة الشبابية التي أشعلت شرارة ثورة 25 يناير أي علاقة تنظيمية أو فكرية بجماعة الإخوان. فقد حرصت هذه الأخيرة في البداية على النأي بنفسها بعيدا عن الثورة ولم تقرر النزول بثقلها في الميدان إلا يوم 28 يناير، أي بعد ثلاثة أيام كاملة من اندلاعها، وبعد أن تأكدت من وجود دلائل قوية على ضخامة التأييد الشعبي لها، وانخراط كافة فصائل المعارضة في صفوفها. ويلاحظ هنا أن الجماعة سارعت للاستجابة لدعوة الحوار التي أطلقها النظام، حتى من قبل ان يتنحي مبارك، ومع ذلك ليس بمقدور أحد إنكار أن الجماعة لعبت دورا مهما في التعجيل بسقوط مبارك.
كما يلاحظ أن خلافات حادة سرعان ما اندلعت بين الجماعة وبقية الفصائل المشاركة في الثورة قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية (غزوة الصناديق)، وأن هذه الخلافات راحت تتصاعد وتتعمق، خاصة أثناء وعقب الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها الجماعة بما يقرب من نصف إجمالي المقاعد وحزب النور السلفي بحوالي 22%، الأمر الذي ضمن لتيار الإسلام السياسي ككل، هيمنة تامة على السلطة التشريعية، ومكنه من التحكم في تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور. ولا جدال في أن تحالف الجماعة مع حزب النور، خاصة إبان معركة تشكيل الجمعية التأسيسية، باعد بينها وبين شركاء الثورة وراح يخصم كثيرا من رصيد الثقة المتبادلة بين الطرفين. ثم جاء قرار الجماعة بخوض الانتخابات الرئاسية، رغم تعهد سابق بعدم خوضها، ليثير المزيد من المخاوف والقلق حول النوايا الحقيقية للجماعة والوجهة التي تريدها.
أخطاء أدت إلى تعميق الانقسامات بين فصائل الثورة وغذت الشكوك في نوايا الجماعة
الثالثة: مرحلة الانتخابات الرئاسية. إذ يلاحظ أن علاقة الجماعة بالمؤسسة العسكرية ظلت وثيقة وودية خلال معظم فترة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية، ولم تبدأ في التوتر إلا بعد قرار الجماعة بخوض انتخابات الرئاسة بمرشح إخواني. كان يفترض أن يؤدي هذا التوتر إلى تنبيه الجماعة إلى حاجتها الماسة لاستعادة ثقة شركاء الثورة فيها، خاصة بعد ظهور نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي أكدت أنه ما كان لمرشحها تحقيق الفوز إلا بدعمهم المباشر (لم يحصل مرشحو تيار الإسلام السياسي الثلاثة، مرسي وأبو الفتوح والعوا، مجتمعين إلا على حوالي 40% من إجمالي أصوات الناخبين). ومع ذلك فقد بدا واضحا منذ ذلك الحين أن الجماعة اتخذت قرارا استراتيجيا بالتنسيق مع التيار السلفي، الذي كانت تدرك يقينا أنه مخترق أمنيا ويعادي الثورة منذ انطلاقتها. وعلى أي حال فقد ارتكب مرسي سلسلة من الأخطاء، أهمها: 1- تعيين هشام قنديل رئيسا للوزراء، بينما كان الأحرى به تعيين شخصية سياسية مستقلة قادرة على لم الشمل وتوحيد صفوف الثورة 2- تشكيل غير متوازن للجمعية التأسيسية ساعد على إثارة جدل عقيم حول إدراج تفسير مفصل في الدستور يتعلق بالموقف من الشريعة الإسلامية 3- إصدار إعلان «دستوري» يركز السلطة في يد الرئيس ويهمش دور بقية المؤسسات. 4- اتخاذ قرار مفاجئ بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بدون تشاور مع وزارة الخارجية، والإعلان عن فتح باب «الجهاد» للقتال ضد نظام بشار الأسد. ولا شك أن هذه الأخطاء ادت إلى تعميق الانقسامات بين فصائل الثورة وغذت الشكوك في نوايا الجماعة.
كان من المتوقع، في سياق كهذا، أن تترسخ القناعة لدى معظم القوى العلمانية بأن جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها تسعى لسرقة الثورة، وبالتالي لم يعد أمامها سوى التكتل في مواجهتها والعمل على إسقاطها إن أمكن، الأمر الذي ساهم في تشكيل «جبهة الإنقاذ» ولاحقا في إطلاق «حركة تمرد». لكن هل سعت هذه القوى للتنسيق مع المؤسسة العسكرية، أو استدعائها لإنقاذ الثورة، كما تدعي الجماعة؟ أم أن المؤسسة العسكرية هي التي نجحت، على العكس في استغلالها وتوظيفها لخدمة مشروعها الخاص في استعادة السيطرة على مفاتيح السلطة؟
هذا ما سنحاول الاجابة عليه في مقال الأسبوع المقبل.
د. حسن نافعة
القدس العربي