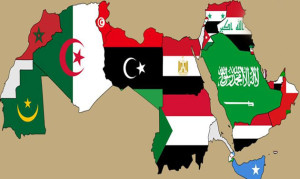لنجاح النسبي لـ «وقف العمليات العدائية» لا يستبعد نهائياً العودة الى إشعال الجبهات. وهذا رهن حسابات الإيرانيين والنظام السوري، بعدما أشار الانسحاب الروسي، ولو جزئياً، الى أن موسكو تعطي أولوية للمفاوضات والحل السياسي، في إطار توافق غير مسبوق بينها وبين واشنطن. وإذا كان لهذا التوافق أن يستمر، فلا بدّ أن تسعى محادثات جون كيري مع فلاديمير بوتين وسيرغي لافروف الى تطوير ما تمّ التوصل إليه، أي الانتقال من الهدنة الموقتة الى وقف إطلاق نار دائم، والانتقال من البحث في الشكليات والتفاوض على التفاوض وجدول الأعمال الى تداول وفدي النظام والمعارضة في تفاصيل «الانتقال السياسي». ولن ترضخ الأطراف لوقف النار أو لدخول تفاوض في العمق إلا إذا تبيّنت أن هناك تصميماً أميركياً – روسياً يرقى الى مستوى الإرادة الدولية، وهذه بدورها ستنعكس على الداعمين كافة.
هذه هي اللحظة التي ينبغي أن يثبت فيها الأميركيون والروس فعلاً أنهم في صدد إنهاء الصراع في سورية. فالاكتفاء بـ «وقف العمليات» وعدم البناء عليه، كما الركون الى وجود وفدَي المعارضة والنظام في أروقة الأمم المتحدة وعدم تفعيل التفاوض بصيغ عملية مرنة، من شأنها أن تعيد الأولوية الى الأرض للتحاور بالنار والاحتكام الى القتال.
والواقع، أن الشهور الثلاثة التي مرّت على صدور القرار 2254 شهدت إهمالاً دولياً لنصوصه وتقصيراً في تنفيذه، من دون أن يكون هناك تفسير مقبول. إذ باشر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، فور صدور القرار، البحث في المواعيد المحتملة للمفاوضات، وشاركته القوى الدولية الضغط على الطرفين كي يحضرا الى جنيف. ولو لم تحتجّ المعارضة وتطلب إجراءات تمهيدية قبل التفاوض، لما التفت الجميع الى أن القرار نصّ فعلاً على: «الصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية»… «تحديد طرائق وقف النار وشروطه»… «الحاجة الى آلية لرصد وقف النار والتحقق منه والإبلاغ عنه»… «تدابير لبناء الثقة»… «وصول المساعدات الإنسانية»… «الإفراج عن أي محتجزين في شكل تعسّفي»… «وقف أي هجمات موجّهة ضد المدنيين» – «بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبّية» – «وأي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي». وما يفرض التذكير بهذه النقاط هو أن الدول التي صيغ القرار بعنايتها فكّرت في كل الشروط اللازمة والضرورية قبل العملية التفاوضية، وأنها هي التي أهملتها (اجتياح الميليشيات الإيرانية العديد من المناطق، القصف الروسي للمستشفيات والمدارس، القصف «النظامي» المستمر بالبراميل) فتسبّبت بنكسة لانطلاق التفاوض.
لذلك، كانت مفاوضات كيري – لافروف في ميونيخ (11 شباط/ فبراير)، والهدنة التي أثمرتها، في مثابة «صحوة الجبّارَين» – إذا جاز التعبير. لكن، ربما كانا في حاجة الى «صحوة» أخرى في ما يتعلق بالجانب السياسي، وهو الأصعب. إذ لا بدّ أن يتوافقا على «مشروع انتقال سياسي» مشترك، لأنهما قد يعمدان في مرحلةٍ ما/ قريبة الى الضغط على الطرفين، ولن ينجحا في ذلك إلا اذا اتسم طرحهما بمقدار كبير من الوضوح والمعقولية في احترام الشعب السوري وطموحاته. لم يعد مفيداً (ولا مسلّياً طبعاً) جدلهما العلني العقيم على «مصير بشار الأسد»، ولا توافقهما السرّي على إبقائه طالما أن هناك حاجة إليه أو الوعد بأن «الانتخابات بعد 18 شهراً» هي الحدّ الأبعد لاستمراره في المشهد.
هذا الجدل يعطي الأسد مزيداً من الفرص ليس فقط للقتل واستخدام البراميل المتفجّرة، بل خصوصاً للمماطلة والعرقلة والتعطيل، معوّلاً أساساً على ابتزازات إيران وإسرائيل للعب من وراء الستار على تباينات أميركية – روسية، سواء لمدّ عمره السياسي أو لدسّ أطروحات تمكّنه من الاستمرار في أي صيغة تقسيمية أو فيديرالية. وليس البديل من هذا الجدل أن يُعتمد على صالح مسلم (رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي)، أو على أي جهة أخرى مماثلة تستمد أدوارها من تقاطع الاستخدامات (الأميركية والروسية والإيرانية والأسدية والإسرائيلية) لها، لتطرح تصوّراً لـ «مستقبل سورية». فمثل هذا الطرح ينبغي ألا يكون متسرّعاً أو مستسهلاً التوجّه نحو الفدرلة أو التقسيم، بل أن يكون مسؤولاً في تصوّر احتمالات المستقبل: فمن حق الأكراد أو العلويين أو سواهم أن يُصان أمنهم وتُحترم حقوقهم، لكن إذا كان لأي مكوّن أقلوي أن يفرض مرة أخرى مصالحه ونزواته على الآخرين، لمجرّد أن هذا يناسب روسيا أو يناسب إيران وأن أميركا لا مانع لديها، فهذا لا يعني أن البحث جارٍ عن نهاية للصراع بل عن إدامته، أو أن ثمة نيّة حقيقية لتصفية «داعش» وإرهابه بل لإيجاد كل الأسباب لنشوء إرهاب أشد وأدهى.
هنا يتوجب التذكير أيضاً بالقرار 2254، الذي نصّ على «التزام وحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين بغضّ النظر عن العِرق أو المذهب الديني»… لذا تتوجّب مساءلة الأميركيين والروس هل أن لهذا الكلام معنى ويلزم احترامه في ما سيكون أم أنه في عُرفهم مجرد مبادئ لم تعد صالحة لما سيكون؟ لكن، لماذا تُستصدر القرارات أصلاً، ولماذا تقدّم على أنها «قوانين دولية» إذا كانت الدول الكبرى تعتبرها بلا قيمة وتضمر مسبقاً عدم احترامها؟.. بلى هناك فرصة حقيقية للحفاظ على وحدة سورية، إنْ لم يكن عملاً بالمبادئ فليكن بالتبصّر في أن «الأقاليم المفدرلة» أو الدويلات المقسّمة» إعدامٌ نهائي للدولة والمؤسسات التي دأبت روسيا على التحذير من انهيارها، وترخيصٌ دولي للتخلّي عن إنهاض الاقتصاد ومشاريع إعادة الإعمار، وستكون بالتالي إيذاناً بتناحر دائم واستيلاداً متكرراً لظواهر التطرّف والإرهاب. ناهيك طبعاً عن الصداع الإقليمي المفزع الذي ستحمله «شرعنة» التفتيت والتفكيك من كسر تاريخي لأي تعايش بين الأديان والأعراق. صحيح أن الواقع الذي انبثق من الصراع صعب ومقلق، لكن تهرّب المجتمع الدولي – تحديداً أميركا وروسيا – من الاعتراف بمسؤولية نظام الأسد عما حصل من إجرام ووحشية، زاد الواقع الصعب صعوبةً ببحثه عن أفضل السبل لبقاء هذا النظام ولإفلاته من أي عدالة وعقاب، بل لمكافأته بإقليم أو دويلة.
لا أحد يَعتدّ بإعلان «فيديرالية روج آفا – شمال سوريا» فقط، لأن حزب صالح مسلم هو من يتبنّاها أو لأنه قال أنه جمع بضع دزينات من «الأحزاب» في مؤتمره، أو لأنه حليف هيثم منّاع وقد يصبح حليف أحمد الجربا الذي يشتغل على عشائر الحسكة، بل إن للاهتمام به سببيْن: الأول، أن إعلان الفيديرالية أكّد معلومات تعود الى أواخر 2012، بعدما كشف «حزب الاتحاد» عداءه للمعارضة المقاتلة وبخاصة لـ «الجيش السوري الحر» في حلب وأطرافها، ونُقل وقتئذ عن موالين للنظام وأكراد مناوئين لصالح مسلم أن حزبه سيكون «قاطرة التقسيم» لئلا يكون النظام هو المبادر الى طرح هذا الخيار. أما السبب الآخر فهو، طبعاً، تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (29/02) بأن سورية «قد تصبح جمهورية فيديرالية»، وقد اتضح في الآونة الأخيرة أن الروس باتوا يقاسمون الأميركيين النفوذ على «حزب الاتحاد» وبرضا متبادل. وبين الأطراف الداخلية المعنية بالأزمة ليس هناك مستفيدون من طرح الفيديرالية غير أكراد صالح مسلم ونظام الأسد، ومع أن الأخير بادر الى رفضه إلا أنه وضعه في استثماراته السياسية وفي خانة المساومات المقبلة. الجديد هو أن إيران استيقظت فجأة على «خطر الأقاليم الكردية» عليها مباشرةً، مع أنها دعمت ولا تزال حزب العمال الكردستاني الناشط إرهابياً الآن داخل تركيا، و «الأقاليم» هذه تعني التقسيم وهي غازلت ولا تزال هذا الخيار باعتباره الوحيد الذي يضمن مصالحها في سورية. لذلك، يلزمها أن تستيقظ أيضاً من وهم آخر وهو أن تمسّكها بالأسد كضامن لتلك المصالح بات أكثر من أي وقت مضى رهاناً على ورقة محروقة.