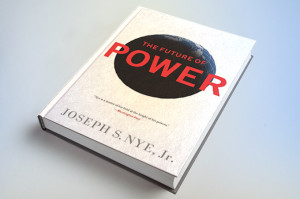
مقدمة
لعل السمة الأكثر بروزًا في أدبيات العلاقات الدولية الأميركية خلال العقود الثلاثة الماضية تتجلى في “القلق على مستقبل المكانة الأميركية في بنية النظام الدولي”، وبمقدار ما عزز سقوط الاتحاد السوفيتي من نزعة الزهو الأميركي كما تبدت في “نهاية التاريخ” لفوكوياما، فإنه أيقظ قلقًا كامنًا على مستقبل الولايات المتحدة كان قد قرع بول كينيدي أجراسه الأولى في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وقبل الإعلان الرسمي عن سقوط الاتحاد السوفيتي ببضع سنين.
وإذا كان الاتجاه الغالب على الأدبيات الأميركية ذا نزعة تشاؤمية توحي باحتمال التراجع الأميركي مع تباين في إيقاع هذا التسارع من كاتب لآخر، فإن كتاب جوزيف ناي “مستقبل القوة” يقف في الطرف المقابل متشككًا في صحة النزعة التشاؤمية تلك، ويسعى لنزع صفة الحتمية عن التراجع الأميركي، لكنه يشترط لذلك إعادة النظر في مفهوم “القوة” بما يتناسب والسياق التطوري لبنية المجتمع الدولي.
ومعلوم أن مفهوم القوة ثاوٍ في المنظومة المعرفية الأميركية في تجلياتها المختلفة وبخاصة السياسية؛ وهو ما يعني أن كتاب جوزيف ناي يمس القيمة العليا في المنظومة القيمية السياسية الأميركية والتي هي نتيجة “للثقافة السياسية والمؤسسات السياسية الأميركية”، كما يقول، لكن مساهمته الأبرز هي في النقد الشديد للنظرية الواقعية والدعوة لفهم جديد للقوة من ناحيتين: أنماط القوة (وهو الجزء الأول من الكتاب ويركز فيه على القوة الاقتصادية والعسكرية)، وتوزع القوة وانتقالها (وهو الجزء الثاني من كتابه ويتناول فيه نمطين من القوة، هما: القوة الناعمة (soft power) والقوة الكَيِّسَة (smart power) التي تجمع بين القوة الخشنة والناعمة، ليخلص في نهاية الدراسة لمناقشة موضوع “التراجع الأميركي” واحتمالاته.
تشير القراءة الدقيقة لهذه الدراسة إلى أن لها هدفين:
-
معرفيًا: ينصب بشكل أساسي على نقد أطروحة بول كينيدي عن صعود وهبوط القوى العظمى، وتحديدًا فكرته عن “التمدد الزائد” (overstretch) من ناحية، ونقد مناهج الإسقاط (projection) في الدراسات المستقبلية لاسيما المستندة لفترات زمنية قصيرة من ناحية أخرى. ويرى أن هذه المناهج هي الأكثر اعتمادًا من قبل الدراسات التي تتنبأ بتراجع الولايات المتحدة.
-
سياسيًا: يتمثل في وضع رؤية جديدة للاستراتيجية الأمثل للولايات المتحدة لتجنب الدخول في دورة “الصعود والهبوط” التي تظلل الأدبيات السياسية الأميركية المعاصرة.
تبدلات القوة
بعد أن يناقش مشكلة قياس القوة، وكيف أن مقومات القوة تبدلت عبر التاريخ (في القرن السادس عشر تبوأت إسبانيا مكانتها عبر السيطرة على المستعمرات وتكديس الذهب)، في القرن السابع عشر (اعتمدت هولندا على عنصري التجارة والمال)، أما في القرن الثامن عشر (فلعب عامل عدد السكان والقوة العسكرية الدور الأهم في المكانة الفرنسية)، بينما في القرن التاسع عشر (اعتمدت بريطانيا على نتائج الثورة الصناعية والقوة البحرية)، إلى أن وصلنا إلى المجتمع الحالي والذي تمثل “المعلوماتية” أحد متغيرات القوة المركزية فيه.
ذلك يعني من وجهة نظر “ناي” أن المتغيرات التي تشكّل القوة تتغير من مرحلة تاريخية لأخرى، كما ترافق مع هذه المسألة عناصر جديدة لابد من أخذها في الاعتبار:
-
ظهور أطراف جديدة غير الدول على المسرح الدولي (المنظمات الإرهابية، الشركات متعددة الجنسية، منظمات الجريمة المنظمة، المنظمات غير الحكومية.. إلخ). وهنا لابد من التنبه لبعض المظاهر بهذا الصدد:
-
أن عدد الأطراف الجدد من غير الدول في تزايد مستمر.
-
عبور نشاطات هذه الأطراف للحدود مما جعل التفاعلات الدولية أكثر تعقيدًا؛ فعلى سبيل المثال، فإن ثلثي دخل شركة IBM يأتيان من خارج الولايات المتحدة، كما أن ربع موظفيها (من مجموع 400 ألف) موظف موجودون في الولايات المتحدة.
-
انخفاض تكلفة التواصل بين فروع هذه المنظمات، بل أصبح الأفراد جزءًا من هذه التعقيدات، فعدد مستخدمي الإنترنت تجاوز المليار نسمة.
-
موت المسافة: فلم يعد للمسافة معنى؛ إذ يمكن التواصل من أية نقطة في العالم مع أية نقطة أخرى أو مع نقاط كثيرة في نفس الوقت وعلى مسافات مختلفة، وهو أمر تستثمره هذه الأطراف الجديدة على غرار ما تفعل “القاعدة” مثلاً.
-
أفرزت هذه الأطراف أنماطًا جديدة من المشكلات والمنازعات؛ فقد ساهمت هذه التنظيمات في خصخصة الحرب (وأصبحت تساهم في التدريب والتجنيد والحوار.. إلخ)، وبرزت مشكلات الحروب الفضائية التي تمثل الفيروسات أحد أشكالها والتي تسبب أحدها (فيروس الحب) بخسائر وصلت إلى حوالي 15 مليار دولار، كما أن جماعات الجريمة المنظمة كلفت من خلال انتهاكها للملكية الفكرية وسرقة البيانات حوالي تريليون دولار في عام 2008، كما أن شبكات التجسس الإلكتروني اقتحمت 1295 حاسوبًا في 103 دول منها 30% “أهداف” حكومية مهمة.
غير أن ذلك كله لا يعني أن مفهوم السيادة قد انتهى أو أن ذلك إيذان “بانتهاء الدولة القومية” كما اعتقد كينيش أوهمي (Kenichi Ohmae)، لكن الضرورة تقتضي أن تتعايش الدولة المعاصرة مع هذه الأنماط الجديدة من الأطراف والتفاعلات.
-
-
أن هذه القوى الجديدة تزودت بفعل آليات العولمة والثورة المعلوماتية بعناصر قوة جديدة.
-
انتشار القوة وتوزعها؛ وهو أمر أهم من انتقال القوة من دولة لأخرى؛ فالقطاعات التي لا تسيطر عليها الدول في ازدياد مطرد.
-
ضرورة التحول عن اعتبار حجم الناتج المحلي (GDP) هو المقياس الأمثل للقوة؛ لأنه يُغفل عناصر القوة الأخرى والتي تتجلى في القوة الناعمة والقوة الكيسة.
-
أن الميل للحروب واستخدام القوة العسكرية “بين الدول” يتراجع، بينما “داخل الدول” ما زال متواصلاً.
ويميز “ناي” بين القوة الناعمة والقوة الكيسة؛ إذ تعني الأولى مجموع أدوات “الإقناع والجذب”، والتي تتم من خلال السمعة الدولية، السلطة المعنوية والأخلاقية، الوزن الدبلوماسي، القدرة الإقناعية، الجاذبية الثقافية، المصداقية الاستراتيجية، الشرعية، بينما تمثل الثانية القوة الناتجة عن الجمع بين أدوات القوة الناعمة وأدوات القوة الخشنة لبناء استراتيجية تتناسب مع تغير الظروف والسياقات.
ويؤكد “ناي” على مفهوم وأهمية الشرعية كسند للعمل القتالي، وتتجسد الشرعية من خلال عدالة القضية التي تقاتل من أجلها، وتناسب القوة والتمييز في استخدامها، وتقديم الموضوع من خلال وسائل الإعلام والمناورات السياسية والعرض في الأمم المتحدة… إلخ، وتتضح هذه المسألة في الحرب على العراق 2003؛ إذ ظهرت كفاءة القوة العسكرية الأميركية ولكنها بدون شرعية لعدم الحصول على تفويض من مجلس الأمن، كما قدّم نموذج سجن أبو غريب نموذجًا لإضعاف الشرعية.
ويتساءل “ناي” عن كيفية توظيف القوة الخشنة لتتحول إلى “قوة ناعمة”، ويرى أن ذلك ممكن من خلال:
-
عبر الحرب ولكن باستخدام سياق شرعي لهذه الحرب.
-
الدبلوماسية القهرية والتي تتمثل في التهديد باستخدام القوة.
-
تقديم الحماية للحلفاء “ولآخرين” (لاتفيا، اليابان، السعودية.. إلخ).
-
المشاركة في علميات حفظ السلام.
-
التدريب والمساعدات الإنسانية في الكوارث ومواجهة القرصنة.
ويرى أن القوة العسكرية سيبقى لها دورها في القرن الحادي والعشرين ولكن “بجدوى أقل” مما كانت عليه في القرون الماضية.
وينظر “ناي” إلى القوة الناعمة على أنها مفهوم “وصفي” (descriptive) لا معياري (normative)، كما لا يراها شكلاً من المثالية أو الليبرالية، لكن المشكلة فيها تكمن في كيفية دمج القوة الناعمة في استراتيجية الدولة، لاسيما أنها تعتمد على “الجذب لا الدفع”.
أما مصادر القوة الناعمة فهي ثقافة المجتمع (البعد الجاذب من هذه الثقافة)، والقيم السياسية (المقبولة داخليًا وخارجيًا)، والسياسة الخارجية (بمقدار شرعيتها)، ثم الموارد الاقتصادية والموارد العسكرية (من خلال قنوات التعاون والتدريب أو التوظيف في أغراض إنسانية كالكوارث الطبيعية وغيرها).
ويقدم “ناي” نماذج للقوة الناعمة لتوضيح فكرته فيشير إلى:
-
كان في الفترة ما بين 1978-2008 ما مجموعه 1,4 مليون طالب صيني درسوا في الخارج، وفي عام 2009 كان هناك 220 ألف طالب أجنبي يدرسون في الصين التي تسعى ليصل العدد إلى نصف مليون في 2020، كما فتحت بضعة مئات من المراكز الثقافية الصينية في العالم، وقد أنفقت الصين خلال عام 2009-2010 حوالي 8,9 مليار دولار “لأعمال دعائية خارجية”.
-
تشارك الصين في أعمال حفظ السلام، وانضمت لمنظمة التجارة العالمية، رغم ذلك ما زال دور القوة الناعمة الصينية يعطي نتائج متواضعة في كثير من الأحيان، كما تشير إلى ذلك استطلاعات الرأي العام الدولي.
وتتحقق القوة الناعمة بطرق مباشرة (الإقناع والدبلوماسية والكاريزما للقيادات.. إلخ) أو غير مباشرة (بخلق البيئة المساعدة على الإقناع والجذب). -
هناك حاليًا 46 رئيس حكومة في العالم من خريجي الجامعات الأميركية، وهناك حوالي 750 ألف طالب أجنبي يأتون للولايات المتحدة كل عام.
ويرى “ناي” أن جدوى القوة الناعمة مرهون بالمصداقية في الإعلام لاسيما في ظل كثرة وتنوع هذه الوسائل وتنافسها المحموم بشكل يفرض على المتلقي البحث عن الأكثر مصداقية، وكلما كان عهد المتلقي بمصداقية الأداة الإعلامية أطول كان ذلك في مصلحة القوة الناعمة.
قوة متملصة
يرد “ناي” في أغلب صفحات دراسته التي تقع في 272 صفحة على التيار الذي يميل للاعتقاد بتراجع الولايات المتحدة مثل مجلس المخابرات الوطني الأميركي الذي توقع انتهاء الهيمنة الأميركية عام 2025، والرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف الذي اعتبر أزمة 2008 المالية إشارة لانتهاء المكانة الأميركية، وزعيم المعارضة الكندية ميشيل إغناتيف الذي دعا كندا للتطلع نحو “خارج الولايات المتحدة” لأن ساعة الهيمنة الأميركية قد أزفت.
ويشير “ناي” إلى أننا بحاجة إلى “سردية (narrative) أكثر دقة من صعود وهبوط القوى العظمى”، ويرى هذه السردية الجديدة في أن القوة العسكرية لا تزال ولفترة قادمة بيد أميركا، كما أن القوة الاقتصادية متعددة الأقطاب وليست بيد قوة واحدة، ناهيك عن أن التفاعلات في المجتمع الدولي أصابها تحول مهم يتمثل في العلاقات العابرة للقوميات التي تقودها وحدات “غير الدولة”؛ مما خلق مستويين من التفاعل، أحدهما بين الدول والآخر حراك بين الدول و”غير الدول”، وعليه فإن الولايات المتحدة لا تستطيع دون التعاون مع غيرها من الدول مواجهة التغيرات العميقة التي تحدثها التحولات الجديدة لاسيما في ميدان المعلوماتية والعولمة.
غير أن الفكرة المركزية في “سردية” ناي هي التحول في معنى القوة وتوظيفها أو إدارتها، ويرى أن للقوة أبعادًا ثلاثة، هي:
-
“دفع الآخرين للقيام بما لا يرغبون في القيام به”.
-
“جعل الآخرين يضعون أولوياتهم وتفضيلاتهم طبقًا لما تريد”.
-
“القدرة على خلق وتشكيل إدراك وعقائد الآخرين دون إدراك منهم أنك تفعل بهم ذلك”.
ولا يجادل “ناي” في أن وجود الموارد أمر مهم، لكنه يرى أن جدواه محدودة إن لم تسانده قوة ناعمة (الإقناع والجذب) من ناحية، والتوفيق بين “التمدد الزائد”( overstretch) على المستوى الدولي، وبين “نقص الكفاية” (underreach) في تعبئة الموارد المحلية، والتي من ضمنها القوة الناعمة.
وفي إطار تحليله لبنية المجتمعات المعاصرة، يصنف المجتمعات إلى:
-
المجتمعات ما بعد الصناعية: حيث لم تعد الحرب وسيلة للعلاقة بين هذا النمط من المجتمعات، وهي تتفاعل ضمن شبكة علاقات اعتماد متبادل معقدة، (مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي). وهي ترى أن الحرب مكلفة، كما أن القوة كانت موجهة سابقًا نحو الجيوش ولكنها الآن موجهة نحو المجتمعات مما يقتضي التحول في إدارتها، فاكتساب عقول وقلوب المجتمع الذي تهاجمه أصبح جزءًا من الاستراتيجية.
-
المجتمعات الصناعية: مثل الصين والهند، وهذه ما زالت الحرب أداة “محتملة” من أدوات التفاعل بينها ومع الآخرين.
-
المجتمعات ما قبل الصناعية: ونموذج التفاعل بين مجتمعات هذا النمط هو نموذج النظرية الواقعية التقليدية (مثل إفريقيا والشرق الأوسط).
ويولي “ناي” القوة الاقتصادية أهمية واضحة، ولا يرى أن أحد التحولات في المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين هي التحول من “الجيوسياسي” إلى “الجيواقتصادي” كما يعتقد الكثيرون نظرًا لصعوبة التحكم في السوق وتزايد عدد اللاعبين في العملية الاقتصادية من دول ومنظمات اقتصادية خاصة ومنظمات هجينة تضم الدول وغيرها، وتتمثل مقومات القوة الاقتصادية لديه في (السوق، الدخل الفردي، الناتج المحلي من حيث الحجم والنوعية.. إلخ)؛ وهذه قابلة لأن تتحول إلى قوة عسكرية.
أما الجزء الثاني من دراسة “ناي” فينصب على انتشار أو توزيع القوة وبروز تأثيرات الفضاء الإلكتروني، ويقدم نماذج على ذلك، مثل: تعطيل إسرائيل للدفاعات السورية قبل ضرب ما قيل: إنه مفاعل نووي عام 2007، أو مثال المشكلات بين شركة غوغل والصين في مجال حقوق الإنسان والملكية الفكرية والرقابة… إلخ.
ويناقش التعقيدات في نطاق هذا النمط من القوة الناعمة؛ فالعلاقة مثلاً بين الدولة وموضوع الحريات من خلال الفضاء الإلكتروني أصبح نطاقًا تصعب السيطرة عليه، فكيف يمكن -على سبيل المثال- التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني في الفضاء الإلكتروني، بل كيف يمكن الفصل بينهما نظرًا للتداخل في شبكة الإنترنت، بل كيف يمكن تحديد المسؤول عن الجريمة الإلكترونية التي تقع ضمن حدود الدولة، فهل المسؤول هو الدول أم منظمة معينة أم فرد ما… إلخ؟
وللتدليل على تعقيدات هذا الجانب، يشير الكاتب إلى أن الصين وروسيا رفضتا التوقيع على ميثاق المجلس الأوربي الخاص بجرائم الفضاء الإلكتروني، كما يشير إلى مناقشات الجمعية العامة عام 2000 التي كشفت التباين بين الولايات المتحدة وروسيا حول ضبط الجريمة والمسؤولية في الفضاء الإلكتروني؛ فعلى سبيل المثال ترى الولايات المتحدة أن التويتر (twitter) واليوتيوب youtube)) أداة للتحرر، بينما تراهما روسيا أو إيران أدوات للهجوم والتجسس، مؤكدًا أن التجسس عبر الإنترنت سيستمر ما لم تتخذ الدول سياسات تعاون جديدة, ويرى أنه مثلما تم تطوير التعاون في مجال “السلاح النووي” يمكن التعاون في المجال الإلكتروني، وهو ما يتم الآن في خطواته الأولى.
المكانة الأميركية بين تيارين
لا يقف “ناي” ضمن فريق المتشككين في المكانة الأميركية مستقبلاً؛ فهو أميل إلى أنها ستبقى الأقوى ولكن دون أن تكون المهيمنة، ويناقش الآراء التي ترى احتمال التصادم الأميركي-الصيني، في ظل نظرية الهيمنة، رغم أنه يرى أن مفهوم الهيمنة أضحى موضع نقاش، فقد انتشرت الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية بشكل سريع ومؤثر رغم هيمنة الولايات المتحدة في تلك الفترة.
وبعد مقارنة للتراجع البريطاني مع احتمالات تراجع الولايات المتحدة، فإنه لا يجد شبهًا كبيرًا بينهما، وهو يرى أن التراجع الأميركي له طابع سيكولوجي “أكثر منه تحولاً في مصادر القوة”، ولا يوافق ناي على بناء تنبؤات طويلة المدى في هذا المجال استنادًا لآجال قصيرة على غرار تنبؤات منتدى دافوس بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
ويواصل توظيف منهج المقارنة من خلال المقارنة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي؛ فرغم القوة الاقتصادية الأوربية إلا أنه يرى أن أوربا لا تزال غير ناضجة في مستوى التكامل أو بلوغ الوحدة، إضافة للأعباء التي تركتها عملية النهوض بأوربا الشرقية، والمشكلات الديمغرافية (سيكون عدد سكان أوربا عام 2060 معادلاً فقط لـ 6% من سكان العالم، وسيكون ثلثهم فوق 65 سنة)، ويعتقد أن أوربا قد تكون قوة موازية للولايات المتحدة إذا حلت مشكلاتها الداخلية السابقة، لكن التنافس بين الطرفين الأميركي والأوربي سيبقى في نطاق السيطرة نظرًا للترابط بين أميركا وأوربا في مجالات التجارة والبحث العلمي والتقارب السياسي والتشارك القيمي.
ينتقل “ناي” بعد ذلك للبحث في التأثير الياباني على المكانة الأميركية، ويشير هنا إلى تراجع معدلات النمو الياباني؛ ففي عام 1988 كان 8 من أكبر عشر شركات في العالم هي شركات يابانية، لكنها جميعًا فقدت هذه المكانة. كما أن اليابان لديها مشكلات ديمغرافية أيضًا، فهناك احتمال تراجع عدد سكان اليابان إلى مئة مليون عام 2050، ناهيك عن أن ثقافة اليابان معادية للهجرات.
رغم ذلك؛ فاليابان تعد من الدول المتقدمة في المستوى الصناعي، وصاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بل إنها تتفوق على الولايات المتحدة في بعض الجوانب الصناعية.
ويتوجس “ناي” من أن المشكلة المستقبلية تتمثل في احتمال تحالف الصين مع اليابان؛ ففي عام 2006 كانت الشريك الأول للصين تجاريًا، لكن ذلك غير محتمل، ويرجح استمرار التحالف الأميركي-الياباني.
وينتقل “ناي” بعد ذلك لرصد مجموعة بريكس (BRICS) التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويحدد مصادر قوة هذه المجموعة في ارتفاع نصيبها من الناتج العالمي من 16-22% من 2000-2008، وفي أنها تضم 42% من سكان العالم، و33% من النمو العالمي، و42% من الاحتياطي النقدي العالمي، لكنه يرى أن نقطة ضعف المجموعة تكمن في روسيا بينما تمثل الصين قلب المجموعة؛ فروسيا تعاني في تشخيصه من الفساد، وضعف المؤسسات، والتخلف العلمي قياسًا للقوى الأخرى، ومن المشكلات الديمغرافية، ناهيك عن الاعتماد على الموارد الطبيعية بخاصة النفط.
ويناقش الكاتب احتمالات التحالف الصيني-الروسي الذي يراه أمرًا مهمًا، لاسيما أن ما يجمعهما منذ معاهدة التعاون بينهما عام 2001 “هو استراتيجية معارضة القطبية الأحادية”، لكن ذلك ليس له أن يقضي على الخلافات بين الطرفين مثل:
-
تمركز عدد كبير من الصينيين على الحدود بين الدولتين، فهناك 120 مليون صيني مقابل 6 ملايين روسي على جانبي الحدود المشتركة.
-
قلق روسي من تطور القوة الصينية وما قد يترتب عليه من انعكاسات.
-
قلق صيني من الإعلان الروسي عام 2009 عن مبدأ الحق في الضربة الأولى بالسلاح النووي (خوفًا من تطور القوة التقليدية الصينية) بخاصة في شرق الصين.
وعند انتقاله للطرف الآخر في المجموعة وهو الهند، يرى أنها تعاني من عوامل ضعف لا تزال ثقيلة رغم النمو الذي حققته، كما أن احتمالات التحالف الصيني-الهندي تبدو ضعيفة.
أما البرازيل، فيرى أن لديها عناصر قوة لكنها تعاني العديد من المشكلات، لاسيما الفقر وتفاوت الطبقات.
وعند انتقاله للصين التي اعتبرها قلب المجموعة، أشار إلى أنها الأسرع تطورًا، لكنها تعاني من:
-
مشكلات ديمغرافية (بسبب سياسة الطفل الواحد).
-
فقر الريف: إذ إن عشرًا فقط من مجموع 31 مقاطعة صينية فيها معدل الدخل أكثر من المعدل العام للدخل الفردي.
-
هناك احتمالات لتلكؤ النمو الاقتصادي في فترات قريبة.
-
حتى لو تجاوزت الصين الناتج الأميركي فإن تركيب الاقتصاد الأميركي مختلف من حيث نوعيته.
-
يفتقد النظام السياسي الصيني الشرعية في منظور المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.
-
تفوق الولايات المتحدة على الصين في السينما والجامعات والبحث العلمي.. إلخ.
-
معدل دخل الفرد سيبقى لصالح أميركا حتى بعد 2050.
-
يعد النفوذ الصيني الدولي محدودًا، أي أن قدرتها على توجيه الأحداث الاستراتيجية الدولية ما زال قاصرًا قياسًا للولايات المتحدة.
-
سيكون الإنفاق الدفاعي الصيني في عام 2025 مساويًا لـ 25% من الإنفاق الدفاعي الأميركي الحالي.
بناء على ذلك كله، يرى “ناي” أن الصين لن تتساوى في مجمل القوة مع الولايات المتحدة لكنها قد تكون تحديًا مهمًا لها.
ذلك يعني أن “ناي” يرى الولايات المتحدة في مكان الصدارة مستقبلاً، دون هيمنة، لكنه ينبه إلى أن مشكلة الولايات المتحدة ليست في نظرية التمدد الزائد، فالنفقات الدفاعية الأميركية رغم تزايدها، فإن نسبتها من الناتج المحلي تتراجع، لكن معضلة الولايات المتحدة هي في مشكلاتها “الداخلية” الثقافية والاقتصادية والمؤسسية؛ فهناك ضعف في المستوى التعليمي المدرسي، ولا تزال الفروق الطبقية طبقًا لمقياس جيني عالية، إضافة إلى فقر الأطفال، وتراجع معدلات الادخار، ومشكلة احتمال إغلاق باب الهجرة، وهو ما دفع إلى تراجع ثقة المواطن الأميركي في المؤسسات السياسية الأميركية، لكنه لا ينسى أن يذكّرنا بأن هناك جوانب إيجابية بهذا الصدد (مثل التحسن في مجال الجريمة، وتراجع معدلات الطلاق، تزايد نسبة التسامح… إلخ). أما الهجرة، فكل 1% زيادة في الخريجين من المهاجرين تزيد من نسبة براءات الاختراع 6%.
توليفة القوة
تتمثل نهاية الدراسة في فصل اسماه “القوة الكيِّسة”، يحاول فيه أن يقدم تصورًا استراتيجيًا لتوظيف القوة الناعمة والخشنة؛، فالمشكلة في القرن الحادي والعشرين من وجهة نظره ليست هي “تعظيم القوة أو الحفاظ على الهيمنة بل إيجاد سبل لتوليف الموارد لبناء استراتيجيات ناجحة في سياق انتشار القوة وتنامي البقية من الدول” أي دمج القوة الخشنة والقوة الناعمة، ويرى أن تحقيق ذلك يستوجب:
-
وضوح الأهداف والعمل على دمج القيم والمصالح.
-
تقييم دقيق للموارد المتاحة ومدى تغير هذه الموارد مع تغير البيئة الدولية.
-
تحديد الأفضليات في الأهداف ومدى شرعيتها.
-
اختيار أشكال القوة التي يمكن اللجوء لها طبقًا للوضع القائم.
-
تقييم دقيق لاحتمالات النجاح.
وينتهي “ناي” إلى أن ما يدعو له لا يمثل نظرة واقعية أو ليبرالية بل هي مزيج منهما سماه الواقعية الليبرالية (liberalrealism).
أصاب “ناي” في التغير في مضمون القوة، وفي ضرورة عدم الفصل بين توظيف القوة والسياق، لكن مفهوم القوة الناعمة هو مفهوم يمت للممارسة الفعلية في كل الحضارات دون أن يفرد له “أدبيات خاصة” به، وهو يشير في ثنايا الدراسة ولو بشكل عابر وقابل للتأويل للنموذج الإسلامي وغيره.
كذلك فإن “ناي” عاب على أغلب من خالفه الرأي في المكانة المستقبلية للولايات المتحدة أنهم بنوا “إسقاطاتهم” استنادًا “لآجال زمنية قصيرة”، ورغم أن نظرية بول كينيدي امتدت لقرون خمس، فإن “ناي” اتخذ موقفًا مخالفًا استنادًا لذات المنهجية القائمة على الإسقاط استنادًا للآجال القصيرة.
يبدو أن فكرة القوة الناعمة انبثقت من التأثيرات التي تركتها الصورة السلبية للسياسة الخارجية الأميركية في العقود القليلة الماضية، وقد ألمح الكاتب غير مرة إلى أن السياسة الخارجية الأميركية تفتقد في بعض ممارساتها “للشرعية”، ناهيك عن تركيز وسائل الاتصال المعاصرة على كل مثالب السلوك الأميركي على غرار نموذج “سجن أبو غريب وسجن غوانتنامو والحروب دون تفويض من الأمم المتحدة في أكثر من مكان في العالم لاسيما في الشرق الأوسط والبلقان”.
والملاحظ أن الباحث كان أكثر جرأة في كشف “خلل” القوة الناعمة الأميركية، لكنه كان أكثر حذرًا عند تقديم بعض النماذج عن إسرائيل لاسيما في تبرير ضرب المواقع المدنية في لبنان وغزة.
ويبدو أن الكثير من تنبؤات “ناي” هي ذات طابع حدسي (intuitive)، وبدت أقل صرامة في بنيتها العامة من دراسة بول كينيدي التي حاول الكاتب هدمها، لكن التنبيه إلى أهمية القوة الناعمة والقوة الكيسة تستحق أخذها بعين الاعتبار لكل من يضع استراتيجية لدولة كانت صغيرة أم كبيرة.
جوزريف ناي
عرض: د. وليد عبدالحي
مركز الجزيرة للدراسات
