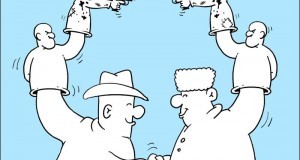
تحتار أوروبا من أين تبدأ رصّ صفوفها لمواجهة روسيا. لا تبدو الظروف ملائمة لأبناء القارة العجوز الذين فشلوا في وضع حدٍّ لتنامي القوة الروسية، ونفوذها أوكرانياً وسورياً. حاولوا الاستعانة بالأميركي، كي يخوض معاركهم عنهم، من دون أن يتذكّروا أن الجمهوري جورج بوش الابن “تجاهل” الزحف الروسي على جورجيا في أغسطس/آب 2008، في مقابل عدم “مخاطرة” الديمقراطي باراك أوباما في تخطّي خطوطٍ حمراء في علاقته مع الروس.
في الواقع، ما يقوم به حالياً الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سورية، وقبله في أوكرانيا، ناتج عن مراكمة عسكرية طويلة لجيشه، لا تزال مستمرة. يعود كل شيء إلى السنتين الأخيرتين، حين بدأت المقاتلات الروسية تخترق المجالات الجوية للدنمارك والسويد والنرويج وبريطانيا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا بكثافة، من دون أن تلاقي ردّاً كافياً، من نوع أن يقوم الآخرون بشيء مماثل، لافتقارهم إلى “القدرة العسكرية” اللازمة. كما استعرض الروس غواصاتهم وسفنهم أيضاً، من بحر البلطيق إلى بحر الشمال، خارج مياههم الإقليمية. لم تجد موسكو أمامها سوى قارة تخلّت عن أحلامها العسكرية، منذ حطّت القوات الأميركية الرحال فيها بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945). تلك القارة، أمضت ربع القرن الأخير من عمر البشرية، تُحصّن اقتصاداتها، وتُزيل العوائق البيروقراطية الفاصلة بين بلدانها، في مقابل العمل الروسي العسكري الدؤوب، للخروج من هزيمة حرب الشيشان الأولى (1994 ـ 1996).
وجّهت روسيا رسائل عسكرية عدة في العامين الأخيرين، لم تعرف أوروبا كيفية مواجهتها، سوى بتوقيع مزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي الذي لاقى، بطبيعة الحال، اعتراضات من الوسط الأوروبي. لم تضرب العقوبات موسكو فحسب، بل أبدى الاقتصاديون الألمان معارضة شديدة للعقوبات على روسيا، بحجّة “انعكاسها السلبي عليهم”. وغني عن التعريف أن وقود حوض منطقة الرور الصناعية الألمانية يأتي من روسيا.
سعت أوروبا إلى الدفع بحلف شمال الأطلسي إلى الواجهة، لضمان “التوازن العسكري” مع الروس، بصورة مشابهة لمرحلة الحرب الباردة (1947 ـ 1991)، لكن الأميركيين، القوة الأبرز في الحلف، لم يندفعوا كما تشاء أوروبا. وعمدوا إلى تنظيم تدريبات متنوّعة، لا تؤثر في التوازن العسكري بين الأوروبيين والروس. تماماً كما فعلوا في تدريبهم أفراداً محدّدين من فصائل المعارضة السورية، الأمر الذي ظهر فشله في المعارك الأخيرة في الشمال السوري.
لم “ينتبه” الأوروبيون إلى أن ردّ الفعل الأميركي “الخجول” في تدريب المعارضة السورية، وفي الدفع بقوات عسكرية كافية في أوروبا بعد ضمّ الروس شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وفي الطلعات الجوية التي استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في الـ15 شهراً الأخيرة، مهّدت، بشكل واضح، للتدخّل العسكري الروسي في سورية. مع العلم أن الطلعات العسكرية ضد “داعش” لم تؤدِّ سوى إلى تمدد التنظيم، بدلاً من محاصرته. تدمر نموذجاً.
لم يدرك الأوروبيون أن الأميركيين لم يعودوا في موقع تعزيز قوة القارة العجوز، كما كان أيام صواريخ “بيرشينغ”، خصوصاً أن العلاقة الأميركية مع روسيا تبقى أفضل بكثير من علاقة الأوروبيين بها. وأن “التعاون العسكري” بين موسكو وواشنطن على خلفية الأزمة السورية تخطّى كل مفاهيم العلاقة غير المباشرة، أيام روسيا بشكلها السوفييتي والولايات المتحدة، نحو علاقة “أكثر تكاملية” حتى الآن.
سيؤدي ذلك إلى دفع الأوروبيين إلى المواجهة مع الروس، على الرغم من صعوبة موقفهم ودقته، في ظلّ الظروف الصعبة التي يشهدونها، لجهة توافد مئات آلاف المهاجرين إليهم، ولجهة عدم وجود قدرة عسكرية أوروبية، خارج إطار التحالف مع الولايات المتحدة، لمواجهة روسيا. ولعلّ عدم تسليم سفينتي “ميسترال” الفرنسيتين إلى روسيا يبدو أقصى ما يُمكن أن تفعله أوروبا في وجه الروس. لكن السفينتين بالذات باتا في عهدة مصر عبد الفتاح السيسي، حليف بوتين. أوروبا الآن في أضعف موقف تاريخي لها.
وجّهت روسيا رسائل عسكرية عدة في العامين الأخيرين، لم تعرف أوروبا كيفية مواجهتها، سوى بتوقيع مزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي الذي لاقى، بطبيعة الحال، اعتراضات من الوسط الأوروبي. لم تضرب العقوبات موسكو فحسب، بل أبدى الاقتصاديون الألمان معارضة شديدة للعقوبات على روسيا، بحجّة “انعكاسها السلبي عليهم”. وغني عن التعريف أن وقود حوض منطقة الرور الصناعية الألمانية يأتي من روسيا.
سعت أوروبا إلى الدفع بحلف شمال الأطلسي إلى الواجهة، لضمان “التوازن العسكري” مع الروس، بصورة مشابهة لمرحلة الحرب الباردة (1947 ـ 1991)، لكن الأميركيين، القوة الأبرز في الحلف، لم يندفعوا كما تشاء أوروبا. وعمدوا إلى تنظيم تدريبات متنوّعة، لا تؤثر في التوازن العسكري بين الأوروبيين والروس. تماماً كما فعلوا في تدريبهم أفراداً محدّدين من فصائل المعارضة السورية، الأمر الذي ظهر فشله في المعارك الأخيرة في الشمال السوري.
لم “ينتبه” الأوروبيون إلى أن ردّ الفعل الأميركي “الخجول” في تدريب المعارضة السورية، وفي الدفع بقوات عسكرية كافية في أوروبا بعد ضمّ الروس شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وفي الطلعات الجوية التي استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في الـ15 شهراً الأخيرة، مهّدت، بشكل واضح، للتدخّل العسكري الروسي في سورية. مع العلم أن الطلعات العسكرية ضد “داعش” لم تؤدِّ سوى إلى تمدد التنظيم، بدلاً من محاصرته. تدمر نموذجاً.
لم يدرك الأوروبيون أن الأميركيين لم يعودوا في موقع تعزيز قوة القارة العجوز، كما كان أيام صواريخ “بيرشينغ”، خصوصاً أن العلاقة الأميركية مع روسيا تبقى أفضل بكثير من علاقة الأوروبيين بها. وأن “التعاون العسكري” بين موسكو وواشنطن على خلفية الأزمة السورية تخطّى كل مفاهيم العلاقة غير المباشرة، أيام روسيا بشكلها السوفييتي والولايات المتحدة، نحو علاقة “أكثر تكاملية” حتى الآن.
سيؤدي ذلك إلى دفع الأوروبيين إلى المواجهة مع الروس، على الرغم من صعوبة موقفهم ودقته، في ظلّ الظروف الصعبة التي يشهدونها، لجهة توافد مئات آلاف المهاجرين إليهم، ولجهة عدم وجود قدرة عسكرية أوروبية، خارج إطار التحالف مع الولايات المتحدة، لمواجهة روسيا. ولعلّ عدم تسليم سفينتي “ميسترال” الفرنسيتين إلى روسيا يبدو أقصى ما يُمكن أن تفعله أوروبا في وجه الروس. لكن السفينتين بالذات باتا في عهدة مصر عبد الفتاح السيسي، حليف بوتين. أوروبا الآن في أضعف موقف تاريخي لها.
بيار عقيقي
صحيفة العربي الجديد
